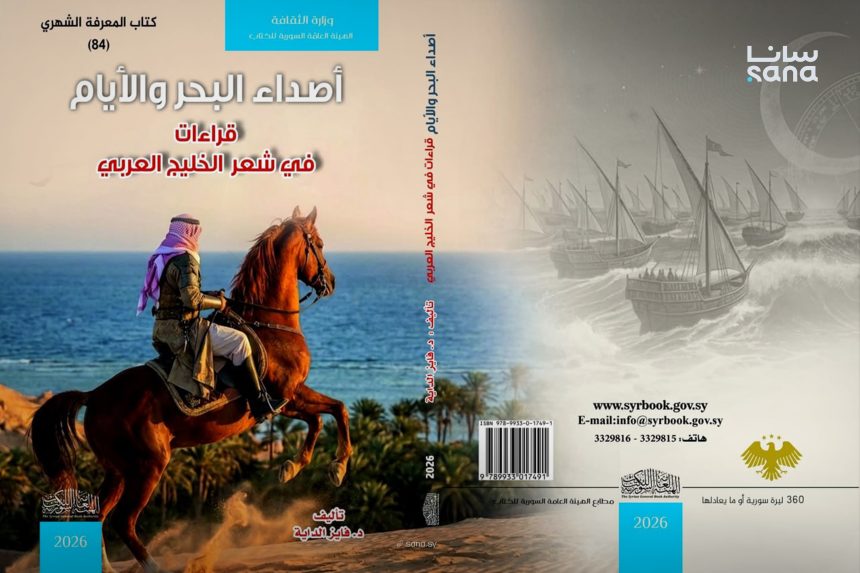منذ أن بدأت محكمة العدل الدولية بتحقيقاتها حول جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة، وأعقبتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب -المُقال أخيراً- يوآف غالانت وغيرهما، والعالم الغربي يتكشّف أكثر فأكثر. لم تكتفِ ألمانيا، على سبيل المثال لا الحصر، بموقفها الداعم بالمطلق للكيان، بل صرّحت مراراً وتكراراً عبر مجموعة من متحدّثيها الرسميّين بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنّها ستواصل تزويد الاحتلال بالأسلحة و«أي دعم آخر يحتاجه». جاء ذلك رداً على دعوى رفعتها نيكاراغوا في آذار(مارس) 2024 ضد ألمانيا، باعتبارها ثاني أكبر مزوّد سلاح للاحتلال بعد الولايات المتحدة الأميركية. ثم أطلّت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بكلمةٍ من داخل البرلمان الألماني تؤكد فيها إيضاحها للأمم المتحدة بأنّه في غزة «حتى الأماكن المدنية يمكن أن تفقد وضعها المحمي» في سبيل القضاء على «حماس». وأخيراً، صرّح السيناتور الأميركي الجمهوري جون ثون بأنّ أميركا ستحافظ على موقفها الثابت من دعم «إسرائيل»، فذلك يعد من أولويات سياستها الخارجية، ونشر تغريدة له على منصة إكس يقول فيها إنّه يجب على الولايات المتحدة «أن تمرّر تشريعاً يهدّد المحكمة الجنائية الدولية» إذا سعت الأخيرة إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغيره من المتورطين. بلغةٍ مباشرة فظة، كتب ثون: «إذا لم تتراجع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الشنيعة وغير القانونية لمتابعة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يقرّ فوراً تشريعات العقوبات، كما فعل مجلس النواب».
في المدة القصيرة التي تلت العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أي منذ ما يتجاوز الـ400 يوم، كان الغرب سبّاقاً في تبنّي رواية الاحتلال ودعمه بكل الوسائل السياسية والعسكرية والمالية والتكنولوجية وغيرها. كانت ذريعة دول الغرب في تبرير تمويل الإبادة -التي ما زالت مستمرة حتى لحظة كتابة هذه السطور- تنساق خلف مجموعة من الأكاذيب التي تناقلتها ألسنة المتحدثين باسم كيان الاحتلال، من رئيس الوزراء إلى السفراء والسياسيين والقنوات الإعلامية العبرية. ولأنّهم يمتلكون المنصّات والمنابر الأقوى، كان صوتهم يطغى في البداية على الحقائق التي تخرج من غزة. لكن مع مضي الأيام، بدأت تنتشر بكثافة الصور والتغطيات المباشرة للجرائم الصهيونية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزّل، ولم يستطع الاحتلال إعدامها مثلما أعدم المئات من الفلسطينيين الذين جرى اختطافهم خلال الحرب أو وقعوا تحت عربدة قناصي العدو وهم يعبرون الطرقات بحثاً عن الماء والخبز. حين أخذت الجرائم تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مباشرة، وباتت الشعوب «البيضاء» تشارك في التظاهرات الرافضة للمحرقة المتعمّدة، وتنظّم أنشطة موسّعة وإضرابات مؤثرة، وجدت الحكومات «البيضاء» نفسها في مأزقٍ أمام مواطنيها.
حاولت في البداية تضليلهم عبر الإعلام الرسمي والمموّل، وسعت إلى تأطير الأحداث وتغيير الحقائق، لكن ذلك لم يجدِ نفعاً. انتقلت بعدها إلى المرحلة الثانية، عبر ترهيب الناس باستعمال خدعة اللغة والمصطلحات وربطها بالقانون والعقوبات المجحفة وأعادت تعريف «معاداة السامية» وجعلتها مساوية لـ«معاداة الصهيونية» وفرضت عقوبات على من ينتقد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وحين لم ينفع كثيراً هذا القمع المباشر والملتف عبر القانون، خلعت حكومات الغرب القناع الأخير وأظهرت مباشرةً لم نشهدها بشكلها الفظ والصلف منذ انتهاء زمن الكولونيالية. هذه الدول التي أنهكت أوطاننا بتحضّرها وإنسانيّتها طوال العقود السابقة، قرّرت أنّها لم تعد في حاجة إلى كل تلك الادّعاءات. لم يعد هناك مانع من قول الأشياء كما هي، فجاء استعمالها للغة مباشراً جداً مع مواقفها العلنية الداعمة للتطهير العرقي في غزة. في ما يلي عودة إلى التاريخ، زيارة خاطفة إلى منشأ الحضارة الغربية منذ آلاف السنين لنستعيد موقفاً مشابهاً يساعدنا في إدراك وجهها الحقيقي.
في المدة الممتدة بين العصر الأركايك والحروب البيلوبونيسية في اليونان القديمة، ازدهرت دول المدن التي تسمى «بوليس» (polis) وعاش بعضها عصراً ذهبياً من التطور والتمدن والتحضّر. كانت أثينا على رأس تلك الدويلات الإغريقية، تقدّم نفسها نموذجاً باهراً يشدّ أنظار الدويلات الأخرى واهتمامها. ويمكن القول إنّ موطن الحاكم الإصلاحي بيركليس، كان الرحم الذي أنجب في ذلك العصر الديموقراطية البرّاقة والفلسفة العظيمة والسياسة المتقدّمة. لكن للمفاجأة، هذه الدويلة التي حملت اسم إلهة الحضارة والخصوبة في الميثولوجيا اليونانية، وأوجدت نظام القرار الجماعي بعد استبداد الطغاة وحكم الأوليغارشيا والطبقة الأرستقراطية في البلاد، أوقعت نفسها في حفرة أطاحت بالقيم التي كانت تتباهى بتكريسها في مجتمعها وبين مواطنيها، وتتفاخر بها على منافسيها في الدويلات الأخرى.
كل ذلك يحدث أمام مرأى العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية لأنّ «الأقوياء يفعلون ما يريدونه»
في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد، وتحديداً في عام 416، فرضت أثينا حصاراً على جزيرة ميلوس في بحر إيجه، وأعدت لها أسطولاً بحرياً مكوّناً من عشرات السفن الحربية، وآلاف المقاتلين والمشاة والرماة المدرّبين بحرفة. جاء الحصار خلال الحرب الطاحنة بين مدن اليونان وعلى رأسها أسبارطة وأثينا، ففي حين شكّلت أسبارطة حلف الرابطة البيلوبونيسية مع مدن مهمة مثل كورينث وثيبس (طيبة)، اصطفّت أثينا في الحلف الديلياني الذي أقيم في جزيرة ديلوس. لكنّ ميلوس قرّرت أن لا تتدخّل بشكلٍ مباشر في الحرب البيلوبونيسية التي امتدّت لما يقرب من ثلاثين عاماً، وسعَت لتبقى على الحياد. لم يرق ذلك للأثينيّين الذين وضعوا سكان جزيرة ميلوس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستسلام من دون مقاومة ودفع الجزية لأثينا، أو الموت. رأت ميلوس في ذلك تعسّفاً وإهانة لها ولقادتها وشعبها، فلم يكن هناك من مبرّر منطقي أو أخلاقي لإخضاعها. رفضت الجزيرة الإذلال حتى وجدت نفسها في حصار خانق أسفر عن نتائج وخيمة؛ إذ سيطرت أثينا على الجزيرة وأعدمت رجالها ونكّلت بسكانها واستعبدت النساء والأطفال.
لم يكن ليحفظ حق دويلة ميلوس في التاريخ لولا تدوين القائد العسكري ثوسيديدس «أبي التاريخ العلمي»، المنحدر من عائلة أثينية ثرية، فقد كتب «حوار ميلوس» (Melian Dialogue) في مدة نفيه خارج أثينا. رغم أنّه لم يكن حاضراً في اجتماعات المفاوضات بين المدينتَين/الدويلتَين، إلا أنّ المؤرّخ كتب تصوراً درامياً للحوار الذي دار بين الطرفين المتفاوضين على مسألة إخضاع مينوس، وأدرجه في كتابه «تاريخ الحرب البيلوبونيسية». هذا الحوار أصبح ورقة مرجعية لما جاء فيها من تناقض أخلاقي في سياسة أثينا، بين ما كانت تدّعيه وما أنزلته على سكان ميلوس. ببساطة شديدة، تخلى الأثينيون عن حرفتهم الأسمى في النقاش الفلسفي حول الأخلاق، ولم يمنحوا الطرف الآخر شرف النقاش لفهم ما أرادوه، وربما الاقتناع بوجوب إخضاع جزيرة ميلوس تحت سلطة الأثينيين. مدينة الفلاسفة وقلب الحضارة الغربية، لم تجد من الكلام ما قد يتطفّل على سمع سكان ميلوس ويلتف على عقولهم، لتبرير إصرارها على الهيمنة واستحصالها للجزية. ولم تكن تلك كل الحكاية، بل جاءت كلمات الجنرالات المبعوثين متعجّلة لتحقيق مصلحة أثينا الخاصة على حساب المدن اليونانية الأخرى. لن نثقلكم بخطابات نزعم فيها حقنا في احتلالكم، ولا نأمل أن نسمع منكم مطوّلات تبرّر حيادكم أو حقكم في استقلاليتكم، فكما «تعلمون جيداً، الحق والعدل موضع نقاش فقط بين طرفين متساويين في القوة، أما في حالة طرف قوي وآخر ضعيف؛ فيفعل الأقوياء ما يستطيعونه، ويعاني الضعفاء بقدر ما يتوجّب عليهم». بكل صلفٍ، ألقى الطرف الأثيني هذه الكلمات على شيوخ ميلوس، غير آبهين بحفظ ماء تاريخهم الحضاري.
واليوم، بعد حوالى 2.500 عام من تدمير ميلوس واستعباد سكانها الأوروبيين على يد بني جنسهم وحضارتهم، تقف حكومات الحضارة الغربية في العلن، أمام الكاميرات وفي أعلى المنابر، لتقول إنّها تدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل ما تفعله. الدعم المطلق يأتي غير مشروط على حساب المدنيين في غزة ولبنان. الدعم الكامل يبرّر المجازر المتعمّدة بحق النساء والأطفال، والتدمير الممنهج للقرى والمدن، وتفجير الأحياء السكنية ونسف أماكن العبادة من مساجد وكنائس وأضرحة. كل ذلك يحدث أمام مرأى العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية لأنّ «الأقوياء يفعلون ما يريدونه، ويتحمّل الضعفاء المعاناة بقدر ما يتوجّب عليهم».
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن