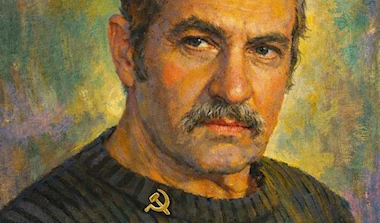| أحمد ضياء دردير
[* هذا العنوان، كما هو واضح، مستوحى من عنوان فيلم ستانلي كوبريك «الدكتور سترينغلوف أو كيف تعلّمت أن أكفّ عن القلق وأحب القنبلة»]
تبدأ تجربة القنبلة الذرية في صحراء لوس ألاموس فتنحبس الأنفاس. يتباطأ الزمن ويتوقف الصوت فلا تسمع إلا همساً؛ ووسط هذا الخشوع في حضور ميلاد أقوى أسلحة الدمار في ذلك الوقت (وأمام سلاح الدمار الذي سيحدد هوية العصر) نرى ضوءاً ساطعاً، ثم يعود الصوت ونسمع الانفجار مبشّراً بنجاح التجربة.
قيل إن الجمهور في بعض بلادنا العربية قد وقف مصفّقاً عند هذا المشهد. تدعونا هوليوود دائماً للتماهي مع المستعمِر، ولكن هذه مرحلة جديدة من الانسحاق وانهزام الكرامة تجعل بعض الناس يصفّقون لجلّادينا ولقدرتهم على إبادتنا. هذا لا يمنع أن البعض الآخر من جمهورنا يعي جيداً أن أوبنهايمر هو مجرم هيروشيما وناغازاكي وأن هذا الاختبار الناجح كان بداية الجريمة.
فهل كان الفيلم يريد لنا أن نحبس أنفاسنا من ثقل هذه اللحظة التي ستنتج عنها المجزرة، والتي سينتج عنها سباق تسلح وتوازن قوى قائم على «التدمير المتبادل المؤكد»، أم أن نحبس أنفاسنا حماسة لهذه القدرة الأميركية الجبارة التي توشك أن تولد، ويولد معها فصل جديد من سيطرة الإنسان (الأبيض الإمبريالي) على الطبيعة وعناصرها وعلى الحياة والموت؟
قراءتي هي أن المشهد يستحضر الموقفين ليغلب الثاني على الأول.
بروميثيوس وتراتبية النار
يشبه الفيلم أوبنهايمر ببروميثيوس الذي سرق النار من آلهة الأولمبس وأعطاها للبشر. الفيلم في الأساس مقتبس من كتاب بعنوان «بروميثيوس الأميركي» والإشارات إلى أسطورة بروميثيوس تتكرّر أكثر من مرة منذ بداية الفيلم.
ولكن، إذا كان أوبنهايمر قد استرق، مثل بروميثيوس، نوعاً خطراً ومحرّماً من العلم للبشر، فإنّ هذا يجعل البشر هم الأميركيين حصراً، أو لو قرأناه بشكل أوسع قليلاً ليصبح البشر هم أعضاء النادي النووي فقط (غير أن بروميثيوس الأميركي هذا قد حال دون وصول هذه النار إلى أيدي السوفيات حين وشى بزملائه الذين أرادوا تسريب المعلومات بشأنها، وظل محايداً، بحسب الفيلم نفسه، في شأن مشاركة الأميركيين لهذه التقنية الجديدة مع حلفائهم الروس في ذلك الوقت، تاركاً القرار للقيادة السياسية للولايات المتحدة، أي أن نار العلوم تصبح حقاً حصرياً للولايات المتحدة بالرغم من أن علومها في هذا الشأن قامت على كوكبة عالمية من العلماء منهم من هرب من ألمانيا النازية ونقل إلى الأميركيين علومها).
أمّا علاقتنا، نحن المشاهدين، بهذه النار فليست واحدة، بل تختلف بحسب علاقتنا بالمركز الإمبراطوري: النار التي تنير لهم هي النار التي تحرقنا. وإذا ما قرئ مشهد تفجير القنبلة التجريبية، وقرئت النار التي طغت على آخر المشهد، بروميثيوسيا تصبح هذه النار وتصبح الرهبة التي تبثها في المشاهد علامة من علامات هذه القدرة البشرية المتطورة؛ بينما إذا قرأناه في ضوء المجزرتين في هيروشيما وناغازاكي وفي ضوء القدرة السياسية التي أعطاها لأصحاب القنبلة، فلا نرى في النار سوى أشلاء الأبرياء وهي تحترق – لا أشلاء اليابانيين الذين أصابتهم القنبلة بشكل مباشر فحسب، ولكن أشلاء الذين أحرقتهم أميركا في حروب أخرى بقدرات تكنولوجية مماثلة أو مختلفة وبقدرة سياسية تستند في ما تستند إلى هذه القنبلة.
يمر حوار الفيلم عرضاً على حجم المأساة في اليابان (من دون عنصر بصري واحد بالرغم من أن هذا كان ليعطي المخرج القدرة لإظهار بعض من حرفيته التي تتفوّق بكثير على رؤيته الفنية). لكنّ الاستعارة البروميثيوسية، مع تقطيع المشاهد وقفزها ما بين المستويات الزمنية بشكل يضع الثقل الدرامي على ما عاناه أوبنهايمر من بعد القنبلة على يد رئيسيه/غريمه في هيئة الطاقة الذرية وعلى يد البارانويا المكارثية، كل ذلك يجعل أوبنهايمر، كما قال له أحد أشخاص الفيلم، يلاقي عقوبة بروميثيوس—الذي تقول الأساطير إن الآلهة قد عاقبته على المعرفة التي منحها للبشر بأن قيّدته إلى جبل لتأكل العقبان من كبده بالنهار ثم تنمو كبده بالليل لتأكلها العقبان في اليوم التالي. يريد لنا الفيلم أن نظن أن أوبنهايمر قد عوقب وأنه عوقب جزاء الجميل الذي أسداه للبشرية. بينما الحقيقة هي أنه كان مجرماً وأن ما عاناه من جراء الخلافات الداخلية الأميركية، التي يفرد لها الفيلم ثلثاً كاملاً ولا يخلو ثلثاه الآخران منها، هي مكافأة لا عقاب إذا ما قورنت بما اقترف من جرم، وأن هذه الخلافات الأميركية الصغيرة والتافهة لا ينبغي أن تعنينا إلى هذه الدرجة.
مدمّر العوالم
في مشهد تالٍ قريب نرى جمهوراً يلوّح بالأعلام الأميركية ابتهاجاً بالمجزرة ويهتف لأوبنهايمر والقنبلة، ونرى أوبنهايمر واقفاً على المنصة يتلقّى التكريم ثم يباغته الندم فيتخيل كما لو أن القنبلة الذرية قد أصابتهم هم ويرى كل من حوله وهم يحترقون أو يفرون بحثاً عن ملجأ.
نرى خلال الفيلم أوبنهايمر وهو يريد أن يتعذب ليكفّر عن ذنبه، ونراه مزهواً لأنه اخترع اختراعاً أنهى الحرب وكان من شأنه، بحسب رأيه، أن يمنع الحروب الأخرى. وفي الحالتين تُتخطى دماء اليابانيين ليصبح العالم الأميركي، بزهوه أو بعذابه النفسي، سيد المشهد.
كان من الضروري للفيلم اختلاق ضمير لمجرم الحرب، الذي لم يعلن عن ندمه يوماً. هذا الضمير المختلق ليس مهماً لجعل الشخصية أكثر آدمية وأكثر استدراراً للتعاطف فحسب، ولكن لأسباب أيديولوجية أيضاً. فأمام هذا الجمهور المتعطش للدماء، يحتاج الفيلم إلى اختلاق ضمير وبوصلة أخلاقية، لا لأوبنهايمر فحسب، ولكن للأميركيين عموماً.
ولكنّ الضمير والبوصلة الأخلاقية كانا هناك بالفعل: في زملاء أوبنهايمر الذين وقّعوا عريضة تطالب بعدم استخدام القنبلة، خاصة وقد أوشكت الحرب على الانتهاء—في مقابل أوبنهايمر الذي كان يتستر بحياد العلم ليشارك في ارتكاب جريمة العصر. وكانا هناك في رفاق أوبنهايمر القدامى من اليساريين—الذين تنصّل هو منهم، والذين حاول بعضهم تسريب سر القنبلة إلى السوفيات لكي لا تستأثر قوة واحدة بهذا السلاح المدمّر، في مقابل وشاية أوبنهايمر بهم.
هاتان النقطتان لم تفيا الفيلم حقهما؛ فبينما بدت عريضة العلماء هامشية، فإن الفيلم قد أسقط تفصيلة مهمة، إذ لم يكن توقّع استسلام اليابان محتوماً فحسب، بل كان اليابانيون قد بدأوا بالفعل في مناقشة شروط الاستسلام وكان العائق الوحيد هو إصرار الأميركيين على أن يكون الاستسلام «دون قيد أو شرط». ولم يكن الموقف الياباني وليد اعتبارات الشرف والكرامة فحسب، بل كان في الوقت نفسه وليد خوفهم من أن يعني الاستسلام غير المشروط تدخلاً أميركا مستمراً في حياتهم ومصيرهم. وفي المقابل، كان قصف اليابان بالقنبلة الذرية يضمن تدخل أميركا لا في اليابان فقط بل في سائر العالم بعد أن استعرضت قدرتها التدميرية الفائقة وبرهنت أنها لن تتورع عن إحداث مثل هذا الدمار—لولا أن وصل السوفيات إلى القنبلة فأحدثوا توازناً رادعاً أمام هذه الإرادة التدميرية الأميركية.
وأمّا الذين حاولوا تسريب سر القنبلة الذرية للسوفيات، فهؤلاء لم يدفعهم ولاء أيديولوجي للشيوعية أو محبة خاصة للروس فحسب، وإنما كان موقفاً أخلاقياً بحتاً. فإذا كان ما برّر به أوبنهايمر لنفسه، وما برّر به الفيلم، امتلاك أميركا لمثل هذه القوى التدميرية الهائلة واستخدامها، هو أن ذلك سينهي الحرب وسيحول دون نشوب حروب أخرى، فإن هذا المنطق يظل أعرج ما دامت أميركا وحدها هي من تملك هذه القدرة، وبالتالي تصبح وحدها القادرة على شن الحروب فينتفي منطق امتلاك القنبلة لمنع الحروب. أمّا عندما يمتلك القطبان الدوليان هذا السلاح فإنّ وجود هذا السلاح عند الخصم يمنع كل طرف من استخدامه. لا ولاء شيوعي هنا ولكن استقامة منطق الردع الذي كان المنطق المبرر لاختراع القنبلة من الأساس.
ولكن تنكّر أوبنهايمر لهذا اليسار الأخلاقي لم يبدأ حين وشى بعضو الحزب الشيوعي الذي كان يريد تسريب الأسرار للسوفيات. فعندما بدأ «مشروع مانهاتن» لإنتاج القنبلة الذرية كان على أوبنهايمر أن يقطع صلاته بأعضاء الحزب الشيوعي (بمن فيهم أخوه) وأن ينحّي كل العلماء من ذوي التوجهات اليسارية من فريقه بعد أن يكون قد أدار ظهره لتوجهاته هو اليسارية.
يجعل الفيلم من إدارة أوبنهايمر ظهره لمبادئه استقلالاً وفردية، ويجعل من تنكّره لزملائه خدمة وطنية، ويساق الهولوكوست بشكل غير أمين في المشهد الذي يتنكّر فيه لزملائه ليبدو كما لو أنه تنكّر لهم ليتسنّى له إنقاذ بني دينه من المحرقة، لا ليصبح إله القتل كما تشي الصلاة الهندوسية الشهيرة التي قيل إنه ردّدها بعد نجاح التجربة: «ها قد أصبحتُ الموت؛ مدمرَ العوالم».

العودة إلى لوس ألاموس
يتخيل الفيلم هذه الصحراء التي أجريت فيها التجربة صحراء خالية لا يملكها أحد؛ وعندما يتحدّث أوبنهايمر عنها يقول لا أحد هناك إلا بعض الهنود (أي أصحاب الأرض الأصليون) الذين يأتون لدفن موتاهم. هذه الإشارة تسجل— ربما من دون قصد أو تأنيب ضمير—ما دأبت عليه الولايات المتحدة الأميركية من تدنيس الأراضي المقدّسة للسكان الأصليين، بما في ذلك تلويثها بالإشعاع النووي.
قد يبدو الأمر نكاية وكأن الولايات المتحدة تتقصّد تدنيس أراضي هؤلاء—وهذا في حد ذاته حقيقي—ولكنّ المسألة في بعض الأحيان تكون أبسط من ذلك؛ إذ تبحث الولايات المتحدة عن أماكن خالية من السكان لكي تجري فيه التجارب الملوّثة للبيئة، ولأن الاستعمار قد دأب على تخيّل أراضي السكان الأصليين خالية من سكانها (وأتبعت هذا الخيال بالعمل على إخلائهم وإبادتهم في مراحل تاريخية مهمة) فإن من البديهي أن تختار أراضي السكان الأصليين الخالية، في نظر الاستعمار، من سكانها، لتجري عليها هذه التجارب.
وإشارة أوبنهايمر في الفيلم إلى الهنود الذين يأتون لدفن موتاهم، بينما تشير من دون قصد إلى الحق التاريخي لهذا الشعب في هذه الأرض، فإنها لا تجعلهم حاضرين إلا في موتهم، في اتساق مع الأيديولوجيا الأميركية التي تتخيل السكان الأصليين حتى في حضورهم غائبين لا يسكنون المكان إلا سكناً شبَحياً.
ولكن إقامة المعسكر الذري في لاس ألاموس وتفجير القنبلة التجريبية فيها لم يمثّلا فقط عدواناً على موتى السكان الأصليين وجنائزهم، إذ صادرت الحكومة الأميركية هذه الأرض من أصحابها من الشعوب الأصلية ومن الهيسبانيك (الذين يتحدّرون من خليط من نسب الشعوب الأصلية والمستوطنين الإسبان) لتقيم عليها معسكر «مشروع مانهاتن»، وفي الموقعين الآخرين في واشنطن وتينسي حدث الشيء نفسه وطاول التهجير في الأساس السكان الأصليين.
ثم بعد انتهاء التجربة استمر أثرها على هذه الأرض وعلى هذه المجتمعات من خلال التلوث الإشعاعي والغبار الذري اللذين تسبّبا في زيادة الإصابة بأمراض السرطان على مدى عقود من الزمان.
لا يفرد الفيلم مساحة لأي من ذلك ولكن قرب نهاية الفيلم، عندما يسأل الرئيس ترومان أوبنهايمر عما سيفعلون بهذا المعسكر، يقول أوبنهايمر كأنما يقول شيئاً عبثياً: «نعيد الأرض إلى الهنود». مرة أخرى تزاح البوصلة الأخلاقية من الذين ينادون بإعادة الأرض إلى أصحابها (وهم كثر بين السكان الأصليين والمتضامنين معهم) إلى مسخرة أوبنهايمر التي لا تقدّم ولا تؤخر وليس وراءها أي نية أو ضمير.
أهم أفلام القرن أم أتفهها؟
الفيلم، فنياً وعلى مستوى التمثيل والحبكة والرواية متوسط—ربما باستثناء بعض المشاهد التي يستعرض فيها المخرج براعته التقنية/السنماتوغرافية. وعناصر الفيلم لا ترتقي إلى مستوى الأسئلة التي يطرحها حدث مثل اختراع القنبلة الذرية واستخدامها. وحكايته تهرب من الأسئلة المصيرية إلى تفاصيل محلية أميركية جانبية تتعلّق بالشد والجذب في ما بين الأطراف المختلفة هناك وبمسألة الولاء لأميركا—وبالرغم من أن الفيلم في بعض أجزائه مُسلٍّ إلا أنه يصبح شديد الإملال كلما أُغرق في هذه التفاصيل. ومحاولات تسويقه كأهم أفلام القرن ما هي إلا محاولات لفرض تفاهات المركز الإمبريالي وأسئلته الفرعية على سائر العالم.
سيرياهوم نيوز3 – الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن