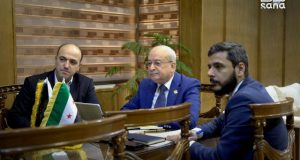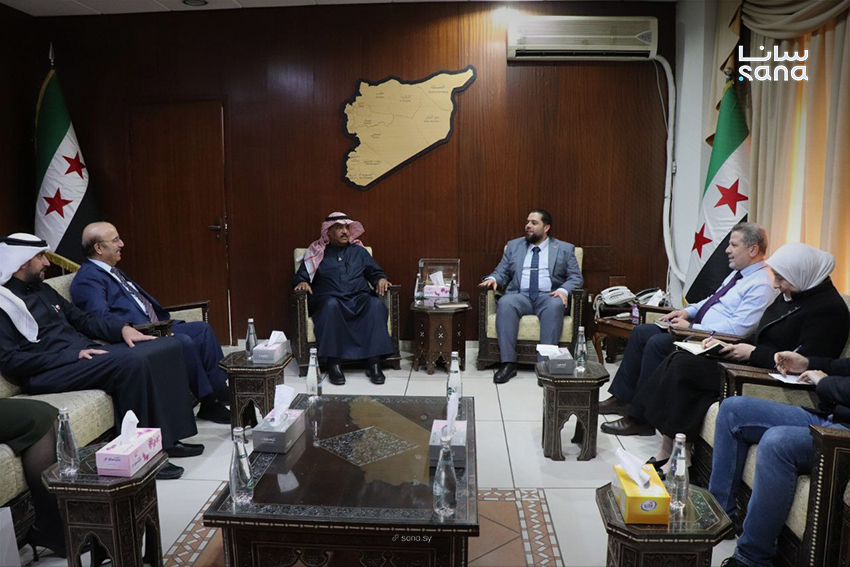ربما يكون كتاب الراهب الموصلي يعقوب الكلداني المطبوع سنة 1900، في مطبعة دير الآباء الدومنكيين بالموصل، تحت عنوان «دليل الراغبين في لغة الآراميين» من أوائل الكتب التي تطرقت في العصر الحديث إلى أصول السريان وعلاقتهم بغيرهم.
في هذا الكتاب – المكتوب باللغة العربية كمعجم آرامي عربي ولكنه لا يخلو من فقرات ومقتبسات باللغة السريانية من دون ترجمة – يكرر الكلداني في مقدمته ما بات في عداد البديهيات في زماننا من أن «جميع البلاد المعروفة بالسريانية سواء كانت شرقية أم غربية كانت معروفة في قديم الزمان بالآرامية، وهذه كانت تسميتها الحقيقية…، قد اختلفت آراء العلماء في لفظة سوريا التي منها سُمّي السريان أي اختلاف. فلقد ذهب البعض منهم لا سيما العلماء في أصل لفظة سوريا مشتقة من آثور أو آشور، اشتقها اليونانيون بعد استيلاء ملوك الآثوريين على الديار الشامية» .
«الربيع في بلاد ما بين النهرين» (بول باتو)
وفي عرضه لآراء علماء عصره ومن سبقهم يورد الكلداني رأياً لأحدهم يسمّيه ابن الصليني، وأغلب الظن أن المقصود مار ديونيسيوس يعقوب بن الصليبي مطران آمد (ديار بكر) 1171، والذي يكرر الرأي نفسه في كتاب آخر، يقول فيه: «لكنهم (أعني اليونانيين) يسموننا تعييراً لنا عوض السريان يعاقبة، ونحن نردهم قائلين إن اسم السريان الذي سلبتموه عنا ليس عندنا من الأسماء الشريفة لكونه متأتياً من اسم سوروس الذي ملك في أنطاكية فدعيت باسمِه سوريا… أما نحن فإننا من بني آرام، وباسمهِ كنا نسمى يوماً آراميين». ولا يبدو أن هذا التأثيل لاسم سوريا من سوروس يعتد به علمياً لأسباب عدة منها أن بعض الباحثين القدماء والمعاصرين يعتبرون قصة سوروس أسطورية، وقد ورد اسمه في ترجمة سريانية لأسطورة يونانية عنوانها «ديوقليوس الحكيم» موجودة في المتحف البريطاني، وقد ترجم جزءاً منها هنري بدروس كيفا الذي يعرف نفسه بالمتخصص في التاريخ الآرامي، وذكر رقمها التوثيقي المتحفي، والبعض الآخر ينفي وجود ملك آرامي بهذا الاسم لأنطاكيا، ولكن كلام الراهب الكلداني يفيدنا – وإنْ بشكل مقصود – في إلقاء الضوء على الخلافات التي كان اسم السريان يثيرها مبكراً بين الطوائف المسيحية في المشرق العربي، ويخلص إلى ثلاث خلاصات سأدرجها أدناه بحرفها لأهميتها:
ad
– «إن السريان عموماً، شرقيين أم غربيين، لم يكونوا في قديم الزمان يسّمون سرياناً بل آراميين نسبة إلى جدّهم آرام بن سام بن نوح».
– إن اسم السريان لا يمكن أن يرتقي عهده عندهم إلى أكثر من أربعمائة أو خمسمائة سنة قبل التاريخ المسيحي (أرجح أنه يقصد اعتباراً من السنة الميلادية التي كتب فيها كتابه) خلافاً لمن يحاول أن يجعل اسم السريان قديماً أصلاً للآراميين.
– والخلاصة الأخيرة والتي تهمنا هنا فيقول فيها: «إن اسم السريان لم يدخل على الآراميين الشرقيين أي الكلدان والآثوريين إلا بعد المسيح على يد الرسل الذين تلمذوا هذه الديار، لأنهم كانوا جميعاً من سورية فلسطين، وذلك إذْ كان أجدادنا الأولون المنتصرون (المتنصرون؟) شديدي التمسك بالدين المسيحي الحق، أحبوا أن يسموا باسم مبشريهم، فتركوا اسمهم القديم واتخذوا اسم السريان ليمتازوا عن بني جنسهم الآراميين الوثنيين، ولذا أضحت لفظة الآرامي مرادفة للفظة الصابئي والوثني ولفظة السرياني مرادفة للمسيحي والنصراني إلى اليوم» (ص 11، م.س).
إن تعليل إطلاق الاسم بكون الرسل الأولين نشروا رسالة المسيح في مناطق شرق الفرات جاؤوا من «سورية فلسطين» (وفي المناسبة فقد سبق لأبي التاريخ هيرودوتس أن استعمل هذه التسمية «سورية فلسطين» ومقلوبها أي «فلسطين سورية» في تاريخه الشهير في القرن الخامس ق.م، كما وثقت ذلك في كتابي «موجز تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربي الإسلامي» ص 66) قد يكون مقنعاً كفاية في مناطق شرق الفرات، ولكنه لا يعلل شيوعه في الغربية «السورية الفلسطينية» إلا على سبيل المجاز.
ويضيف الكلداني أن «بلاد السريان» كانت منقسمة إلى «قسمين عظيمين شرقي بين الفرات وبلاد الأرمن شمالاً حتى جزيرة العرب جنوباً، وغربي يمتد مما وراء الفرات إلى البحر المتوسط غرباً. وتنقسم لهجوياً إلى قسمين؛ لهجة شرقية وأخرى غربية». ويضيف الراهب الكلداني «أما الشرقية فهي لغة الكلدان الكاثوليك والنساطرة أينما كانوا، وهي اللغة الآرامية الصحيحة القديمة المستعملة يوماً في مملكتي بابل ونينوى العظيمتين والجزيرة والشام ولبنان وما يجاور هذه البلاد كما يقر بذلك الخبيرون من الموارنة خاصة… وأما اللغة الغربية المعروفة في زماننا بالسريانية بلا قيدٍ فهي لغة الموارنة والسريان الكاثوليك واليعاقبة حيث وجدوا، وهذه لا نجد أثراً لاستعمالها في جميع البلاد الآرامية ما خلا جبال طور عبدين في قرب ماردين… فلذا لا مانع أن نتخذها (نعتبرها؟) لغة جبلية متولدة من فساد اللغة الآرامية الفصيحة قد نشرها متأخراً بعض علماء السريان الأرثوذكس وجعلوها عامةً في الطقس السرياني كي يمتازوا عن النساطرة لشدة العداوة الدينية الكائنة بينهم» (ص 12).
إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من كلام يعقوب الكلداني، إضافة إلى إرجاعه أصل كلمة السريان إلى سوريا، هو أن اللغة أو اللهجة الغربية التي سميت السريانية لا وجود لها شرقاً، أي في بلاد الرافدين، حيث تسود ما سماها الكلداني «الآرامية الصحية الفصيحة القديمة»، واعتبر اللهجة الغربية «السريانية» لهجة آرامية فاسدة. ويبدو السجال المذهبي الطائفي بين مكونات الإقليم الشرقي والغربي -الكاثوليكي والأرثوذكسي- بارزاً هنا. والملاحظ أيضاً أن المسيحيين العراقيين/ وعلى اختلاف طوائفهم، نادراً ما يستعملون تسمية أو صفة السريان حين الإحالة إلى هويتهم ويركزون على البعد القومي سواء كان آثورياً/ آشورياً، أو كلدانياً، مع أن الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية في العراق توصفان رسمياً بالكنيستين السريانيتين، ولكن اسم «السريان» غير شائع في الاستعمال الحياتي اليومي.
نترك كتاب الراهب يعقوب الكلداني الموصلي، وننتقل إلى موصلي آخر هو عالم آثار متخصص ومؤرخ وكلداني أيضاً هو د. بنهام أبو الصوف (تـ 2012)، والذي يعترض بدءاً على اعتبار «الكلدان» قومية (إثنية) بل هم في نظره مسيحيون نساطرة قدماء، ومن الأتباع الأوائل ليسوع المسيح، ولكنهم من أصل آرامي، وقد تمت «كثلكة» قسم كبير منهم بمختلف الأساليب في القرن الخامس عشر بتدخل من روما، وأطلق عليهم البابا ليون، وربما يقصد البابا ليون العاشر في القرن السادس عشر، اسم «المسيحيين في أرض الكلدان». يضيف أبو الصوف «ولهذا يطلق بطريرك الكلدان على نفسه إلى اليوم لقب «بطريرك بابل على الكلدان» أي أن الكلدانية عنده مذهب ديني وليس قومية»، وهذا رأي قابل للنقاش ويثير إشكالات كثيرة أخرى. ومن مقالته المكثفة هذه، ولقاء تلفزيوني آخر نورد باختصار الخلاصات التالية:
– «بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية حلَّت اللغة الآرامية والخط الآرامي في معظم بلاد الرافدين غربي دجلة وفي الشمال وكل بلاد آشور وهذا كما أسلفت أعلاه بعد سقوط الآشوريين والكلديين، تجاورهم إلى الشرق من دجلة وفي كل بلاد إيران لغة وخط الدولة الأخمينية التي احتلت بابل في 539 ق.م.
– إن آخر كيان سياسي للآشوريين بعد خروجهم من نينوى وآشور كان في حرّان حيث قضى عليه نبوخذ نصّر مؤسس السلالة الكلدية البابلية الأخيرة.
– تأسيساً على هذا، نجد أن من كانوا يتكلمون ويتعاملون باللغة الآشورية، لغة الحاكمين في الامبراطورية الآشورية وفي كل بلاد الرافدين وأطرافها الشمالية والجبال وشمالي سوريا، قد انقرضوا تماماً في مطلع القرنين الخامس والرابع ق.م وما بعدهما، حتى مجيء المسيحية إلى هذه البلاد بعد انتشارها في بلاد الشام أولاً. وبسبب هذه الأحداث لم يتبقَ في بلاد الرافدين أية لغة آشورية أو كلدية (بابلية) ما عدا مخلفات قليلة كهنوتية في المعابد والمراكز الدينية المحافظة.
جريدة الأخبار
السريان والآراميون: مقاربة للأصول والعلاقات والتجليات [2/2]
رأي علاء اللامي الأربعاء 31 آب 2022
0
ربما يكون كتاب الراهب الموصلي يعقوب الكلداني المطبوع سنة 1900، في مطبعة دير الآباء الدومنكيين بالموصل، تحت عنوان «دليل الراغبين في لغة الآراميين» من أوائل الكتب التي تطرقت في العصر الحديث إلى أصول السريان وعلاقتهم بغيرهم.
في هذا الكتاب – المكتوب باللغة العربية كمعجم آرامي عربي ولكنه لا يخلو من فقرات ومقتبسات باللغة السريانية من دون ترجمة – يكرر الكلداني في مقدمته ما بات في عداد البديهيات في زماننا من أن «جميع البلاد المعروفة بالسريانية سواء كانت شرقية أم غربية كانت معروفة في قديم الزمان بالآرامية، وهذه كانت تسميتها الحقيقية…، قد اختلفت آراء العلماء في لفظة سوريا التي منها سُمّي السريان أي اختلاف. فلقد ذهب البعض منهم لا سيما العلماء في أصل لفظة سوريا مشتقة من آثور أو آشور، اشتقها اليونانيون بعد استيلاء ملوك الآثوريين على الديار الشامية» (ص 9).
ad
«الربيع في بلاد ما بين النهرين» (بول باتو)
وفي عرضه لآراء علماء عصره ومن سبقهم يورد الكلداني رأياً لأحدهم يسمّيه ابن الصليني، وأغلب الظن أن المقصود مار ديونيسيوس يعقوب بن الصليبي مطران آمد (ديار بكر) 1171، والذي يكرر الرأي نفسه في كتاب آخر، يقول فيه: «لكنهم (أعني اليونانيين) يسموننا تعييراً لنا عوض السريان يعاقبة، ونحن نردهم قائلين إن اسم السريان الذي سلبتموه عنا ليس عندنا من الأسماء الشريفة لكونه متأتياً من اسم سوروس الذي ملك في أنطاكية فدعيت باسمِه سوريا… أما نحن فإننا من بني آرام، وباسمهِ كنا نسمى يوماً آراميين». ولا يبدو أن هذا التأثيل لاسم سوريا من سوروس يعتد به علمياً لأسباب عدة منها أن بعض الباحثين القدماء والمعاصرين يعتبرون قصة سوروس أسطورية، وقد ورد اسمه في ترجمة سريانية لأسطورة يونانية عنوانها «ديوقليوس الحكيم» موجودة في المتحف البريطاني، وقد ترجم جزءاً منها هنري بدروس كيفا الذي يعرف نفسه بالمتخصص في التاريخ الآرامي، وذكر رقمها التوثيقي المتحفي، والبعض الآخر ينفي وجود ملك آرامي بهذا الاسم لأنطاكيا، ولكن كلام الراهب الكلداني يفيدنا – وإنْ بشكل مقصود – في إلقاء الضوء على الخلافات التي كان اسم السريان يثيرها مبكراً بين الطوائف المسيحية في المشرق العربي، ويخلص إلى ثلاث خلاصات سأدرجها أدناه بحرفها لأهميتها:
ad
– «إن السريان عموماً، شرقيين أم غربيين، لم يكونوا في قديم الزمان يسّمون سرياناً بل آراميين نسبة إلى جدّهم آرام بن سام بن نوح».
– إن اسم السريان لا يمكن أن يرتقي عهده عندهم إلى أكثر من أربعمائة أو خمسمائة سنة قبل التاريخ المسيحي (أرجح أنه يقصد اعتباراً من السنة الميلادية التي كتب فيها كتابه) خلافاً لمن يحاول أن يجعل اسم السريان قديماً أصلاً للآراميين.
– والخلاصة الأخيرة والتي تهمنا هنا فيقول فيها: «إن اسم السريان لم يدخل على الآراميين الشرقيين أي الكلدان والآثوريين إلا بعد المسيح على يد الرسل الذين تلمذوا هذه الديار، لأنهم كانوا جميعاً من سورية فلسطين، وذلك إذْ كان أجدادنا الأولون المنتصرون (المتنصرون؟) شديدي التمسك بالدين المسيحي الحق، أحبوا أن يسموا باسم مبشريهم، فتركوا اسمهم القديم واتخذوا اسم السريان ليمتازوا عن بني جنسهم الآراميين الوثنيين، ولذا أضحت لفظة الآرامي مرادفة للفظة الصابئي والوثني ولفظة السرياني مرادفة للمسيحي والنصراني إلى اليوم» (ص 11، م.س).
ad
إن تعليل إطلاق الاسم بكون الرسل الأولين نشروا رسالة المسيح في مناطق شرق الفرات جاؤوا من «سورية فلسطين» (وفي المناسبة فقد سبق لأبي التاريخ هيرودوتس أن استعمل هذه التسمية «سورية فلسطين» ومقلوبها أي «فلسطين سورية» في تاريخه الشهير في القرن الخامس ق.م، كما وثقت ذلك في كتابي «موجز تاريخ فلسطين منذ فجر التاريخ حتى الفتح العربي الإسلامي» ص 66) قد يكون مقنعاً كفاية في مناطق شرق الفرات، ولكنه لا يعلل شيوعه في الغربية «السورية الفلسطينية» إلا على سبيل المجاز.
ويضيف الكلداني أن «بلاد السريان» كانت منقسمة إلى «قسمين عظيمين شرقي بين الفرات وبلاد الأرمن شمالاً حتى جزيرة العرب جنوباً، وغربي يمتد مما وراء الفرات إلى البحر المتوسط غرباً. وتنقسم لهجوياً إلى قسمين؛ لهجة شرقية وأخرى غربية». ويضيف الراهب الكلداني «أما الشرقية فهي لغة الكلدان الكاثوليك والنساطرة أينما كانوا، وهي اللغة الآرامية الصحيحة القديمة المستعملة يوماً في مملكتي بابل ونينوى العظيمتين والجزيرة والشام ولبنان وما يجاور هذه البلاد كما يقر بذلك الخبيرون من الموارنة خاصة… وأما اللغة الغربية المعروفة في زماننا بالسريانية بلا قيدٍ فهي لغة الموارنة والسريان الكاثوليك واليعاقبة حيث وجدوا، وهذه لا نجد أثراً لاستعمالها في جميع البلاد الآرامية ما خلا جبال طور عبدين في قرب ماردين… فلذا لا مانع أن نتخذها (نعتبرها؟) لغة جبلية متولدة من فساد اللغة الآرامية الفصيحة قد نشرها متأخراً بعض علماء السريان الأرثوذكس وجعلوها عامةً في الطقس السرياني كي يمتازوا عن النساطرة لشدة العداوة الدينية الكائنة بينهم» (ص 12).
ad
إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من كلام يعقوب الكلداني، إضافة إلى إرجاعه أصل كلمة السريان إلى سوريا، هو أن اللغة أو اللهجة الغربية التي سميت السريانية لا وجود لها شرقاً، أي في بلاد الرافدين، حيث تسود ما سماها الكلداني «الآرامية الصحية الفصيحة القديمة»، واعتبر اللهجة الغربية «السريانية» لهجة آرامية فاسدة. ويبدو السجال المذهبي الطائفي بين مكونات الإقليم الشرقي والغربي -الكاثوليكي والأرثوذكسي- بارزاً هنا. والملاحظ أيضاً أن المسيحيين العراقيين/ وعلى اختلاف طوائفهم، نادراً ما يستعملون تسمية أو صفة السريان حين الإحالة إلى هويتهم ويركزون على البعد القومي سواء كان آثورياً/ آشورياً، أو كلدانياً، مع أن الكنيستين الأرثوذوكسية والكاثوليكية في العراق توصفان رسمياً بالكنيستين السريانيتين، ولكن اسم «السريان» غير شائع في الاستعمال الحياتي اليومي.
نترك كتاب الراهب يعقوب الكلداني الموصلي، وننتقل إلى موصلي آخر هو عالم آثار متخصص ومؤرخ وكلداني أيضاً هو د. بنهام أبو الصوف (تـ 2012)، والذي يعترض بدءاً على اعتبار «الكلدان» قومية (إثنية) بل هم في نظره مسيحيون نساطرة قدماء، ومن الأتباع الأوائل ليسوع المسيح، ولكنهم من أصل آرامي، وقد تمت «كثلكة» قسم كبير منهم بمختلف الأساليب في القرن الخامس عشر بتدخل من روما، وأطلق عليهم البابا ليون، وربما يقصد البابا ليون العاشر في القرن السادس عشر، اسم «المسيحيين في أرض الكلدان». يضيف أبو الصوف «ولهذا يطلق بطريرك الكلدان على نفسه إلى اليوم لقب «بطريرك بابل على الكلدان» أي أن الكلدانية عنده مذهب ديني وليس قومية»، وهذا رأي قابل للنقاش ويثير إشكالات كثيرة أخرى. ومن مقالته المكثفة هذه، ولقاء تلفزيوني آخر نورد باختصار الخلاصات التالية:
ad
– «بعد سقوط الإمبراطورية الآشورية حلَّت اللغة الآرامية والخط الآرامي في معظم بلاد الرافدين غربي دجلة وفي الشمال وكل بلاد آشور وهذا كما أسلفت أعلاه بعد سقوط الآشوريين والكلديين، تجاورهم إلى الشرق من دجلة وفي كل بلاد إيران لغة وخط الدولة الأخمينية التي احتلت بابل في 539 ق.م.
– إن آخر كيان سياسي للآشوريين بعد خروجهم من نينوى وآشور كان في حرّان حيث قضى عليه نبوخذ نصّر مؤسس السلالة الكلدية البابلية الأخيرة.
– تأسيساً على هذا، نجد أن من كانوا يتكلمون ويتعاملون باللغة الآشورية، لغة الحاكمين في الامبراطورية الآشورية وفي كل بلاد الرافدين وأطرافها الشمالية والجبال وشمالي سوريا، قد انقرضوا تماماً في مطلع القرنين الخامس والرابع ق.م وما بعدهما، حتى مجيء المسيحية إلى هذه البلاد بعد انتشارها في بلاد الشام أولاً. وبسبب هذه الأحداث لم يتبقَ في بلاد الرافدين أية لغة آشورية أو كلدية (بابلية) ما عدا مخلفات قليلة كهنوتية في المعابد والمراكز الدينية المحافظة.
ad
– في القرن الأول الميلادي كانت اللغتان السائدتان هما الآرامية في بلاد الشام مع اليونانية والفارسية في شرقي بلاد الرافدين وإيران وحتى مجيء الفتح العربي الإسلامي، وبدأت اللغة العربية -ومن ثم خطها- يحل محل الفارسية في شرق العراق كما صار يزاحم الآرامية (التي صارت تدعى الآن السريانية – من سورث أي سوريا) بعد أن تبنى المسيحيون الجدد هذه اللغة وأطلقوا عليها السيريانية لأنهم اعتبروا الآرامية هي لغة الوثنيين فصارت معظم مدن بلاد الرافدين وبلاد الشام تتكلم العربية، واستمرت السريانية (وريثة الآرامية) في الكنائس ولدى بعض القطاعات المحافظة في بلاد الرافدين وبلاد الشام، إلا أنها استمرت كلغة التداول خارج المدن وفي قرى وقطاعات منعزلة في كل بلاد الرافدين وبلاد الشام وما زالت».
ما يهمنا في الاقتباس الأخير أن الباحث أبو الصوف يميز بين الآرامية ووريثتها السريانية، بما يذكرنا بالتفريق الذي قال به الراهب يعقوب الكلداني، حول أصل تسمية السريان ويرجعه إلى سوريا، أو «سورث» كما يستدرك أبو الصوف من دون أن يوضح أصل لفظة «سورث» وبأي لغة وردت بهذا التصويت.
الاحتمال الذي عبر عنه الباحث جعفر المهاجر حول اسم السريان لا يوجد ما يؤيده ويرجحه، فصيغ النسبة التي أوردناها ومنها السوراني لا تلتقي مع الصيغة الأشيع أي السرياني
نصل الآن إلى وجهة نظر المؤرخ جعفر المهاجر، الذي ينسب السريان «إلى حاضرتهم سورى، القرية المعروفة بهذا الاسم حتى اليوم في نطاق مدينة الحلّة. الذين كانوا قد تنصّروا في فترة الحكم الروماني لهم، من دون أن يتمسحنوا، كما سيفعل الرومان». ويضيف في فقرة أخرى «إنّ أصالة الجماعة التي ستُعرفُ في ما بعد باسم قريش في النبط هي من الأُمور الثابتة. من أبرز شواهدها عبارة علي عليه السلام الشهيرة: «مَن كان سائلاً عن نسبنا فإنّا نبطٌ من كوثى». وثانية عن ابن عمّه ابن عباس: «نحن معاشرَ قريش حيٌّ من النبط من أهل كوثى». و»كوثى» هذه اليوم قريةٌ في نطاق الكوفة. والظاهر أنّه بعد قرنٍ تقريباً من دمار «الحجر» حصلت هجرةٌ نبطيّةٌ معاكسةٌ كبيرةٌ من «كوثى» باتجاه «الحجاز» نزلت الوادي الصغير الذي تتوسّطه الكعبة، التي كان النبي إبراهيم عليه السلام قد رفع قواعدها في قصّةٍ معروفة».
لنبدأ من البلدة البائدة التي تحمل اسم سورا أو سوراء، وتلفظ بالألف الممدودة والمقصورة وأحياناً بالشين، ويسميها العامة باللهجة العراقية العربية «سورة»، ويكتبها الشيخ يوسف كركوش الحلي في كتابه «تاريخ الحلة» سيور. وقد أخذت اسمها من أحد رواضع نهر الفرات قرب مدينة الحلة (حاضرة الإمارة المزيدية الأسدية التي أنشئت في عام 388هـ/998 م)، وهو النهر الذي سماه المؤرخ والآثاري العراقي أحمد سوسة نهر سوران، وهو نهر مندرس الآن. وتذكر المصادر العربية الإسلامية وجود «جسر فوق هذا النهر يعرف بجسر سورا، وهو الجسر الذي أكسب مدينة سورا أهمية في تاريخ العراق، إذ يُعدُّ هذا الجسر الطريق الرابط بين الكوفة والمدائن وبغداد، كما كان معبراً للجيوش الإسلامية أيام الفتوحات الإسلامية (مقالة تعريفية بمدينة سورا الآثارية على موقع «مركز تراث الحلة»).
وقال الباحث د.أحمد سوسة إنَّ سورا كانت في الأصل «مدينة بابلية قديمة ومركزاً من المراكز المهمة» ولم يوثق هذه المعلومة بأدلة آثارية أو تأريخية، ولهذا يبقى كلامه مجرد معلومة قابلة للبحث والنقاش. أما لفظ سورا فذكر د. يوسف كاظم الشمري وحمدية صالح الجبوري في بحث مشترك لهما بعنوان «مدينة سورا قراءة في نشأتها وآثارها الفكرية والعمرانية والجغرافية» إنه «عبري» ويعني الأرض المنخفضة، وهذا ما لم يؤكده د. أحمد سوسة مع أنه من أصول يهودية ويجيد العبرية ومسقط رأسه الحلة نفسها كما تقول سيرته الشخصية، وقد تكون البلدة قد وجدت حقاً قرب بابل القديمة، وسكنها اليهود بعد السبي البابلي في عهد نبوخذ نصر فصاعداً ولكن هذا لا ينفي أنها ظلت بلدة صغيرة ثانوية قياساً إلى الحواضر الأخرى في بلاد الرافدين القديمة أو العربية الإسلامية. وبهذا وصفها الإدريسي حيث قال بأنها «مدينة حسنة متوسطة القدر». أما ابن حوقل فوصفها بقوله: «هي مدينة مقصودة» أي واقعة على طريق المسافرين والتجارة، ولهذا يقصدها الناس، وذكر أن حفر نهرها «يرجع إلى زمن مُلك الأردوان، وهم النبط» ويرد أيضاً أن «هذا الاسم أطلق على النهر تيمناً بابنة جميلة لهذا الملك وهي أم سابور بن أردشير ملك الساسانيين»؛ ورغم الطريقة البدائية في هذا الوصف الجغراتاريخي، وعدم وجود ملك نبطي سوادي بهذا الاسم الذي يتكرر في السردية العربية الإسلامية مثله مثل النمرود، ولكن الخبر بصيغته العامة قد لا يخلو من الصحة، فالنبط أو من يسمَّون «نبط السواد» كانوا يشكلون غالبية سكان العراق قبل الإسلام إذا ما اتفقنا على المعنى المجازي للأنباط كاسم أطلق على عموم بقايا الأقوام الجزيرية القديمة في الرافدين، ولكن الروايات حولهم يختلط فيها الأسطوري والحكائي، والموثق بغير الموثق آثارياً ولغوياً.
وقد أشارت بعض الروايات كما يذكر الشمري والجبوري في بحثهما إلى أن تأسيس سورا كان في 403 هـ / 1013 م، فيما يُستشَف من روايات أخرى أن تأريخ تأسيسها يعود إلى تأريخ أقدم قليلاً من ذلك وتحديداً إلى عهد الخليفة العباسي القادر (تـ 1031م) الذي كان قد منح الأمير علي بن مزيد الأسدي لقب أمير وأصبحت سورا و«حلة بني مزيد» عموماً في العهد البويهي «ملجأ اللاجئين»، وهذا التوريخ قد لا ينفي الكلام عن وجود البلدة في العهد البابلي، ولكنه ربما يسجل بداية نشوء جديدة لها في العصر العربي الإسلامي كملاذ للاجئين والمطاردين.
وقد شهدت سورا بعض الصعود بعد الفتح الإسلامي وربما كانت قبله بفترة لا يمكننا الجزم بأمدها مقصداً لبعض المهاجرين المسيحيين الآراميين القادمين من جهات العراق الأخرى ومن سوريا خلال القرن الخامس عشر، مع بدء عملية كثلكة النساطرة الشرقيين من قبل السلطات الدينية والزمنية الرومانية التي تطرق إليها بهنام أبو الصوف فيما سلف، وما تخلله ذلك العهد من اضطراب واضطهاد للرافضين المتمسكين بمذهبهم النسطوري، ولكن سورا لم تكن مركزاً مسيحياً مشهوراً للنساطرة أو لليهود (أسست فيها مدرسة دينية يهودية سنة 247م، كان فيها كبار الحاخامات، كما تخبرنا بعض المصادر) بل بقيت محطة تعايش فيها الجميع طوال قرون قبل وبعد الإسلام.
ad
إنَّ هذا الحضور السرياني في بلدة سورا مهما كانت كثافته، وهي بهذا الحجم المتوسط عمرانياً، متأخر زمنياً عن تكرس مصطلح السريان بزمن طويل، وعليه فمن غير الصحيح أن يقال أن لفظ «السريان» أخذ أو اشتق من اسم بلدة سورا، ومن اللافت أننا نقع على إشارات عديدة على أن أرض بابل بعامة ومنها منطقة سورا كانت تسمى بلد أو أرض النبط السريان في كتابات متأخرة ضمن عملية توحيد المواصفات التي دأب عليها البلدانيون والمؤرخون العرب بين السريان والأنباط، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن اسم «السريان» قد اشتق من هذا الإقليم أو من هذه البلدة وسنذكر العديد من اشتقاقات النسبة إليه بعد قليل.
في العصر العربي الإسلامي تخبرنا المصادر سالفة الذكر أنَّ سورا: أمست في العصر العباسي المتأخر حاضرة علمية، أنجبت العديد من العلماء والمحدّثين، منهم من ولِد فيها ونُسب إليها، واختلفوا في صيغة النسبة إليها بين (السّوراني، والسّوراوي، والسّيوري)، ومنهم من اتَّخذها وطناً له، ومنهم من قصدها لينهل من علم رجالها، ومنهم الكُليْني (تـ 329هـ). ويُنسب إلى سورا من أهل العلم الفاضل الشيخ مقداد بن عبدالله السيوري الحلي الأسدي (ت 826هـ) صاحب «كنز العرفان»، وإبراهيم بن نصر السّوراني من أهل سورا، والحسين بن علي بن جود السّوراني الحربي، كانت داره عند سورا، فقيل له السّوراني، والشيخ علي بن يحيى بن علي الخياط السّوراوي، وأبو منصور السّيوري أديب وله شعر جيد، وغيرهم الكثير ممَّن ينتمي إليها.
إن ما ورد في هذه الاقتباسات يظهر لنا أن الاحتمال الذي عبر عنه الباحث جعفر المهاجر حول اسم السريان لا يوجد ما يؤيده ويرجحه، فصيغ النسبة التي أوردناها ومنها السوراني لا تلتقي مع الصيغة الأشيع أي السرياني، ثم أن تاريخ بلدة سورا أحدث عهداً من ظهور التسمية شمالاً في بلاد الشام.
إن الاعتقاد السائد والأوسع انتشاراً يذهب إلى كلمة «سوريا» ذاتها هو تحريف يوناني للفظة آشور باليونانية «أسيريا» لتصبح «سيريا» بعد حذف الألف في بداية الكلمة، وهذا بخصوص اسم الإقليم الواقع في شمال بلاد الرافدين وجزء من غرب سوريا وهو موطن الآشوريين ومهد دولتهم على نهر دجلة قبل أن تتوسع نحو الفرات. وأرجح من جانبي أن تكون لفظة «سريان» هي النسبة/الجنسية في اللغة اليونانية والرومانية القديمتين، وذلك بإضافة النون إلى سيريا لتكون «سيريان» كما يحدث في النسبة/ الجنسية في اللغات الأوروبية المعاصرة إلى سوريا، فهي بالإنكليزية «Syrian» وفي الفرنسية «syrien»، والأصل في كل ذلك هو اسم الإقليم الآشوري سالف الذكر، والتحديد والذي نجد ترجمة النسبة منه «الآشوري» في الإنكليزية والفرنسية ليست بعيدة عن ترجمة نسبة «السوري»، فهما: في الإنكليزية «Assyrian» وفي الفرنسية «Assyrien».
أمّا عن بدء انتشار تسمية السريان بين المتحدثين بالآرامية الذين اعتنقوا المسيحية فيعتقد باحثون أنه كان في القرون المسيحية الأولى وتبنوا لهجة مملكة الرها «الآرامية» كلغة طقسية لهم. وتستخدم هذه التسمية حالياً بشكل خاص بين أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية والكاثوليكية وبعض الموارنة، وهذه التواريخ لاحقة بزمن طويل لصعود بلدة سورا قرب الحلة.
كنت قد رجحت في مقالة سابقة قبل بضع سنوات أن تكون مقولة الإمام علي «نحن نبط من كوثى» قد جاءت في سياق المثلنة الإنسانية الإسلامية التي تساوي بين البشر وتنحاز إلى المستضعفين كالنبط المذمومين من قبل المغالين في عروبتهم وأصولهم القبلية فساوى نفسه وعشيرته بهم، إذ لا توجد أية تنسيبات وتأصيلات تؤكد أية علاقة للنبط بقريش غير هذه المقولة رغم أن العرب هم أهل التأصيل والأنساب والمتخصصون الأوائل فيها بين شعوب المنطقة. وأرجح أن يكون الشيخ يوسف كركوش الحلي صاحب «تاريخ الحلة» قد قارب هذا المعنى في تفسيره لمقولة الإمام علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس عن أصل قريش النبطي من كوثى حين يقول في معرض انتقاده لازدراء النبط ودفاعه عنهم باسم النظرة الإسلامية «وهذه نظرة سامية إلى هذا الشعب -النبطي- لم تمنع الإمام علي (ع) غطرسة الحاكمين من أن يقول إن أصل قريش من نبط كوثى بينما كان أهل كوثى فلاحين محكومين وقريش سادة حاكمين. وبهذه الروح أخذ الإسلام يغزو الأفئدة في الشعوب غير الإسلامية» (ص 4، «تاريخ الحلة»)، وفي ذاكرتي أن الباحث التراثي العراقي الراحل هادي العلوي قد ذكر هذا المعنى صراحة قبل أكثر من عقدين، ولكنني للأسف لا أستطيع توثيق قوله هذا، إذ لا أتذكر إنْ كان أورده في مقالة صحافية أو في أحد كتبه.
ملاحظة أخيرة بخصوص كوثى، إذْ يخلط البعض بين كوثى والكوفة ويحيل الواحدة إلى الأخرى، وهذا غير صحيح فلا علاقة بين الاسمين/ البلدتين؛ فكوثى «وهي اليوم قريةٌ في نطاق الكوفة»، كما يقول المهاجر بصواب، وهي بالسومرية «كودوا»، وهي بلدة بائدة وتسمى حالياً تل إبراهيم، هي مدينة سومرية قديمة تقع حالياً في محافظة بابل في العراق، أي أنها أقدم من ظهور الآراميين والنبط والسريان بأكثر من ألف عام، وتقع على الجانب الشرقي لنهر الفرات، شمال مدينة نيبور وتبعد 25 ميلاً شمال شرقي بابل. أمّا الكوفة فهي من المدن التي مصَّرها العرب المسلمون كمعسكر لقوات الفتح، وتقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات الأوسط الذي يسمى شط الهندية القديم، شرق مدينة النجف بنحو عشرة كيلومترات. وقد أصبحت الكوفة عاصمة دولة الإسلام في عهد الإمام الخلفية الرابع علي بن أبي طالب، واسمها كما يذهب بعض البلدانيين واللغوين القدماء من التكوف أي التجمع، وسميت كوفاني وهي المواضع المستديرة من الرمل، وعندهم أنَّ كلَّ أرض فيها الحصباء مع الطين والرمل تسمى «كوفة».
سيرياهوم نيوز 1- الاخبار اللبنانية
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن