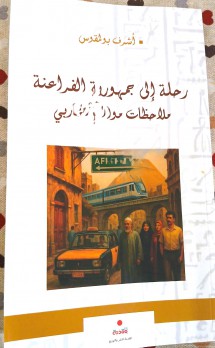تتداخل وجدانات الشعراء وأحاسيس كلماتهم مع دماء الشهداء ليظل الوطن مزهراً ومزدهراً، ويظل الأثر مشعاً بألوان سندسية أزلية وأبدية، وهذا ما يألفه التاريخ الإنساني، خصوصاً، العربي والسوري الذي ما يزال يفخر بشهدائه المستمرة أرواحهم الطاهرة بحراسة الأرض والسماء لأنهم “أحياء عند ربهم يرزقون”، فترى المعاني تبكي مع قصيدة الشاعر فارس الخوري “ذكرى الشهداء” وهو يرثيهم بحرقة: “أبكي ومعذرة عيني إذا ذرفت، على الغطاريف منها والأساطين، بيضُ الصحائف ما هانوا ولا غدروا، أنقى وأطهر من زهر البساتين”.
تلك الأزهار التي تتفتّح في قصيدة “ملحمة الجلاء” للشاعر محمد سليمان الأحمد ـ بدوي الجبل ـ الذي كان مقاتلاً إلى جانب صالح العلي ورفاقه، لتعطّر عناصر الكون برائحة الشهداء وتراب وطنهم الشامخ: “أيها الدنيا ارشفي من كأسنا، إن عطر الشام من عطر السماء، شهداء الحق في جنّتهم، هزّهم للشام وجد ووفاء”.
واقعية الانتماء العربي شعرياً
والملفت بجاذبية لانهائية، وعبْر الأزمنة، أن الروح الشعرية دائمة التلاحم مع الروح الشهيدة، وتلمع بخلودها العربي والقومي والإسلامي، ويذكر التاريخ ما ورد في شعر حسان بن ثابت: “فقلت لها إن الشهادة راحة، ورضوان ربّ يا أُمامَ غفورُ”، وأبو تمام، وابن الجيّاب الغرناطي الأندلسي، وما تلاهم من الشعراء أمثال السياب، وأحمد زكي أبو شادي، وإبراهيم وفدوى طوقان، وعبد الرحمن بارود، وجميل صدقي الزهاوي، والشاعر القروي ـ رشيد سليم الخوري، ومحمود درويش، والبياتي، والجواهري، وأحمد شوقي، وجبران، وغازي القصيبي، ونازك الملائكة، وأدونيس، والشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود الذي لحّنت وغُنيت قصيدته ومن أبياتها “سأحمل روحي على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى، فإمّا حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا”، والشاعر الحمصي جورج أطلس من شعراء المهجر، الذي كان مقيماً في الأرجنتين “تبكيك حمص وما تحويه من نزه، يبكيك “ميماسنا” يبكيك عاصينا”.
وعموماً، اتسمت قصائد الشعراء العرب من المحيط إلى الخليج وفي بلاد المهجر بالحماس الوطني والانتماء العربي القومي، والدلالات المعبّرة عن خلود الشهداء، المعطّرة بآثارهم غير القابلة للفناء، وتمتعت القصائد بأسلوب فني تعبيري واقعي ومتخيّل بأبعاد روحية تفلسف الشهادة والمحبة بصوفية شفافة عالمها الأبدية.
الشهداء شعراء
وانتهج الشعراء السوريون في قصائدهم عن الشهادة والشهداء والوطن تنويعات متناغمة مع هذه الروح النقية المنتمية بقوة إلى جماليات كل من الفعل الشهيد كأعلى المراتب المعبّرة عن حب الله والوطن، وجماليات المقول الشعري المتناغم مع الصعود الأزلي للروح والمعاني، وامتزاجها الهاطل في الضمائر، الملتحم مع الطبيعة، المتحول إلى ورود وأشجار وأكوان سندسية، المنبثق لوحات شعرية تصويرية وواقعية وتشكيلية ورمزية ووصفية تتخللها حكائية شعرية عن الشخصية الشهيدة، خصوصاً، وأن من بين شهداء السادس من أيار أدباء ومفكرين وإعلاميين وشعراء من بلاد الشام، منهم أدباء ومفكرون وإعلاميون سوريون شهداء أعدمهم جمال باشا السفاح في (6/5/1915ـ 1916) مع قافلة الشهداء الأولى والثانية في دمشق، وهم شكري بك العسلي، ورفيق رزق سلوم، وعبد الحميد الزهراوي، بالإضافة إلى شهداء آخرين من سورية مثل شفيق بك مؤيد العظم، ورشدي الشمعة، والأمير عمر الجزائري حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، وستظل سورية تكرم شهداءها في السادس من أيار وشهداء تشرين وشهداء الحرب الإرهابية الأخيرة، ليس كل عام فقط، بل على مرّ اللحظات والأيام، لأنهم العيد الذي يمجّد تضحيتهم الوطنية ضد كل محتلّ وإرهابي وظلامي، وهو ما تفعله يومياً مع كل شهيد ضحّى سواء في قلعة حلب، أو الجامع الأموي، أو مشفى الكندي، أو في أي بقعة أخرى من ترابها الطاهر.
مكاشفة سباعية الزهراوي
وبلا شك، يستوقفنا الشهيد المفكر والكاتب والصحفي والنهضوي القومي العربي عبد الحميد الزهراوي، مؤسس جريدة “المنير” وجريدة “الحضارة”، ورئيس المؤتمر العربي الأول في باريس عام 1913، الذي خلدته سورية بتسمية العديد من المدارس والصروح الثقافية باسمه، كما صدرت أعماله الكاملة عام 1995، ولقارئ أشعاره أن يغوص في أبعاد صوفية فلسفية متأمّلة، تختزل الكلمات بإيقاعات تختزل الإنسان والكون، وتمنح الطمأنينة الواثقة بالخالق والعمل للوصول إلى ذاك الخلود الذي ناله بالشهادة الحاضرة في يومياته وأبياته، ومنها خاتمة قصيدته السباعية: “وعندي وراء الكل وحي بروحه، لروحي لا ريبٌ إليه يطول، فلا تكثرنّ الهمّ في كل طارئ، فإن تماثيل الجفاء تحول، وتأتي عنايات وتبدأ مراحمٌ، وللربّ سرٌّ غامضٌ وجليل”.
وكما تبدأ قصيدته بالثقة اللامتناهية بالربّ تنتهي عابرة بسكون القلب المتحدي لكل هبوب مزعج، محاورة ذاتها والقصيدة والآخر، موقنة بأن رحلتها العابرة في الحياة ستوصلها إلى الحياة اليقينية المضاءة بالاستشهاد.
نبالة الحياة الأرضية والسماوية
ولم يكن من الشهيد الكاتب الأديب الحقوقي الإعلامي الموسيقي رفيق رزق سلوم حين علم بمن أوشى به للعثمانيين إلاّ أن سامحهم، كما أخبر بذلك أمه عبْر رسالة إليها ذكر فيها أسماءهم، وتقدّم بكل ثقة الفارس المطمئنّ إلى حبل المشنقة الذي التفّ على عمره وهو في الخامسة والعشرين، تاركاً وصيته شعراً لتُكتب على قبره: “وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جداً، فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجداً، وإن ضيّعوا عيني حفظت عيونهم، وإن هم هووا عني هويت لهم رشداً، وإن زجروا طيراً بنحس تمر بي، زجرت لهم طيراً تمر بهم سعدا”.
وتتضمن هذه الأبيات الدامعة من شدة الألم والنقاء نبالة الإنسان الشهيد الشاعر الأخلاقية، فتدفع السيئة بالتي هي أحسن، وتخبرهم بما عليهم أن يفعلوه، مستصرخاً ضمائرهم أثناء حياته الأرضية والعلوية، لعلهم حين يقومون بمحاكاة الكلمات التي كتبها أمام أعواد المشانق وهو مبتسم بشجاعة قائلاً: “يظهر أن مكاني هناك”؛ لعلهم يستضيئون بضميرها وفاعلها ليخرجوا من بوابة الظلام ويدخلوا بوابة الضوء.
أيضاً، مما أوصى به أهله في رسالته ألا يحزنوا لأن روحه حولهم تراهم، وكأنه الروح القادمة من الغيب إلى الحاضر وهي تتراءى العالم الملموس ومنه ترائيها لجثمانها المعلق على المشنقة وهي تخطو إليها بشجاعة وطمأنينة: “ثقوا بأن روحي ترفرف دائماً فوقكم، فأرى كل حركة من حركاتكم ولا ترونني، فإذا حزنتم أهرب من عندكم، وإياكم أن تغيروا ثيابكم، أو عادة من عاداتكم”.
كم تحمل هذه الكلمات من شفافية ميتافيزيقية متحركة بشعرية عميقة بين البساطة والاختزال كما يتحرك الموج في أحضان البحر، فيترك موسيقاه كما تركها الشهيد رفيق رزق الله سلوم على الفضاء العازف مثله على القانون والبيانو والعود والكمان، وكأنها “سوناتا” تردد أبياته في قصيدة أخرى، تحثّ على بناء الإنسان والوطن من خلال العمل الجاد والفخر بالعلم والتاريخ لصياغة المجد الوطني العربي القومي: “الفخر بالجِدّ لا بالجَدّ والحسب، والفضل للعلم، ليس الفضل للنسب” ويضيف بشعرية استفهامية منحازة لإجابتها المتضمَّنة فيها: “تُرى…، يعيد لنا التاريخ رونقنا، وننقذ المجد من خطبٍ ومن نوب”.
أيقونات معطّرة للمجد
وللشاعر خليل مردم بك فروسيته الوطنية والشعرية، ولا سيما أنه كان وزيراً، ورئيس المجمع العلمي العربي، ومؤسس الرابطة الأدبية ومجلة “الثقافة”، وكاتب كلمات النشيد الوطني “حماة الديار” التي لحنها الأخوان اللبنانيان أحمد ومحمد فليفل، ومن قصائده التي بكت معه شهداء ميسلون “ذكرى يوسف العظمة”: “أعكف على جدث في عدوة الوادي، بميسلون سقاهُ الرائح الغادي، وطأطئ الرأس إجلالاً لمرقد من قضى له الله تخليداً بأمجاد”.
بينما يخاطب بدر الدين الحامد بقصيدته “عيد الجلاء” الشهيد البطل يوسف العظمة ورفاقه: “يا راقداً في روابي ميسلون أفق، جلت فرنسا فما في الدار هضام، لقد ثأرنا وألقينا السواد وإن…مرت على الليث أيام وأعوام”.
وبأسلوبه الكاشف عن الواقع، وشتات الحال العربي، يمجّد الشاعر نزار قباني الشهيد، مؤكداً على أن دماءه الصادقة الوحيدة مثل روحه المعطاءة هي الطريق إلى التحرير: “يا أشرف القتلى، على أجفاننا أزهرت، الخطوة الأولى إلى تحريرنا، أنت بها بدأت، يا أيها الغارق في دمائه، جميعهم قد كذبوا، وأنت قد صدقت، جميعهم قد هزموا، ووحدك انتصرت”.
لكن سليمان العيسى، شاعر العروبة والطفولة، يظل من أروع الشعراء الذين كتبوا قصائد أيقونية للشهداء، لذلك، أختم بأجمل الأبيات المعبّرة بفنيات جمالية تجمع الموت بالأغاني الخضراء، وتترك للرعد والبرق والمطر وصهوات الريح والطبيعة تحولاتها المتفاعلة مع حياة الشهيد الأبدية، فترتعش الدلالات والإيقاعات والأرواح وهي تقرأ:
ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا عند الشهيد تلاقى الله والبشر
ناداهم الموت فاجتازوه أغنية خضراء ما مسها عود ولا وتر.
سيرياهوم نيوز 2_البعث
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن