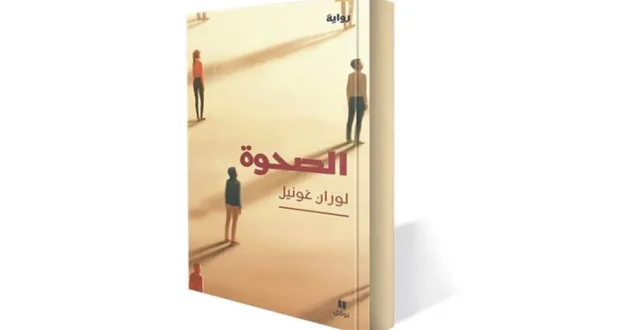رولا عبدالله
لا تُقاس رواية الكاتب الفرنسي لوران غونيل، الصادرة بعد صدمة كونية – كالجائحة – بما تقول فقط، بل بما تمتلكه من جرأة على إعادة ترتيب وعي القارئ. في هذا السياق، جاءت “الصحوة” الصادرة حديثاً عن دار نوفل/هاشيت انطوان (ترجمة كريستيل صوفي عزيز)، لا بوصفها حكاية متخيّلة عن وباء، بل كمنصّة أدبية لتفكيك علاقة الإنسان بسلطته ومجتمعه وإعلامه وذاكرته. استند غونيل إلى أدوات غير روائية: قراءات نفسية واجتماعية ودراسات حول صناعة الطاعة والسيطرة الذهنية، ليُحمّل السرد حمولة معرفية كثيفة جعلت الرواية أقرب إلى “مختبر أفكار” منها إلى عمل تخييلي صرف. وهذه القوة نفسها ستصبح لاحقاً نقطة النقد الجوهرية.
إذ لم تعد المخاطر التي تهدّد حياة الإنسان اليوم مجرد أحداث عرضية، بل صارت جزءاً من طريقة اشتغال النظام نفسه: حوادث السير التي تُقدّم بوصفها قدراً يومياً فيما هي نتاج بنية مدينية تفضّل السرعة على الأمان، السكّري الذي يُعامل كخلل فردي فيما هو نتيجة منظومة غذائية صناعية شاملة، الشرائح الذكية والكاميرات التي تُباع لنا بعبارة “الأمان” بينما تؤدي عملياً إلى تعميق هندسة السلوك عبر التتبّع الدقيق، بطاقات الدفع الإلكترونية التي تُسوّغ كحلّ للسرقة والجريمة لكنها تُنشئ تبعية مالية كاملة قابلة للإغلاق بقرار واحد، والاحترار المناخي الذي يُروّج له كقدر كوني بينما هو حصيلة تفويض بلا سقف لرأس المال. هذه الأخطار الخمسة لا تعمل متفرّقة، بل كحقل تدريب طويل على التطبيع مع فكرة أن حياتك تُنظَّم، وتُراقَب، وتُكشَف، وتُدار، بذرائع الحماية نفسها.
من جهة الفكرة، ينجح غونيل في تحويل الجائحة من حدث صحي إلى مرآة سياسية ومعرفية. لا يكتفي بوصف النظام العالمي في طور إعادة توزيع سلطته، بل يذهب إلى تحليل آليات الإذعان وصناعة الخوف وتطبيع الاستثناء، وهو بذلك يعيد الاعتبار للأدب بوصفه أداة قراءة لا مجرد وسيلة تسلية. غير أنّ هذا النجاح المعرفي يُصاحبه ميل إلى المباشرة: فحضور تشومسكي وبيدرمان ومفاهيم هندسة الوعي يبدو أحياناً كإحالات جاهزة تُستدعى لإسناد الفكرة بدل أن تُهضَم عضوياً داخل البنية الروائية. ما يرفع منسوب اليقين ويهبط بمنسوب الالتباس الضروري للفن.
أما على مستوى الشكل، فالرواية تُبنى بإيقاع سردي يلتقط حالة الهلع الجماعي ويعيد ترجمتها في لغة متوترة تقف على حدود التقرير والتحليل. القارئ لا يدخل في “حياة شخصيات” بقدر ما يدخل في “حالة فكرية” تصاحب الشخصيات. وهذا خيار جمالي واعٍ، يقوّي وظيفة الرواية النقدية لكنه يضعف التعلّق العاطفي ويقلّل من أثر التعاطف التخييلي الذي يُعتبر عادة محرّكاً داخلياً لرسوخ العمل في الذاكرة. الشخصيات في “الصحوة” تُستخدم كبنية حمل، لا ككائنات حيّة كاملة، وهو ما يمنح النص صلابته الفكرية ويحرمه مرونته الحكائية.
وفي دينامية التواطؤ بين الشكل والمضمون، يكسب غونيل حين يضع القارئ في مواجهة الأسئلة التي حاولت الأنظمة والأزمات كتمها: من يملك تفسير الواقع؟ من يعرّف الخوف؟ ومن يُقرّر ما إذا كانت حياة البشر مجالاً للتجربة السياسية؟ لكنه يخسر حين يتحوّل النص في مواضع كثيرة إلى ما يشبه بياناً مُعلَّلاً لا رواية مفتوحة على التعدّد. فالرواية التي تعلن أطروحتها بوضوح تقترف ضد نفسها ما تتهم الواقع بفعله: تضييق تعددية التأويل.
خلاصة القول: “الصحوة” ليست رواية ضعيفة لكنها أيضاً ليست رواية بلا ثمن. إنها عمل قوي حين نقرأه كوثيقة أدبية عن وعي ما بعد الجائحة، وحين نُحاسبه كأدبٍ خالص يظهر مقدار ما دفعه من حيوية التخييل لقاء ما كسبه من صلابة الأطروحة. قوتها أنها توقظ القارئ، ونقصها أنها أحياناً لا تترك له مسافة ليحلم بعد أن يستيقظ.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن