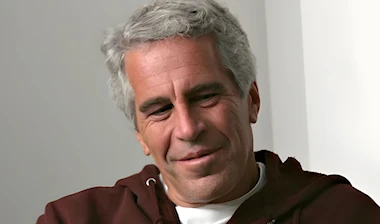|رياض ملحم
لم تكن صدفةً أبداً أن يتزامن ظهور العولمة مع هيمنة نظام القطب الواحد. فالعولمة، في صميم ميكانيزميات عملها، هي «أعلى مراحل الإمبريالية»، والولايات المتّحدة، بعد تربّعها على عرش النظام الدولي في بداية التسعينيات، جسّدت، عن سابق تصوّر وتصميم، الهيمنة الإمبريالية الجديدة على العالم. العولمة، على هذا المستوى، إذاً، ليست عالم الكرة الأرضية الجديد، بل هي عالم القطب المهيمن، وهذا العالم هو المرحلة النهائية للتاريخ (بحسب فوكوياما)، بكلّ ما لهذا «التاريخ الجديد» من أدوات سيطرة وهيمنة، فكرياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافيّاً، بحيث يصبح فعلياً العالم «قرية كونية» مقابل «مدينة العالم» التي تجسّد جدلية المركز والأطراف.
في هذه الإمبريالية الجديدة، لم تعد وظيفة «القرية الكونية» ممارسة «نمط إنتاج اقتصادي واحد» مفروض عليها، بل أصبح هدف «مدينة العالم» هو فرض «نمط استهلاك ثقافي واحد» على «القرية الكونية» التي تتلقّاها وهي منجذبةً نحوه بشكل لا شعوري، لخدمة «نمط إنتاج اقتصادي قومي» هو الاقتصاد الأميركي. وهذا الاقتصاد، بوسائل تعبيره عن نفسه (كالمال والتكنولوجيا والصناعة والزارعة والتجارة وغيرها)، وبمؤسساته التي تعبّر عنه (كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي)، هو لا شكّ مصلحة قومية أميركية بامتياز.
يجادل بيار بورديو أنّ الإمبريالية التقليدية اعتمدت على سياسة «فرّق تسد»، باعتبار أنّ نمط الإنتاج الاقتصادي الواحد يحتاج للتمايز الثقافي لكي يعيد إنتاج نفسه (الإمبريالية الأوروبية)، بينما العولمة باعتبارها إمبريالية جديدة (أميركية) تحتاج لسياسة «وحّد تسد»، لأنّ تعميم نمط استهلاك ثقافي واحد يحتاج بالضرورة لإلغاء كلّ الخصوصيات الثقافية التي من شأنها أن تحدّ من عملية استهلاك ما ينتجه الاقتصاد القومي «المهيمن».
العولمة وما بعد الحداثة
هي إذاً جدلية الحداثة وما بعد الحداثة، أي جدلية الموت المعنوي والحياة المعنوية. سأشرح: كونها عولمة، أي كونها قادرة على أن تُستوعب من قبل مختلف الاختصاصات، وكونها قابلة لأن تخضع للتحليل بحسب الأدوات التحليلية الخاصة بكل اختصاص، فهي، والحالة هذه، قابلة للمعالجة ضمن إطار «الحداثة وما بعد الحداثة». ففي حين ركّزت الحداثة على ضرورة وجود الحركة داخل التناقضات، والديناميات داخل اللاتجانس، فإنّ فلسفة «ما بعد الحداثة» ركّزت وسعت إلى توحيد التناقضات ببوتقة ثقافية متجانسة واحدة، أي فرض ثقافة استهلاكية واحدة لا تراعي خصوصيات المجتمعات الأخرى ولا تعبيراتهم الثقافية المختلفة. والعولمة بهذا المعنى، أي باعتبارها «تجانساً ثقافياً/ استهلاكياً مُعولماً» بخدمة «نمط إنتاج اقتصادي قومي»، تحاول (هنا أستعير تعبير مهدي عامل في كتابه «هل القلب للشرق والعقل للغرب؟») أن تلغي كلّ ما ليس هي.
إنّ حقيقة أنّ العولمة هي حداثة على صعيد التكنولوجيا والاقتصاد، وما بعد حداثة على صعيد الثقافة، لا يعني أنّ الواقع يعكس أحقّية هذه الحقيقة. ذلك أنّ الحقيقة المضادّة للعولمة، والتي هي «العالمية»، استطاعت أن تستفيد من حداثة العولمة (وسائل التواصل الاجتماعي، التلفزيون،… إلخ) لكي تحمي «التنوع الثقافي العالمي»، أي لتجنّب مخاطر العولمة الما بعد حداثية. بشكل أكثر وضوحاً، رغم محاولات الولايات المتحدة أن تدخل مخيّلة البشرية جمعاء وتحدّد أساليب عيشها بهدف التغلّب على التنوّع الثقافي على الأرض، الذي يشكّل حدّ ممانعة أمام العولمة، شكّلت نوعاً من «الاجتياح الثقافي» بمجنزراتها الإعلامية ودبّابات شركاتها متعدّدة الجنسيات. مقابل هذا الاجتياح الثقافي، يقف مفهوم «العالمية» كمقاومة ثقافية للدفاع عن التنوّع الحضاري في العالم. فالعالمية كما تعرّف نفسها هي «الاعتراف المتبادل والضروري بالأدوار، بحيث تتفاعل الثقافات وتنفتح على بعضها البعض مع الاحتفاظ بخصائص وهوية كلّ ثقافة»، فهي إذاً التنوّع الذي يتفاعل ديالكتيكياً لإنتاج وخلق ديناميكية حضارية على كلّ المستويات. إنّ كلّ التعبيرات الثقافية، من سلوكيات ونمط عيش وعقائد وعادات، تتعامل وتستفيد من بعضها البعض من خلال توفّر «حداثة التكنولوجيا والاقتصاد»، وترفض، بل وتقاوم، عولمة الما بعد حداثة على الصعيد الثقافي باعتبارها أداة لإعادة صياغة شعور البشرية وأساليب تعبيرها عن نفسها. (في سياق مشابه، يصدّع رأسنا «المتأمركون العرب» بأنّنا «كمحور مقاوم» نستخدم التكنولوجيا التي ينتجها الغرب الذي نعاديه ثمّ ندّعي أنّنا نقاومه، ولكنّهم – لو يفقهون – لفهموا أهمية معنى أنّ الذي «يقاتل فينا هي الروح». وأنا على يقينٍ تام أنّ عماد مغنية، ذلك الشهيد ذو العبقرية العسكرية، كان يدرك تماماً أنّ الروح هنا ليست مفهوماً هُلاميّاً وروحانيّاً، بل هو سدٌّ ثقافي عام وشامل يحمل كلّ الدلالات الثقافية الدينية والوطنية والأممية. وهذا ما يفسّر لماذا يقف مع قضايانا مجتمعات وأفراد غير عربية وغير إسلامية في العالم كلّه. وهذا ما يعكس نوعاً من التفاعل الثقافي الذي تنادي به العالمية، والذي نعبّر عنه من خلال استخدامنا لـ«الآيفون» مثلاً، الذي من خلاله ننشر ونتلقّى تضامناً عالميّاً تجاه قضايانا. ومعركة «سيف القدس» خير دليل على كيفية الاستفادة من حداثة العولمة على الصعيد التكنولوجي من دون تبنّي عولمة الما بعد حداثة على الصعيد الثقافي). لا يعني هذا أنّ مقاومتنا هي فقط مقاومة ثقافية، بل المعنى المقصود هو أنّه يجب على البندقية أن تتشرّب قيم صاحبها وتصوّراته تجاه ذاته والآخرين، تجاه عالمه والعوالم الحضاريّة الأخرى، أن تقاوم «أمركة» الآذان والعيون والعقول، وأن تواجه مثلاً: «الاحتلال الديموقراطي»، وأن تكون حذراً تجاه كلّ مفهوم يصدر عن الغرب لأنّ معركتنا كذلك تطاول «المفاهيم» ودلالاتها
يجادل بيار بورديو أنّ الإمبريالية التقليدية اعتمدت على سياسة «فرّق تسد»، بينما العولمة باعتبارها إمبريالية جديدة (أميركية) تحتاج لسياسة «وحّد تسد»!
العالمية مقابل العولمة
يعرّف الإمام محمد مهدي شمس الدين، في «العولمة وأنسنة العولمة»، مفهوم العولمة بأنّه لغة للتعبير عن طموح نحو إيجاد نظام سياسي دولي تهيمن فيه قوّة وحيدة أو تحالف قوى، هيمنةً سياسية انطلاقاً من مصالحها المادّية ونظرتها الفلسفية، على أكبر قدر ممكن من الدول والشعوب». ينطبق هذا التعريف بشكل مطلق على النظام السياسي الدولي بعد الحرب الباردة، بالتالي يصبح من المنطقي مقاربة العولمة باعتبارها هيمنة القطبية الواحدة على العالم. لذلك، فإنّ أهمّية ما يجري الآن في العالم تعكس حجم انحسار النظام العولمي الواحد لصالح نظام عالمي متعدّد، لأنّ عملية التحوّل الحاصلة على الساحة الدولية اليوم هي بشكل أو بآخر محاولة جادّة ومعقولة لكسر العولمة لصالح «العالمية»، بمعنى أنّ إعادة تشكيل النظام الدولي على قاعدة التعدّدية القطبية هي إعادة إنتاج للعلاقات الدولية بشكل أكثر احتراماً للخصوصيات الثقافية، من جهة، وأقلّ امتثالاً للنمط الذي تحاول فرضه الولايات المتحدة على العالم. لذا يبدو ضرورياً أن نفهم كيف يمكن لنظام متعدد الأقطاب أن يحترم الخصوصيات الثقافية ويقلّل من اعتماد الدول على الأنماط «المعلّبة» التي ينتجها القطب الواحد.
إنّ التأويل الحضاري لسور الصين العظيم هو عزل الصين عن الخارج وحمايتها منه بآنٍ واحد، وبنفس الوقت فإنّ طريق الحرير القديم هو انفتاح على الخارج بالاعتماد على إنتاج الداخل. وقد وصل الأمر عند البعض لاعتباره «عولمة سابقة لأوانها» (القصد من العولمة هنا هو التبادل التجاري خارج الحدود القومية)، فكيف استطاعت الصين أن توازن بين النقيضين؟
العودة للجذور التاريخية دائماً ما يشكّل أساس الفهم للسلوكيات الحالية للدول، وفي حالة الصين فإنّ هذه العودة أكثر من ضرورة ذلك لأنّ التاريخ الصيني لا ينفصل عن حاضرها فكريّاً وسلوكيّاً. وانطلاقاً من هذا الافتراض، يجادل عماد منصور في دراسته عن الثقافة الاستراتيجية الصينية بأنّ الصين رأت نفسها تاريخيّاً بأنّها (تيان خا Tianxia) أي حضارة كلّ ما تحت السماء، وأنّها تمثّل العظمة، والخارج هو من يتشرّف بالدخول إليها. فهي على هذا المستوى، لم تسعَ لأن تنشر رسالتها الحضارية في الخارج، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنّ التهديدات الإمبراطورية، في فترة الدول المتحاربة (475-211 قبل الميلاد) ثمّ «قرن الإذلال» (1839-1949)، عكسا الغاية الكامنة وراء سور الصين العظيم (عزل وحماية).
ومن السمات الأساسية في الثقافة الصينية هي ضرورة توحيد الداخل منعاً من فتح الباب للتدخلات الخارجية، لذلك دائماً ما كانت الصين تتجنّب الانقسامات الداخلية خوفاً من تدخّل خارجي محتمل، وهي لم تشقّ طريق الحرير القديم ولم تنفتح تجاريّاً على الخارج إلا بعد أن وحّدت الداخل وتحكّمت في أقاليمها عبر الإدارة المركزية. فهي على هذا المستوى حاولت التوفيق بين الانفتاح والعزل، لم تنفتح حضاريّاً على الآخر ولم تنغلق كذلك اقتصاديّاً، وهي تعلّمت من استعمار أراضيها كيف تحمي ذاتها من دون أن تستعمر دولاً أخرى أو ترسل مبشّرين لحضارتها. وفي هذا السياق، من المفيد جدّاً أن نورد ما يقوله المفكّرون الكونفوشيون بأنّ النقد الذاتي والأخلاق والأفكار الكونفوشيوسية يجب أن تنير السياسة أكثر من التحضير لاستراتيجية حربية، ولم يبدأ التغيير في مقاربات الصين للعالم إلا من أجل التأقلم مع العالم الجديد، لذلك من الطبيعي أن يقول ماو تسي تونغ بأنّ «الصين لا ترغب بأيّ إنشٍ أجنبي». ولذلك طريق الحرير الجديد قائم على غاية «الفوز المشترك»، وليس على الهيمنة والفرض لصالح اقتصاد الصين حصراً. فليس غريباً إذاً أن تمثّل الصين «فن تغيير الواقع للأفضل» (التعبير لهادي العلوي)، هذا التغيير لا يقوم في الصين على أنماط جاهزة وثابتة في كل مكان وزمان، بل يقوم على منهجية جدلية في التفكير السياسي، أي رؤية التاريخ بشكل ديناميكي.
وبدورها، تطل موسكو برأسها في سياق التنوع الثقافي الذي ينبغي أن يتجلّى في نظام التعددية القطبية، يتحدّث المفكر الروسي ألكسندر دوغين في «مشروعه حول النظرية الرابعة»، عن مفهوم «النوماخيا»، وهو مصطلح روسي يستخدمه دوغين للدلالة على ما للثقافات والأفكار من دور أساسي في التكوّن الحضاري. يعتبر دوغين أنّه لا توجد حقيقة ثقافية وحضارية مطلقة، فكلّ حضارة لها تناقضاتها وتعقيداتها وفهمها للعالم، ووحده الحوار بين الحضارات المختلفة يعطي بُعداً سلميّاً لهذا الثراء الحضاري «العالمي». فالنوماخيا إذاً هي، بحسب دوغين، كسر لأي قاعدة عالمية وكسر الرؤية الأحادية؛ فلا يجوز تقييم وتصنيف الحضارات وفقاً لمعايير الحضارة الفاحصة، ولذلك شدّد دوغين كثيراً على ضرورة مواجهة الغرب الذي يفرض ماهيّته على الآخر. هذا باختصار شديد مشروع «النوماخيا»، وتكمن أهمّيته هنا هو أنّ ما يجري الآن في روسيا لا ينفصل على هذا المشروع «الدوغيني»، ذلك أنّ الحديث عن القومية الروسية مقابل «التمدّد الغربي» لا يعكس فقط المعنى السياسي، بل كذلك المعنى الهوياتي (وكلّ ما يمكن للهوية أن تتضمّنه) لضرورة مواجهة ذلك «الاجتياح الثقافي الغربي» الذي كان في أوجّه بُعيد سقوط الاتحاد السوفياتي.
خاتمة
لطالما كان ماركس محقّاً، فبحسبه إنّ «أدوات الإنتاج تتطوّر بسرعة أكبر من علاقات الإنتاج»، أي أنّ الاقتصاد يتطورّ أكثر من الثقافة. ولذلك لم يدم مشروع «العولمة كفرض نمط ثقافي استهلاكي واحد» طويلاً، بل سرعان ما بدأ التحوّل في طبيعة النظام الدولي (الأميركي) يتسارع. فصحيح أنّ العولمة شكّلت مرحلة انتقالية «كونية»، «شاملة»، لصالح الولايات المتحدة، ولكن العالم اليوم بات على باب الخروج من هذه المرحلة الانتقالية، لصالح مرحلة انتقالية «عالمية» تتشكّل، ببطء، ولكن بعمق جدّي. في مثل هذه الفترات، يعتبر غرامشي أنّ التصادم يزداد «وحشيّةً»، وهذا بديهي طالما أنّ المهيمن يصارع لأن يحافظ على هيمنته.
سيرياهوم نيوز3 – الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن