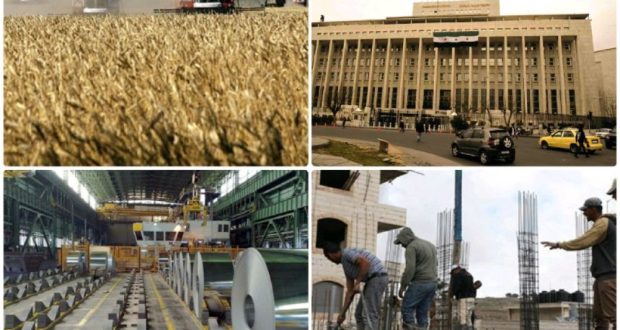من أين نبدأ..؟
سؤال مفتاحي على أفق يخال كل من يسأل أنه لا ينتهي، لشدّة ازدحام أولويات الإصلاح وإعادة إعمار كل شيء في هذه البلاد، ذات البنى المنهكة.
ولعل ترتيب الأولويات اليوم، مهمة من أصعب المهام التي نستعد -نحن السوريين جميعاً- لتلبيتها كاستحقاق سيستغرق وقتاً مديداً من الزمن وهذه من طبيعة الأشياء في بلد كبلدنا سوريا بوضعها الراهن.
” الحرية” أطلقت مثل هذا التساؤل المفتوح.. وبدأت بتلقي الإجابات على لسان خبراء وطنيين ومهتمين، يعيشون هذا الهاجس.
• د. فاخر قربي: تصور لمستقبل سوريا الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية وترجمة هذا التصور في خطة شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة ممنهجة
لم يتردد الخبير الاقتصادي والتنموي الدكتور فاخر قربي، بتسجيل وجهة نظره التي تذهب باتجاه بلورة منهاج وخطة واضحة المعالم، بجملة بدأ بها حديثه لصحيفتنا الحريّة، مفادها “تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى خريطة طريق واضحة تحدد أولويات التنفيذ”.
فالتنمية برأيه ليست مجرد عملية مالية بل تتطلب تبني سياسات إدارية وهيكلية فعالة، بل يبدأ الإصلاح الاقتصادي من رؤية مستقبلية واضحة لتصورين أساسيين:
أولهما: تصور لمستقبل سوريا الاقتصادي في ظل التحديات الداخلية والخارجية وترجمة هذا التصور في خطة شاملة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثانيهما: تصور للنظام الاقتصادي السوري المستقبلي.. أي وضع تصور لمستقبل سوريا الاقتصادي وخطة التنمية الشاملة..
• لا بد من أن تقوم سوريا بتحديد الإطار النظري للاقتصاد الذي تريده لنفسها في المستقبل وتحديد دور كل من القطاع الخاص والعام ودور التخطيط ونظام السوق في توزيع الموارد فيه
وما سبق يستوجب وضع تصور لمستقبل سوريا اقتصادي في ضوء كل من:
موارد سوريا الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية وموقعها الجغرافي.. ثم متطلبات العولمة الاقتصادية وواقع انضمام سوريا إلى الشراكة الاقتصادية العربية-العربية في ظل مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتوقع انضمامها للشراكة الأوروبية المتوسطية.
تصور بانورامي
قبل أن يمضي في سرد تفاصيل ما سبق، يتوقف د. قربي ليشير إلى أنه يقع على سوريا، في ظل هذه المعطيات واجب وضع تصور لأولوياتها الاقتصادية ولعلاقاتها التجارية والاستثمارية المستقبلية ودورها الاقتصادي والسياسي في المنطقة، وترجمة هذا التصور إلى خطة تنمية شاملة تضم مفهوماً جديداً للتنمية يركز على كل من النمو ونوعية النمو وعلى العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر، وعلى تطوير التعليم وتنمية القدرات البشرية والتكنولوجية المحلية، بنفس الوقت الذي يؤكد تنمية كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد الوطني ضمن استراتيجيات تضع تعظيم التصدير وزيادة فرص العمالة في أولى أولوياتها.
• يتطلب برنامج الإصلاح برنامجاً زمنياً، ويتوجب أن يكون شاملاً عريض القاعدة وذلك بسبب ترابط إجراءات وخطوات الإصلاح نفسها وتأثيرها وتأثرها ببعضها البعض.
ولا بد من تأكيد أن رفع القدرات البشرية والعلمية والتكنولوجية لزيادة معدلات الإنتاجية، ولكي نستطيع المنافسة في زمن العولمة، عملية مجتمعية شاملة تتطلب ثقافة جديدة تشمل تطوير المجتمع القائم على العملية الإنتاجية مباشرة والمجتمع القائم وراء هذه العملية، فهي عملية تحتاج لنمط جديد في العمل والتفكير لدى كل من صاحب القرار وموظف الدولة ومدير المنشأة والعامل وكل فرد يقدم خدمة أو سلعة، نمط يعتمد على التحليل والتفكير والتخطيط والإبداع والابتكار، وقادر بنفس الوقت على استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة في كل مجال، وملتزم التزاماً دقيقاً بمبدأي التخطيط والإتقان في العمل. وهذا ما يتطلب وضع التطوير التربوي في البيت كما في المدرسة، ضمن أولويات الإصلاح والتنمية حتى نستطيع تحرير العقل وتخليصه من موروثات فكرية وأسطورية قديمة ومن أساليب اتكالية في التفكير في العمل وفي أداء الواجب، ومن جهة ثانية يتطلب هذا التطوير الشامل تطوير وتوسيع وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تشارك هذه المؤسسات في صنع القرار وفي اقتراح الخطط وفي المتابعة والمحاسبة والمساءلة لضبط الأخطاء.
رؤية للأفق المقبل
يجزم الخبير قربي بأنه لا بد من أن تقوم سوريا بتحديد الإطار النظري للاقتصاد الذي تريده لنفسها في المستقبل، وتحديد دور كل من القطاع الخاص والعام ودور التخطيط ونظام السوق في توزيع الموارد فيه، وخاصة بعد التحولات الهيكلية الجذرية التي تمت في الاقتصاد السوري في السنوات الأخيرة، والتي رفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص فيه إلى حوالي 60% من الدخل القومي ورفعت حصة القطاع الخاص في التجارة الخارجية خارج النفط إلى حوالي 70%، وحصته في الاستثمار إلى التساوي مع حصة القطاع العام. ومن دون هذا التحديد سيستمر التخبط النظري وستأتي خطوات الإصلاح ناقصة أو متناقضة.
• إما قطاع عام اقتصادي بوظيفة اجتماعية توفر العمالة وسبل العيش للعديد من الفئات الاجتماعية أو قطاع عام كفوء بوظيفة اقتصادية قادر على لعب دور قيادي فعال في العملية الإنتاجية
ويتوجب أن يسعى الإطار النظري الجديد إلى التوفيق بين مفاهيم النظام الاقتصادي العالمي الجديد والثوابت الاقتصادية التي تريد سوريا الحفاظ عليها، وكذلك تحديد دور جديد للدولة، هذا الدور الذي لابد وأن يكون مختلفاً في نوعيته عن الدور السابق لها، وقد يكون دوراً أكبر منه، يركز على التخطيط التأشيري وعلى القضايا الاجتماعية والتنمية البشرية والتكنولوجية وعلى تعزيز المنافسة في السوق وعلى الحماية من مخاطر الاحتكار ومن تهديدات العولمة.
وفي اعتقادي أن الفكر الاقتصادي الجديد يجب أن يعتبر السوق والدولة مكملين لبعضهما البعض وليس بديلين، وأن يعتبر الملكية الخاصة حق وليس منحة، والخاص والعام شريكين في عملية التنمية.
ويضيف: أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على مفهوم “الوطنية الاقتصادية” في ظل نظام السوق والعولمة، وذلك من خلال التركيز على التنمية البشرية والتقدم العلمي والتكنولوجية ومن خلال التشجيع على الاستثمار وعلى التصدير (الذي يخفف من الاعتماد على المساعدات الخارجية) ولكن من خلال الحماية الجمركية.
أهداف
ينصح محدّثنا بأنه يجب أن يوضع الإصلاح الاقتصادي في مكانه الصحيح استناداً إلى التجارب التي مرت بها الدولة التي اعتمدت في السابق منهج الإصلاح الاقتصادي المعتمد على وصفة البنك والصندوق.
الدوليين.
• لا يمكن أن يتم الإصلاح الاقتصادي بنجاح ما لم يتم لجم الفساد والعمل على تكافؤ الفرص وتوفير الشفافية
وقد جاء وقت أصبح فيه الإصلاح وكأنه هدف بحد ذاته، واكتسب التثبيت الاقتصادي وتحرير التجارة والخصخصة والدعوة إلى تحجيم دور الدولة أولوية في برامج الإصلاح. لكن التجارب بينت خطأ هذا التوجه. وفي اعتقادي أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون وسيلة لإدارة الطلب من جهة وتحفيز الإنتاج من جهة ثانية، ولكن يجب أن يكون كذلك مرتبطاً بخطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل وخطة التنمية الاجتماعية. فالتحرير الاقتصادي غير المرتبط بخطة لتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الإنتاجية يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني والإصلاح غير المرتبط ببرنامج لمعالجة الفقرة والبطالة بشكل مباشر يشكل خطراً على السلم الاجتماعي.
ويكون برنامج الإصلاح في سياق حزمة أهداف استراتيجية حقيقية، تبدأ بإدارة الطلب الكلي وتحقيق التوازنات في الاقتصاد الكلي وأهمها احتواء التضخم.. ثم تعبئة كافة الطاقات المادية والبشرية في الوطن لخدمة عملية التنمية.. وزيادة الكفاءة في الأداء الاقتصادي وفي توزيع الموارد.. إضافة إلى خلق المناخ المحفز للاستثمار طويل الأجل وتوفير الفرص المتكافئة للجميع…ورفع عائدية الاستثمار من خلال إزالة العقبات والجمودات في البيئة الإنتاجية، ومن خلال إقامة البيئة التنظيمية والتشريعية السليمة لعمل كل من القطاعين العام والخاص وزيادة قدرة كل منهما على التحرك السريع لمواجهة متطلبات السوق المتغيرة باستمرار.. إلى جانب تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر (وليس المحفظي) مع توجيه هذا الاستثمار نحو أولويات التنمية المحلية من خلال الحوافز… ولا ننسى منع الاحتكار وتعميق المنافسة في السوق.
والنقطة المحورية هي الحفاظ على شبابنا ومتعلمينا داخل الوطن من خلال توفير المناخ اللازم لهم للاستثمار والعلم والإبداع والابتكار والحفاظ على الكرامة.
منطلقات
في سياق ما يخصّ منطلقات الإصلاح.. يرى قربي أنه ينبغي أن يبدأ إعداد برنامج الإصلاح من جملة منطلقات تؤخذ بعين الاعتبار.. أولها: البرنامج الزمني والشمولية.
فبرأيه يتطلب برنامج الإصلاح برنامجاً زمنياً، ويتوجب أن يكون شاملاً عريض القاعدة وذلك بسبب ترابط إجراءات وخطوات الإصلاح نفسها وتأثيرها وتأثرها ببعضها البعض.
فإصلاح القطاع المصرفي لا يكون مجدياً من دون إصلاح القطاع العام، كما وإن إصلاح القطاع العام أو الإصلاح المالي لن يكون فعالاً من دون إصلاح القطاع المصرفي. كذلك فإن خطوات تحرير التجارة من دون خطوات متلازمة لتحفيز الإنتاج والإنتاجية تعرض السوق الداخلي لمزاحمة شديدة وتعرض الميزان التجاري لانكشاف خطر. كما وأن إعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية أو تعديل قانون الاستثمار من دون إصلاح البيئة التشريعية والتنظيمية للعمل الإنتاجي يصبح من باب العبثية.
النقطة الثانية: تتابع الإصلاحات وتقرير السرعة في الإصلاح.. فمن وجهة نظر الباحث قربي الإصلاح المتدرج هو الأفضل، ولكن يبقى السؤال، أي تدرج وأي سرعة، وعلينا إيجاد التوازن السليم بحيث نصل إلى عملية إصلاحية ديناميكية نشطة وفعالة، ولكن نحافظ بنفس الوقت على الاستقرار الاجتماعي. ولا بأس أن يكون الإصلاح الاقتصادي تحت عنوان “الإصلاح المتدرج المكثف”.
أما النقطة الثالثة فهي: القرار الاقتصادي المستقل.. وهنا يشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يعني التنازل عن القرار الاقتصادي السوري المستقل بل يجب أن يكون من صنع سوري، وأن يكون دور مؤسسات التنمية الدولية والعربية فيه دور المقدم للدعم والتموين وليس إعداد البرنامج، فالإصلاح نريده لحاجة لنا، استجابة لمتطلبات تنميتنا، ولنصبح أقوياء في عصر العولمة، لا لتلبية رغبات ووجهات نظر خارجية.
معوقات
لم يغفل د. قربي عن أن برنامج الإصلاح سيتعرّض لصعوبات في إعداده كما في تنفيذه لاعتبارات فكرية واعتبارات سياسية واعتبارات اجتماعية، وفوق ذلك وذاك سيعارضه المنتفعون من الأمر الواقع سواء كانوا في السلطة، أو في الخدمة المدنية أو في القطاع الخاص.
لذلك يتطلب برنامج الإصلاح لنجاحه وحتى نضمن الوضوح فيه والتأييد السياسي والشعبي له..وضوح الخلفية الفكرية وراء برنامج الإصلاح.. والتأييد السياسي له على أعلى المستويات.. ثم مشاركة المجتمع المدني في إعداده بما فيه رجال الأعمال والمنظمات النقابية.. وتوفر الفريق المتجانس في إعداده وتطبيقه… إلى جانب تعميق ثقافة نظام السوق والمعرفة بأدواته في النظام الإداري في الدولة.
أما بالنسبة للمعالم الرئيسية لبرنامج الإصلاح فيرى الخبير قربي أنه أن برنامج الإصلاح يجب أن يتضمّن شقين:
شق يعنى بإدارة الطلب الكلي..وشق يعنى بزيادة العرض الكلي السلعي والخدمي.
ويتضمن الشق المتعلق بإدارة الطلب الكلي السياسات النقدية والمالية والسعرية بينما يتضمن الشق المتعلق بزيادة العرض الكلي إقامة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والعمل على إعادة هيكلة البنية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص.
في إدارة الطلب الكلي والسياسات المالية والنقدية يرى د. قربي أن الانضباط المالي أساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي وذلك لاحتواء التضخم وتمكين الحكومة من توفير التمويل للقيام بمهماتها الاجتماعية والاقتصادية.. ولكن لا بد من وضع السياسة المالية في خدمة نمو الاقتصادي أو لا تستخدمها حسب متطلبات الحركة الاقتصادية ومعدلات التضخم. ففي السياسة المالية يقترح القيام بمراجعة عميقة وشاملة للإنفاق الاستثماري والإداري في الموازنة العامة للدولة يتبعه القيام بترشيد لهذا الإنفاق، لإضافة إلى جهود التحصيل وإصلاح التشريع الضريبي.
والحد من الإعفاءات الضريبية المطلقة، لا بل والعمل على ترشيقها وتخفيضها تدريجياً واستبدالها بحوافز ضريبية تشجع مباشرة على التأهيل المهني والتدريب وعلى خلق فرص العمل وتدعيم القدرات التكنولوجية المحلية بما فيها قيام الوحدات الإنتاجية بجهود البحث والتطوير.
والخروج من مشكلة التشابكات المالية والمتزايدة بين مؤسسات وشركات الدولة.. ثم إدخال الشفافية للمالية العامة من خلال دمج الموازنات في موازنة واحدة وإظهار الدعم الاستهلاكي داخل الموازنة.
وفي السياسة النقدية يلفت إلى أنه من الضروري تفعيل هذه السياسة، من خلال تحريك أسعار الفائدة للتأثير على كل من العرض والطلب، وإعادة هيكلة سلم الفوائد الدائنة والمدينة والتنسيق بينهما.
فعلى مستوى تحفيز العرض السلعي، يبيّن أنه من ناحية العرض، هناك جانب البيئة التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل الاقتصادي وهناك جانب إعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية والخدمية.
تشريع
نصل الآن التشريع.. فهو حيثية بالغة الأهمية، إذ يرى الباحث الاقتصادي ضرورة إقامة بيئة تشريعية وتنظيمية سليمة كشرط لازم يفرض نفسه في رؤية الإصلاح وفقاً للدكتور قربي، فهو يرى ضرورة إجراء معالجة شاملة للقوانين والتشريعات القائمة ومنها قانون التجارة، وقوانين كل من الاستثمار والضرائب والعمل والإيجار وقانون العلاقات الزراعية وتطوير أنظمة الإفلاس وحل المنازعات والتحكيم.
وإضافة تشريعات جديدة تمنع الاحتكار وتعزز المنافسة في السوق.. وتعزيز سلطة القانون..ثم مراجعة أنظمة الاستيراد والتصدير وأساليب الحماية وهيكل الرسوم الجمركية…والتسريع في سياسة الانتقال من المنع الكلي للاستيراد واستبداله بالحماية عن طريق الرسوم الجمركية.
إلى جانب الإسراع لتوحيد أسعار القطع، بالتلازم مع ترشيد وتخفيض الرسوم الجمركية وإلغائها بالنسبة لمستلزمات الإنتاج. وأعتقد أن الحكومة السابقة سارت بخطوات كبيرة في الإعداد لهذه الخطوة المهمة.
وإعادة هيكلة البيئة الإنتاجية في القطاعين العام والخاص إذ يجب أن يشمل تحفيز زيادة العرض السلعي القيام بإعادة هيكلة البنية المالية والإدارية والنقدية للمؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص للارتقاء بقدراتها الإنتاجية ولإعدادهما للدخول إلى النظام الاقتصادي العالمي. كما يتضمن إقامة وتسهيل إقامة المؤسسات المساندة لعملها كالمؤسسات المصرفية المتطورة والمدن الصناعية المخدمة ومؤسسات الاستشارات المالية والفنية والنقدية.
ولا بد من الإشارة هنا بأن أياً من القطاعين العام أو الخاص غير قادر على دخول النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحاضر، فالقطاع العام ضعيف القدرة الإنتاجية والنقدية ومثقل الحركة، والقطاع الخاص لا زال قطاعاً عائلياً ضعيفاً، ومفتتاً، يعتمد التكنولوجيا القديمة والإدارة التقليدية، وذلك نتيجة السياسات التي اعتمدتها الدولة في السابق بغرض تحجيمه، والسياسات التي سمحت له طول البقاء ضمن الحماية الجمركية الدائمة، وأخيراً السياسات التي لم تعطه بعد الأمان الكافي بسبب ضبابية التوجيهات والبيئة التشريعية والتنظيمية المعيقة لعمله ولتعامله مع الدولة.
القطاع العام
يرى الدكتور قربي أن القطاع العام تعرّض في السنوات الأخيرة لمنافسة شديدة من القطاع الخاص.
إلى جانب احتواء القطاع العام لفائض عمالي كبير يحقق وظيفة اجتماعية لكنه يرفع من كلفته ويقلص من إنتاجيته.
وتبعاً لمشاكل القطاع العام المتراكمة والحادة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، فقد أصبح من الضروري القيام بدراسة متعمقة وموضوعية للقطاع العام الاقتصادي من أجل إعادة هيكلة بنيته المالية والإدارية والتقنية.. وإيجاد آلية جديدة لعمله لإعطائه المزيد من الاستقلالية والمرونة في الحركة… ورفع أجور عماله بحيث تتقارب أو تتساوى مع أجور القطاع الخاص.
كما يتوجب أن تكون هذه الدراسة دراسة موضوعية تحدد الوضع الحقيقي والموضوعي للقطاع العام الاقتصادي وتقترح الحلول والخطط اللازمة لمعالجة مشاكله. ولكي تكون الدراسة مفيدة وموضوعية وبناءة، يجب أن تبدأ من السؤال الجوهري: لماذا نريد القطاع العام الاقتصادي، وما هو دوره في العملية الإنتاجية وأين حدود هذا الدور، وهل للقطاع العام وظيفة اقتصادية فقط أم وظيفة اجتماعية كذلك.
ويضيف: إذا كنا بحاجة إلى القطاع العام لإقامة التوازنات في الاقتصاد أو للقيام بوظيفة اجتماعية إضافة إلى وظيفته الاقتصادية، فأين مجالات هذا الدور وأين حدوده، وإذا كنا نريده كذلك لمواجهة الشركات العالمية العملاقة لمنع فرض سيطرتها على الدول، كما يقول البعض، فكيف يكون ذلك.
الرواتب
في مضمار البحث عن الحلول أعلاه يُفضّل الباحث الاقتصادي أن نكون واقعيين وصريحين، وخاصة فيما يتعلق برفع الأجور وموضوع الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية، ويرى أننا قد نستطيع إعادة الهيكلة لمؤسسات القطاع العام وقد نستطيع وضع آلية جديدة لعمله، ولكن هل يمكن جعل القطاع العام ديناميكياً فاعلاً يستطيع الحفاظ على خبراته البشرية الحالية واستقدام خبرات جديدة، من دون أن يرفع مستوى أجوره لتتقارب أو لتتساوى مع أجور القطاع الخاص؟.
وهل ممكن رفع الأجور إلى المستويات المطلوبة من دون التخلي عن العمالة الفائضة فيه؟
هذه هي الحقيقة المرة التي إذا لم ندركها سنصل إلى طريق مسدود، إذ يعني التخلي عن العمالة الفائضة فصل الوظيفة الاجتماعية عن الوظيفة الاقتصادية للقطاع العام، ويصبح هذا قراراً سياسياً واجتماعياً وليس فقط قراراً اقتصادياً.
والخيار هنا واضح وصريح.. إما قطاع عام اقتصادي بوظيفة اجتماعية توفر العمالة وسبل العيش للعديد من الفئات الاجتماعية، أو قطاع عام كفوء بوظيفة اقتصادية قادر على لعب دور قيادي فعال في العملية الإنتاجية، وقادر على المنافسة والتوسع وخلق فرص عمل للمجموعات الجديدة الوافدة إلى سوق العمل وقادر كذلك على اختراق الأسواق العالمية.
وقد نجد الحل بالنهاية في إقامة نوعين من القطاع العام الاقتصادي يقوم كل منهما بوظيفة مختلفة، يخضع أحدهما لنفس البيئة التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها القطاع الخاص، بينما يخضع الآخر للبيئة التشريعية القائمة لعمل القطاع العام في الوقت الحاضر مع بعض التطوير.
وإذا قررنا خيار القطاع العام الاقتصادي الديناميكي الفعال فلا بد من إعداد البرامج اللازمة لمساعدة العمالة الفائضة على التحول نحو مجالات إنتاجية أخرى. وبحيث يتضمن مثل هذا البرنامج، فيما يتضمن: برامج التأهيل والتدريب (لمساعدة العمالة الفائضة على الانتقال إلى وظائف أخرى).. وبرامج التعويض المالي للفئات المتضررة.. وبرامج لمنح معونات فنية ومالية للعمال الراغبين في دخول الأعمال الحرة بدلاً من التوظيف.. إضافة إلى الاستمرار بتقوية القطاع الخاص حتى يستطيع المساهمة في استيعاب العمالة الفائضة.
معايير
أيضاً في مجال الحلول ينبغي النظر يجزم د. قربي بأنه لابد من تعديل مقاييس النجاح في القطاع العام الاقتصادي بحيث يصبح الربح هو المعيار الرئيسي للنجاح وليس تحقيق الخطة الإنتاجية.
ودمج بعض الشركات ذات النشاط الواحد والتخلص من تلك المستعصية على الحل أو المنتجة لسلع استهلاكية بسيطة لا تستحق أن تبقى في القطاع العام.. ثم النظر في تجميع الشركات ضمن شركات قابضة على غرار التجربتين المصرية والجزائرية استعداداً لإعادة هيكلتها.
ويعتقد أنه من الحكمة بمكان، اتخاذ قرار ضمني بتجميد القطاع العام الاقتصادي ضمن حدوده الحالية إلى أن تتم الدراسة الموضوعية المقترحة أعلاه ووضع الخطة لإعادة هيكلته والخطة الأخرى للآلية الجديدة لعملها، حتى يصبح قطاعاً عاماً رائداً في العملية الإنتاجية. إما أن نضيف استثمارات جديدة لتعمل ضمن نفس آلية العمل الحالية التي أثبتت عدم فعاليتها لا بل مخاطرها، فهو يشكل في رأيي استمراراً للهدر في المال العام وسيزيد من كلفة إصلاح القطاع العام الاقتصادي حين نبدأ بإصلاحه.
القطاع الخاص
من وجهة نظر الأكاديمي الدكتور فاخر قربي: لكي نجعل القطاع الخاص قطاعاً ديناميكياً أكثر إنتاجية وأكثر التزاماً بالتنمية وبالاستثمار طويل الأجل، وأقل اعتماداً على نشاط الوساطة والربح السريع، ينبغي العمل على أربعة أصعدة.
تبدأ بمنحه الأمان الحقيقي من خلال تأكيد حق الملكية الفردية الخاصة قولاً وعملاً.
وإجراء التعديلات اللازمة في البيئة التشريعية والتنظيمية القائمة المتعلقة بالعمل التجاري والاستيراد والتصدير وقوانين وأنظمة القطع وكذلك التشريعات اللازمة لمنع الاحتكار ولتشجيع المنافسة في السوق.
ثم إقامة وإتاحة الفرصة له لإقامة المؤسسات المصرفية المتطورة والمدن الصناعية المخدمة وإقامة الخدمات الاستثمارية المالية والمحاسبية والتقنية اللازمة لعمله.
وتوفير الفرص المتكافئة للجميع وبكامل الشفافية قولاً وعملاً.
وإقامة أو تشجيع إقامة صناديق استثمارية لمساعدته في عمليات إعادة الهيكلة ودخوله مجالات استثمارية جديدة متطورة.
وحين يوجد هذا الإطار وتوجد البيئة التشريعية والتنظيمية السليمة نستطيع أن نتوقع من القطاع الخاص أن يطور نفسه وأن يعيد هيكلة مؤسساته ويدرب موظفيه ويسدد ضرائبه ويبحث عن أسواق التصدير، ويستثمر في هذا الوطن بدلاً من أن يبحث عن الربح السريع.
المصارف
الإصلاح المصرفي بالعموم ضرورة لتأمين “محركات” الدفع القوية للاقتصاد.. وهنا يفرد د. قربي جزءاً من إجابته لهذا القطاع، ويرى أنه أصبح من الواضح أن النظام المصرفي القائم في سوريا يفتقد إلى القدرة على تعبئة المدخرات المحلية وتحويلها إلى استثمارات وطنية فاعلة، ويفتقد إلى القدرة على نقل الاقتصاد السوري إلى اقتصاد العولمة، كما يفتقد إلى القدرة على الإسهام في عملية الإصلاح الاقتصادي، من خلال مساهمته في إعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم والمشورة اللازمة لهما لدعم انطلاقتهما. لا بل إن القطاع المصرفي في وضعه الحالي يساهم في تكريس استمرارية المنشآت الخاسرة في القطاع العام التي يمنحها التسليف وهو يعرف سلفاً عدم قدرتها على التسديد.
ولا شك أن إصلاح النظام المصرفي ينبغي أن يكون عنصراً أساسياً في عملية التصحيح الاقتصادي.. ويجب أن يكون الإصلاح المصرفي شاملاً فلا يركز على إعادة هيكلة المؤسسات المصرفية فقط، بل يجب أن يشمل السياسة النقدية ومؤسساتها والرقابة على المصارف من قبل هذه المؤسسات وإصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات المصرفية ذاتها وهذا يدفعنا للعمل أكثر، لتقوية مؤسسة المصرف المركزي وإعادة إحياء مجلس النقد والتسليف بهيكلية جديدة… ثم تفعيل السياسة النقدية واستخدام سعر الفائدة كواحد من أدوات هذه السياسة.
وإقامة نظام متطور للرقابة على نشاط المصارف يشمل الرقابة على إدارتها وأموالها ومحافظها الاستثمارية وسيولتها وملاءمتها (وهذا يتم الآن حسبما أدري بمساعدة أوروبية). وقد أكدت الأزمة الآسيوية الأخيرة مدى أهمية الرقابة على المصارف لتفادي الأزمات.
إلى جانب إلغاء مبدأ الحصر والتخصص المصرفي الإلزامي القائم حالياً على الأمر الإداري، والاستعاضة عنه بالتخصص المبني على الخبرة.
وإدخال عنصر المنافسة إلى العمل المصرفي والتأكيد على استقلالية المصارف في قرارات التسليف سواء في القطاع الخاص أو العام إلى القدرة على التسديد.
وإعادة هيكلة البنية المالية والإدارية للمصارف القائمة، وإقامة برامج تدريبية مكثفة للكوادر العاملة فيها.
ومن المهم التوجه نحو إقامة صيغة للقطاع المشترك في العمل المصرفي، بمشاركة رؤوس أموال مصرفية عربية وأجنبية، تنقل إليها المصارف القائمة حالياً بعد إعادة هيكلتها ومعالجة مشكلة ديونها المتعثرة، كما يمكن من خلال هذه الصيغة السماح لإقامة مصارف جديدة مشتركة. وأعتقد بكامل القناعة بأن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام المصرفي، هو الحل الأمثل والأقصر والأكثر فاعلية لتطوير المؤسسات المصرفية القائمة، فهو ينقل التقنيات المصرفية الحديثة إلى هذه المصارف بشكل مباشر وعن طريق الممارسة. ولا أعتقد أنه يجب إقامة أي مؤسسات مصرفية جديدة قبل حسم موضوع إصلاح النظام المصرفي بالكامل.
ولا ننسى العمل على تطوير البنية المالية التحتية وتطوير أسواق المال، مع وضع قواعد للإفصاح المالي من الشركات، وإقامة جهات رقابية كفوءة للإشراف على تطبيق هذه القواعد. ويجدر التأكيد هنا أن تطوير أسواق رأس المال لا يعني بالضرورة الانفتاح على الأسواق المالية العالمية، لا بل من الضروري الحفاظ على “محلية” أسواق المال طويلة تجنبنا لتعرضنا التأثيرات مالية خارجية.
العدالة الاجتماعية
هنا ثمة علاقة جدلية لا يغفل عنها الخبير الاقتصادي والتنموي، وهي الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
فكما دلت التجارب في دول أخرى، ثمة احتمال تزايد فروقات الدخول بين الطبقات في مراحلها الأولى: مزيد من الأغنياء ومزيد من الفقراء بسبب سياسات تحرير لأسعار وترشيد الدعم الاستهلاكي ووقف التوظيف الاجتماعي من الدولة، ثم احتمال ظهور طبقات طفيلية تستفيد من الثغرات خلال مرحلة الانتقال إلى نظام السوق.
ومن جهة ثانية تزداد قناعة المفكرين بين الاقتصاديين في الغرب وقناعة المؤسسات المالية العالمية لتلتقي مع قناعة المفكرين وأصحاب القرار في الدول النامية من أن العولمة الاقتصادية ستساهم في زيادة الفقر وانتشار البطالة في الدول النامية وخاصة الدول ضعيفة الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.
إذا أضفنا إلى ذلك معدلات النمو السكاني في سوريا والتركيبة السكانية السورية المتصفة بارتفاع نسبة الفتوة فيها، والتي تدفع بحوالي 200.000 شخص إلى السوق العمل في السنة كما ذكرنا سابقاً وأضفنا كذلك قرارات التخلص من العمالة الفائضة في القطاع العام كحاجة ملحة لا بديل عنها لزيادة الكفاءة، أدركنا حجم القضية الاجتماعية المقبلين عليها ونحن ندخل نظام السوق ونظام العولمة.
ويضيف قربي: أقول هذا لأؤكد حجم القضية الاجتماعية المتصفة بزيادة احتمالات البطالة والفقر التي تهددنا، حتى نعد لها البرنامج الخاص لمعالجتها بالشكل المباشر (لا بشكل غير مباشر فقط وكنتيجة لعملية النمو). وعلينا إعداد برنامج متكامل لمعالجة قضايا الاجتماعية بالتلازم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وفي مضمار الإعداد لبرنامج التنمية الاجتماعية يقترح:
تأكيد التعليم ونوعيته وتجاوبه مع متطلبات السوق كأداة من أدوات معالجة القضية الاجتماعية ومكافحة البطالة والفقر مثلما هو أداة من أدوات زيادة الإنتاجية في الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية.
ثم اختبار القطاعات الاقتصادية التي توفر الفرص الكبيرة للعمالة.
وزيادة الفرص المتاحة لعمل المؤسسات الصغيرة.
وإقامة برامج شبكات الحماية الاجتماعية بمختلف أنواعها بما فيها التدريب والتأهيل وتلك التي تقدم القروض والمساعدة الفنية لإقامة المشروعات الصغيرة.
وتوسيع وتحسين الخدمات الصحية خاصة للشرائح السكانية الفقيرة.
كما يجب تعزيز الإصلاح الاقتصادي وإصلاح التعليم.
ويجب اعتبار إصلاح التعليم جزءاً لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي سواء فيما يتعلق بالتعليم الأساسي (الابتدائي والثانوي) أو التعليم العالي. وقد أثبتت تجربة النمور الآسيوية الارتباط المباشر بين رفع سوية التعليم وزيادة الإنتاجية في الاقتصاد.
كما يجب أن يعتبر التعليم مفتاحاً لـتكوين الشخصية القومية والحفاظ على الهوية في مواجهة العولمة الثقافية وفي مواجهة التحدي الصهيوني في المنطقة بعد السلام.. ولزيادة الإنتاجية في الاقتصاد من خلال خلق الفرد القادر على التحليل والتفكير والإبداع… وللتعامل مع الثورة التقنية والمعلوماتية.. ولتلبية احتياجات سوق العمل، ولتوزيع الدخل ومكافحة الفقر، (فالتعليم يخلق فرصاً الارتقاء المعرفي وبالتالي زيادة الدخل).
ومن جهة أخرى ينبغي تكثيف نشاط كل من التدريب المهني والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويجب أن يكون البحث العلمي محدد الأهداف والاستراتيجية، وقابلاً للتحول التجاري إلى سلع وخدمات، فالبحث العلمي لا ينبع من فراغ، بل ينبع من الطلب عليه في السوق من الصناعي والمهندس والمزارع والمقاول والطبيب وغيرهم. وإذا لم يوجد قطاع إنتاجي ديناميكي معرض للمنافسة، ويحتاج للتطوير التكنولوجي ليبقى، فسيبقى البحث العلمي مجرد عملية مخبرية قيمتها في خصائصها البحثية وليس في أهميتها الاقتصادية.
مكافحة الفساد
نصل الآن إلى تعزيز مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.. إذ يزداد الاقتناع بأنه لا يمكن أن يتم الإصلاح الاقتصادي بنجاح ما لم يتم لجم الفساد والعمل على تكافؤ الفرص وتوفير الشفافية، ومن دون ذلك يرى د. قربي أنه سيتم هدر المال العام الذي يحتاجه المجتمع لكل من عملية التنمية وعملية التصحيح وتخفيف أعبائها على الفقراء… وستتخذ قرارات اقتصادية تخدم أصحاب النفوذ ولا تخدم المصلحة الوطنية العامة… كما سيظهر الإثراء غير المشروع وتزداد الفروقات بين الطبقات… وستخرج الأموال المحصلة نتيجة الفساد إلى خارج البلاد.
لذلك برأيه يجب أن يضع الإصلاح الاقتصادي القضاء على الفساد بمختلف أشكاله وعلى كافة المستويات هدفاً من أهدافه. ولعل من أصعب تحديات الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى نظام السوق كما أثبتت التجارب هو منع أصحاب النفوذ وأصحاب المال من الاستفادة من الثغرات أثناء عملية التحرر الاقتصادي، ولنا في التجربة الروسية والتجربة الإندونيسية دروساً.
ومن الإجراءات التي تساعد على كبح الفساد وفقاً للخبير الاقتصادي والتنموي..توفر الإرادة السياسية العليا لكبحه…وتوضح النهج الفكري في الاقتصاد…ثم وضع البيئة التشريعية والتنظيمية السليمة…وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني.
المجتمع المدني
يرى الخبير قربي أنه لا بد وأن تتضمن التنمية بمضمونها بمفهومها الشامل الجديد تفعيل مؤسسات المجتمع المدني بكافة شرائحه لتعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة وبحيث تشارك هذه المؤسسات أولاً في صنع القرار وفي اقتراح الخطط وثانياً في المتابعة والمحاسبة والمساءلة. ومثلما لم يعد ممكناً للدولة أن تقوم بالعملية الاقتصادية وحدها دون مشاركة القطاع الخاص لم يعد ممكناً للدولة والقطاع الخاص وحدهما القيام بعملية التنمية ومواجهة المنافسة العالمية من دون مشاركة المجتمع المدني بكافة شرائحه وفئاته وكل حسب اختصاصه.
ويضيف: لا شك أن فقدان التوازن بين دور الدولة ودور المجتمع المدني في العقود السابقة، لصالح دور الدولة، حرم عملية التنمية من مشاركة قدرات بشرية قيمة، وحرم عملية التنمية ذاتها من المحاسبة الموضوعية لها. لا بل نستطيع القول أن تهميش دور المجتمع المدني خلق نوعاً من إتكالية المواطن على الدولة، إتكالية في التفكير كما في العطاء، وأضعف شعوره بالمواطنة. وكانت نتيجة هذا إما القوقعة أو الهجرة. وكم هي من مفارقة أن نرى العقول ورؤوس الموال تغادر دنيا العرب وبينما نرى إسرائيل تستقبل العقول والخبرات ورؤوس الأموال من الشرق ومن الغرب.
وإننا اليوم أكثر ما نكون حاجة إلى إحياء مؤسسات المجتمع المدني وإعادة التوازن بين دورها ودور الدولة في إطار شراكة بينهما، شراكة حقيقية في سبيل المصلحة الوطنية الكبرى، فلا الدور الوصائي للدولة ولا دور المواجهة من المجتمع المدني كما نحتاج لتربية مدنية جديدة ركز على الحقوق والواجبات وعلى المساواة فيها وعلى سلطة القانون، وبحيث يصبح كل مواطن خفير وليست الدولة وحدها هي الخفير.
ويجب التأكد هنا وبكامل القناعة والإخلاص أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما برنامج التنمية الشاملة يحتاج لمشاركة المجتمع المدني في الإعداد والتنفيذ، حتى يتم قبوله وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج متى يبدأ تنفيذه إلى مجتمع مدني فاعل ليراقب ويحاسب ويشير إلى الخطأ وإلى الفساد فوراً في حال حدوثه، لا أن يغطى الخطأ والفساد أو يعالج خلف الأسوار وضمن اللجان، حتى يستطيع برنامج الإصلاح تجاوز عثراته المحتملة والتي لا بد منها بالسرعة القصوى.
يعتبر د. قربي أن العنوان الأهم في الإصلاح الوطني : الإصلاح في الجهاز الإداري للدولة.
إذ يحتاج الإصلاح الاقتصادي لإدارة مدنية كفوءة تصنع برنامج الإصلاح وتقوم بتنفيذه، وللأسف فإن جهاز الخدمة المدنية الحكومية في وضعها الحالي ليس على مستوى القيام بهاتين المهمتين بشكل كفوء لأسباب كثيرة منها..تدني الكفاءات فيها وتداخل السياسة مع الإدارة… وفقدان الحافز على العمل بسبب تدني الأجور…والمركزية الشديدة وتضخم الكوادر البشرية وتحكم البيروقراطية المفرطة في الأداء… وضعف المعرفة بأدوات نظام السوق وثقافته.
هذا ويتطلب إصلاح الإدارة المدنية الحكومية:
فصل السياسة و”التنظيم” عن الخدمة المدنية. فالخدمة المدنية عمل تقني بحث وحين تتدخل السياسة في الإدارة تفسد الإدارة.
وإعطاء المجال للمؤسسات التنفيذية القائمة للقيام بالدور المرسوم لها حسب قانون إنشائها، وتأكيد ضرورة ممارسة كافة الجهات والإدارات في مختلف درجات التسلسل الهرمي صلاحياتها ومسؤولياتها بالكامل ومحاسبتها على هذا الأساس.
ورفع الأجور في جهاز الخدمة المدنية. ولا شك أن هناك حاجة لرفع الأجور وبمعدلات عالية حتى تستطيع الإدارة الحكومية، توفير العيش الكريم لموظفي الدولة ورفع مستوى أدائهم وحتى تستطيع جذب الخبرات العالية للإدارة. لكن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه ما لم يترافق مع التخلص من العمالة الفائضة تماماً مثل مشكلة العالة الفائضة في القطاع العام الاقتصادي ويصبح القرار هنا قراراً سياسياً واجتماعياً بقدر ما هو قرار اقتصادي.
والعمل على تدفق المعلومات بين دوائر الدولة.
والتقليل قدر الإمكان من الازدواجية في العمل عن طريق دمج الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تقام بعمل مشابه.
والقيام بدراسة اختصاصية للجهاز الإداري في الدولة بهدف:
ثم تحديد الفائض الوظيفي وأماكن تواجده.
وتحديد مهمات الوظائف ومسؤولياتها في مختلف دوائر الدولة وتحديد المؤهلات لكل وظيفة.
ودراسة آلية العمليات الإدارية المختلفة في الدولة لتخفيف الروتين والاستفادة بصورة أفضل من وقت العمل بتحويل الوقت غير المنتج إلى وقت منتج.
ووضع معايير أداء موضوعية في الترفيع والمكافآت وإدخال نظام للزيادات والمكافآن يكون مرتبطاً بكمية الجهد الذي يبذله الموظف ونشاطه في العمل ومبادرته المفيدة إلى جانب نظام الترفيع حسب الأقدمية.
مرونة القرار الاقتصادي
يحذّر د. قربي من البطء في اتخاذ القرار الاقتصادي أو غياب هذا القرار في الوقت المناسب يشكل مشكلة رئيسية في سوريا، وسيشكل استمرار هذا النمط في تنفيذ برنامج الإصلاح مشكلة كبيرة.. ويرى أن سبب بطء أو غياب القرار الاقتصادي في سوريا يعود أولاً إلى المركزية الشديدة المتمثلة في المجالس العليا وفي اللجان المتعددة التي تسلب الوزرة المختصة صلاحياتها.. ويعود ثانياً إلى تشابك المسؤوليات في اتخاذ القرار الاقتصادي، والنابع من وجود قناتين على الأقل في صنع القرار الاقتصادي، قناة الدولة وقناة التنظيم.
ويقول: في اعتقادنا أن نظام السوق والمنافسة والانفتاح على التجارة الدولية والاستثمار الخارجي يتطلب المرونة والسرعة في الحركة ويتطلب بالتالي تغيراً جذرياً في أسلوب الإدارة الاقتصادية واتخاذ القرار، أسلوباً لا يتحمل المركزية الشديدة حيث يصبح البطء في اتخاذ القرار كلفة يتحمل نتائجها المنتج المحلي مقابل منافسيه الخارجيين.
ويتطلب التغيير اتخاذ قرارين جريئين يشكلان تحولاً جذرياً في أسلوب الإدارة الاقتصادية:
-أولهما: إقامة علاقة جديدة يبن الدولة المؤسسات والتنظيمية تحدد الأخيرة بموجبها كل من الثوابت النظرية واستراتيجية التنمية والتوجهات العريضة المرغوبة للاقتصاد الوطني، ويترك للحكومة اتخاذ القرارات الاقتصادية اليومية ضمن هذا الإطار، ثم تحاسب على أدائها في مؤتمر مصغر كل سنتين.
– ثانيهما: حل كافة المجالس الوزارية العليا فيما عدا المجلس الأعلى للتخطيط وتحمل كل وزير مسؤولية اختصاص وزارته بالكامل، متيحين للجهات العليا الفرصة لتتفرغ للسياسات الكبرى. كما يتطلب الأمر من كل وزير تحميل مديرياته المختلفة مسؤولياتها بالكامل في الوزارة نفسها، حتى يتسنى للوزير المختص إعداد السياسات والاستراتيجيات العليا بدلاً من الغرق في المعاملات الروتينية اليومية.
يجب علينا بناء هيكلية اقتصادية ومناخ اجتماعي وبيئة قانونية ترتقي لمستوى طموحات المواطنين.
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن