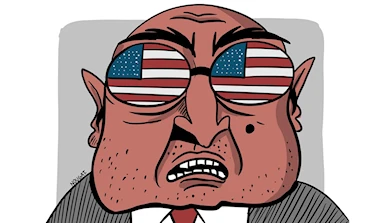يزن زريق
ولد الأديب والقصصي سعيد حورانية (1929 ــ 1994) عند وجيه من وجهاء حي الميدان الدمشقي العتيد سنة 1929. تاجر حبوب ميسور، وهو شيخ ورجل دين معروف أنّه الشيخ حسني حورانية. عن منشأ الأديب إذاً من الناحية الاجتماعية، يمكن تحديد انتمائه إلى بيئة البرجوازية (أو الطبقة الوسطى الميسورة)، بيئة البرجوازية المدينية المحافظة والتقليدية. تلك هي البيئة الاجتماعية التي قدم منها. أما عن البيئة الفكرية الأيديولوجية التي قدم منها سعيد وتربى فيها، فقد وصفها وصفاً معبراً عندما قال عنها إنّها «بيئة دينية ثورية»! فعلاً، نشأ الأديب في بيئة ذات توجه ديني إسلامي واضح يؤطرها الدين كتوجه عقائدي وفكري، وبالطبع سياسي. إنه التدين المحافظ المبادر أو «الإيجابي» (أي المتحفز ليعبّر عن نفسه كنشاط سياسي، وليس محض نمط حياة أو اتجاهاً شخصياً) المألوف عند البرجوازية المدينية عادة وهو يشتد في أوقات الأزمات الوطنية والاجتماعية ليصبح أكثر بروزاً وفاعلية.
سعيد حورانية عام 1979 (جورج عشّي)
تركيا – تكلفة زراعة الأسنان بالفم الكامل قد تفاجئك تمامًا
زراعة الاسنان في تركيا
يقول حورانية عن نفسه متذكراً شبابه: «لقد نمَت حياتي الروحية والفكرية في الجامع. كنت أدرس في جامع الدقاق وأنام فيه، عند الشيخ حسن حنبكة المعروف». والنتيجة الطبيعية للفتى الشاب المتحمس والمندفع كانت في انضمامه في عام 1947 إلى جماعة دينية متطرفة. «لقد كنت أخفي في سنواتي الأولى في الجامعة خنجراً على خصري لأخيف من يتجرأ ضد الدين». ومع قرار التقسيم، كانت قد بدأت الجماعة أعمال فوضى وتخريب، كتعبير عن التمرد والرفض، وكان مقر الحزب الشيوعي السوري هدفاً لبعض أعمال التخريب نظراً إلى وقوفه العلني مع قرار تقسيم فلسطين. وقام أصدقاء سعيد المتدينين بنهب مقر الحزب ومن ضمنها مكتبته. أما عن الكتب، فأعطوها لسعيد الشاب، على اعتبار أن شغفه بقراءة الكتب الدينية والتراثية معروف في ما بينهم. أعطوها لسعيد ولم يكونوا يعرفون أنهم بذلك كانوا قد أفسدوا «الأخ سعيد» المتدين والملتزم دينياً إلى الأبد! لقد أفحمت الكتب سعيد وغيرته جذرياً بل ضيّعته في البداية! ففي المرحلة الأولى، تحول سعيد الشاب من متدين إلى عدمي (وكانت أولى البوادر المبشرة! عودته في يوم سكرانَ إلى بيت أبيه الشيخ فـ «أكلت قتلة غير معقولة») ثم بدأت التحولات الشخصية تتبلور وتتحول إلى تغييرات وتحولات ذات أبعاد حقيقية وفكرية.
من شوقي البغدادي إلى حنا مينه، صار لسعيد الشاب رفاق جدد، وبدأت تحولاته الفكرية تجد تعبيراً محدداً لها في الأدب، وتحديداً في مجال القصة والقصة القصيرة. استقل سعيد الشاب عن أهله ليعيش حياة فقر وفكر، ويبدأ العمل في الأدب بشكل رسمي عبر أولى مجموعاته القصصية «وفي الناس المسرة» التي صدرت عام 1952.
في عام 1954، انتقل سعيد إلى الحسكة ليعمل فيها كمدرس، ثم ليعود إليها عام 1956 ليؤدي خدمته الإلزامية فيها. وكان قد عُيِّن قبل ذلك مدرساً في السويداء، وعلى إثر وقوفه مع أهل المدينة ضد انقلاب الشيشكلي، نُفي إلى الجزيرة السورية وقضى فيها وقتاً.
كان للأديب الشاب دور كبير في تأسيس «اتحاد رابطة الكتاب العرب» مع أسماء أدباء ومفكرين كبار ومهمين عرب أمثال حسين مروة، ومحمد دكروب، وحنا مينه… وعرف السجن مرة أو مرتين في عهد الوحدة وعهد الانفصال، وسافر مرة أو مرتين إلى الاتحاد السوفييتي بوصفه مديراً للمركز الثقافي السوفييتي في سوريا. لا شيء «خارجياً» ظاهراً آخر في حياة الأديب الخاصة أو الشخصية جدير بالذكر. لا شيء خلاف ذلك يمكن الالتفات إليه. هناك أمر آخر أنه بعد مجموعاته القصصية الأولى، امتنع كلياً عن الممارسة الأدبية القصصية وتوقف إنتاجه الأدبي الحقيقي عند تلك النقطة وبقيَ متوقفاً إلى حين وفاته عام 1994! بضع مقالات في النقد الأدبي وبضع مقابلات ليس إلا، فيما عدا ذلك، لا شيء!
هذا الذي يُلقب بـ «تشيخوف القصة العربية»، ذو سيرة ذاتية متواضعة فعلياً، أو هي على الأقل لا تقدم لنا شيئاً لتحقيق فهم حقيقي لأدب الرجل أو أهميته!
أذكر أنني سألت أحد الأصدقاء مرة ممن عاشروا سعيد وتعرفوا إليه وقابلوه، وهو من جيلهم وينتمي إلى «الرعيل» نفسه عن سعيد الشخص والإنسان. كان الجواب بسيطاً لا يشفي الفضول: كتلة طاقة وحماسة، يحب النقاش، وبخشونة أحياناً، ورفيق كأس جيد، وهو بكداشي… كارثة!
انقطاعه عن الكتابة القصصية والإنتاج الأدبي لغز، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه بأعماله المنشورة المبكرة التي كانت واعدة والجوائز التي حصدتها والتأثير الذي تركته، وكان حنا مينه قد عبّر عن ذلك ببلاغة في مقدمته لـ «عزف منفرد لزمار الحي»، قائلاً: «لا تسألوني إلى أي حد بلغ سعيد في صمته أو في مرضه الصمتي. فلطالما حاولت أن أقرأ في عينيه موعد مغادرة هذا الصمت، فكان يكتشف محاولتي بلماحته ويرد حتى من دون أن أتكلم: دع عنك هذه المحاولة يا حناي. وقد أقلعت عن المحاولة مع الأيام فعلاً». لا ريب في أن القارئ يدرك أن كل ذلك لا يقول شيئاً عن سعيد فعلاً، ولا يقول شيئاً عن أدبه وإرثه القصصي، والذي هو على قلّته، يشكّل «ظاهرة» في الأدب السوري والعربي عموماً. لقد كان فعلاً بارقة رعد مدوية، بارقة رعد تلك التي لم يتبعها المطر.
الحياة الشخصية لا تقول شيئاً عن أهمية الأديب (لا في حالة سعيد ولا في غيرها). جواب الأسئلة كلها في أدبه، في إرثه، في ممارسته الأدبية وفي تركته القصصية. فهناك ينكشف اللغز، هناك نعرف سعيد حورانية الحقيقي، وتنجلي أبعاد «الظاهرة».
بلادنا العربية وسوريا هذه البلاد المتخلفة الريفية والفلاحية شبه البدوية في غالبيتها العظمى، مسألتها الرئيسية الاجتماعية والسياسية كانت ولا تزال: الأرض. الأرض ببساطتها، أرض الفلاح السوري التي هي عصب حياته ومعيشته وثقافته. من هنا، يمرّ التاريخ وحولها يتمحور الصراع السياسي والاجتماعي بغالبيته. إنه الموضوع الأكبر، الموضوع الجذر. حنا بطاطو (في كتابه الموسوعي «فلاحو سوريا»)، بوعلي ياسين («حكاية الأرض والفلاح السوري» و«القطن وظاهرة الإنتاج الأحادي في الاقتصاد السوري») والباروت (وحتى باتريك سيل كان قد أدرك بعمق لا يستهان فيه مركزية المسألة في كتابيه المرجعيين عن تاريخ سوريا) وغيرهم من المفكرين كانوا قد حاولوا تقديم رؤى فكرية ومنهجية للمسألة. وعلى المستوى السياسي، خصوصاً إثر الاستقلال، كان السياسيون الذين فهموا أهمية المسألة قلّة مثل أكرم الحوراني وبدرجة أقل وبأهمية لا تكاد تذكر بقية الأحزاب العقائدية. أما الانقلابات العسكرية، فلم ترَ المسألة المصيرية ولم تلتفت إليها، بل على العكس كانت عاملاً في تكريسها (الحل التاريخي الأكبر كان على يد الحكم العربي الوحيد الذي فهم ولو جزئياً الأهمية المحورية لقضية الأرض وحاول ولو جزئياً تقديم حل لها وهو الحكم الناصري وعهد الوحدة، وهذا موضوع يقع طبعاً خارج سياق بحثنا). وضمن السياق نفسه طبعاً، يقع انقلاب الشيشكلي أو مرحلة «الحكم الديموقراطي» في الخمسينيات… إنها حكومات فاسدة وفوق ذلك قمعية وبوليسية، والفلاح هو عدوها وهي بالطبع على اختلاف ألوانها وأشكالها عدوته.
لقد تحدثنا سريعاً عمن التقطوا أهمية مسألة الأرض في الفكر والسياسة (أي في ممارستهم السياسية) التقاطاً حقيقياً أو يكاد، وبقي هناك ميدان ثالث: الأدب. في خمسينيات القرن الماضي، هناك أديب سوري وضع ــ عبر بضع قصص قصيرة فقط ــ يده على القلب النابض للحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية للبلاد في تلك المرحلة (وفي المناسبة، لا يزال!). بل إنه ببصيرة أدبية صافية، التقط المسألة بأكملها. التقطها كاملة خالصة وبكامل أبعادها بما فيها أبعادها الإنسانية. إنه سعيد. ومن دون بهارج ومن دون مقدمات وحذلقات، جاءت أعماله ملحمة للأرض والفلاح السوري. هل تريد فهم مسألة الأرض وعلاقة الفلاح بها؟ لا تكثر من الأبحاث الأكاديمية والدراسات، فهي لن تعطيك الكثير، بل اذهب إلى سعيد وسيعطيك أكثر مما تعتقد.
حكومة الشيشكلي البوليسية الفاسدة صادرت أرض صالح سلمان، الذي كان فلاحاً حسكاوياً عتيداً أسمر لونه من لون تربة قريته: «السنة الماضية جاءنا أمر من محكمة الحسكة بتخلية الأرض التي يزرعها لصالح الشيخ دعيبس، ولكن المنكود رفض! وقال: الحكومة مع الشيوخ، مع النهابين».
إنه أسلوب حورانية، إنه يعتمد أسلوباً درامياً مكثفاً ومليئاً بالصواعق المدوية. إنها ملحمة تنتمي إلى العصر الحديث وواقعية جداً، وليست مسلية إطلاقاً. بضربة واحدة، وضع حورانية يده على جوهر مسألة الأرض في خمسينيات القرن الماضي، وقبل الإصلاح الزراعي لحكومة الوحدة: أولاً مسألة «المرابعة» وكراية الأراضي وزراعتها من دون تمليك ولمصلحة الوجاهات الإقطاعية والاجتماعية مع ما يعنيه ذلك من ظلم للفلاح غير المالك وتبعيته المطلقة لصاحب الأرض والرزق، المالك القانوني ولكن غير الشرعي لها. ثانياً السلطات السياسية على مدار التبدلات والتغيرات التي طرأت على أشكال الحكم المتعاقبة منذ عهد الاستقلال إلى أن أتى عهد الوحدة، كانت كلها بأجهزتها وإداراتها وبوليسها لمصلحة الإقطاعي المتنفذ مالك الأرض وضد الفلاح. وثالثاً توق الفلاح العادل والبطولي وغير الرومنسي أبداً (إذ إن توقه هذا معفّر بعرقه وبرائحة جوع أولاده وتراب أرضه وأسمال بيته ونسائه وأطفاله). نقول إن هذا التوق بات ثابتاً سياسياً اجتماعياً طبع الحياة الاجتماعية والسياسية السورية بوصفه العصب الحقيقي الداخلي الذي يحدد كل العوامل الأخرى وعاملاً داخلياً مركزياً في المشهد السياسي والاجتماعي السوري (وفي المناسبة العربي) ولا يزال.
حورانية ذلك المعلم البسيط الذي نُفي بضع مرات إلى الجزيرة، أدرك جيداً الأرض وأدرك جيداً من هم أهلها، ووضع يداً صافية ومتعاطفة وصادقة على أوجاعهم وآلامهم مدركاً حقيقتهم. كان مدركاً بأن تلك الأرض علمتهم الكثير، وربتهم تربية فيها كثير من الشرف والقليل من الرفاهية! فيها كثير من الكبرياء وقيم رفيعة هم غرباء عنها كلياً… أصحاب المناصب وأهل الحكم والسلطة الذين تناوبوا على أنظمة الحكم في عالمنا العربي ولا يزالون إلى اليوم بعد قرن من الزمن من تحقيقنا لاستقلالنا السياسي. في أدب حورانية، نرى ما وراء الأسمال وما خلف مظاهر الفقر والريف. نرى القضية الاجتماعية الأهم والأكبر في التاريخ السياسي الحديث لكل دويلات المنطقة، ماثلة بحيوية إنسانية تكاد تنطق. حورانية لم يكتب قصصاً ولكنه رسم لوحات، خلق مشاهد ولوحات جدارية جديرة بالكنائس والمعابد، وهي ضخمة فعلاً وبحجم تاريخ وطن. نعم، هناك في تلك البوادي والأنحاء النائية وفي قرى الفلاحين الذين يشكلون أكثر من 80% من سكان الوطن العربي، يُكتب فعلياً تاريخ الوطن وتحل قضاياه الاجتماعية والسياسية المصيرية الحاسمة، وليس في أي مكان آخر موهوم. وحورانية في لوحاته يمسك بأيدينا ويقودنا بأمانة إلى مركز الحياة الاجتماعية السورية والعربية، إلى قلب الحدث ويقول لنا تفضلوا: هذا أنتم، ها نحن.
في اختياره لنماذجه الأدبية وبيئة الأحداث ومسرحها، ثم تطورها التفاعلي والمتصاعد، نحن أمام نبرة «تشيخوفية». يعطي حورانية للمسائل المطروحة بُعدها الكامل وبجوّ يربطك فوراً بالحدث ليجعلك منتمياً ومتورطاً معه ومع أبطاله كأنك ولدت هناك (قريب جداً من الصوت الحميمي الذي يخلقه تولستوي في أعماله العبقرية عن القوزاق والريف الروسي الإقطاعي) فالبعد الدرامي عند حورانية يأتي طوعاً بتلقائية، بل يمكن القول إن الحدث نفسه يفرضه من دون تدخل من الكاتب، وتلك قوة نادرة في الأعمال الأدبية.
ممارسة حورانية الأدبية الرفيعة في السياق الذي ذكرناه، تجعلنا نتسامح مع الأديب على أعماله المبكرة أو الواهنة، التي تغلب عليها العدمية والوجودية وذاتية المثقفين. كما تجعلنا نقف باحترام طبعاً أمام اختياره عدم متابعة أعماله القصصية والاقتصار على ذلك الإنتاج المحدود الذي اختاره. لقد قال فيه الكثير، غالباً كان قد قال فيه ما يكفي. «صالح السلمان ظل صامتاً طويلاً لا يقول شيئاً ينظر من النافذة ولكن نظرته كانت تقول كل شيء».
سيرياهوم نيوز٣_الأخبار اللبنانية
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن