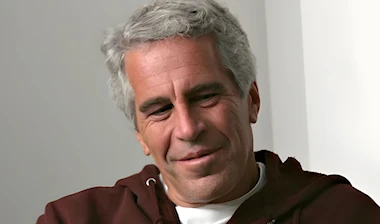هادي قبيسي
نحن أمام تحوّل معرفي/ثقافي هائل، بدأ في غزة وانتقل إلى جزيرة النخبة الغربية التي يديرها «الموساد» من خلال جيفري إبستين. نحتاج إلى بحث وجهد كبير حتى نفهم لماذا وصل العالم الغربي إلى هذا المستوى من الانكشاف.
كان الاتجاه الغربي محكوماً للإنسانوية (الهيومانيزم)، وفيما ليس ثمة شك بأن جرائم الاستعمار بعد عصر النهضة لا تختلف عن ارتكابات العصور البربرية المتوحّشة، لكنّ هناك اتفاقاً بأن الغرب استطاع تمويه وإخفاء عدد هائل من جرائم الإبادة، ومن ثم إقناع الشعوب المُضطهدة بأنه أكثر تحضّراً وأخلاقية منها، واستمرّ في ممارسة هيمنته عليها بالاستفادة من وسائل متعدّدة منها الصورة الناعمة والقدرة على الإقناع.
أمام المتغيّر الحالي يخرج سؤال رئيسي: لماذا أخفق الغرب في إخفاء فساده وتعفّنه الأخلاقي المريع؟ سواء أكان في قضية غزة أم في ملف إبستين؟ بالتأكيد أن هناك اختلافاً بين الحالتين والملفّين، ولكلٍّ خصائصه. ورغم اشتراكهما في التأثير على صورة الغرب، فإنّ كل مسار كانت له محفّزات وسياقات مختلفة.
بالنسبة إلى ساحة غزة، فإنّ السبب الرئيسي في الإخفاق هو عدم قدرة الغرب على ضبط النخبة الصهيونية الدينية التي تحكم الكيان، والتي أصبحت متحكّمة بمفاصله في ظلّ تحالفها مع نتنياهو، وسماحه ودعمه الهائل لتلك النخبة بالردّ على عملية السابع من أكتوبر من خلال إطلاق مشاريع الترانسفير وتجاوز ردّ الفعل في سياقه الاستراتيجي، والانتقال إلى برامج سحق وحسم وإنهاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين.
عملت تلك النخبة من خلال نزع القفّازات السياسية، واستغلال اللحظة للتخلّص من مشروع المقاومة الفلسطيني بشكل نهائي وحاسم، ومن ثم الانتقال إلى باقي الساحات لاستهدافها وإضعافها، مستخدمةً القوّة المحضة دون أي توجيه سياسي عقلاني، كيما تتمكّن من تجاوز الفرضية التنبُّئِية المُتداولة في الوسط الصهيوني حول زوال الكيان بعد بلوغه العام الثمانين، والتي تُعدّ عامل تحفيز وتسريع لمؤثّرات الشعور بالتهديد الوجودي الذي تمثّله حالة المقاومة في المنطقة. جاء هذا التوحّش في زمن التواصل الاجتماعي وعصر الصورة الفورية للميدان، بحيث لم يعد بإمكان الغرب طمس الحقائق وإبعادها عن التناول، بل هي قيد التداول اللحظوي البصري المباشر.
نقطة الربط بين الفضيحتين، اللّتين تشكّلان خطراً فعلياً على البنية الثقافية الغربية برمّتها، هي أن النخبة الصهيونية استغلّت أوراق ضغط تشكّلت في الجزيرة التي أدارها ضابط «الموساد» جفري إبستين، أوراق سقوط أخلاقي ورذيلة للنخبة الغربية، امتلكها الكيان الصهيوني واحتفظ بها للضغط على القيادات الغربية، حتى تمتثل لرغباتها حينما تتفاوت، بشكل جزئي يتعلّق بالكيفيات والدرجات والمواقيت لا الأصول والغايات، مصالح الغرب مع مصالح الثكنة التي أقامها في منطقتنا. على أنّ هذه الوسيلة للابتزاز الشخصي ليست طريقة التأثير والهيمنة الوحيدة للمجموعة الصهيونية على النخبة وشبكات المصالح الغربية، لكنها تبدو أنها سلاح اللحظة الحرجة.
أمّا قضية إبستين، فتمثّل نقطة انعطاف في الصورة الغربية، سواء بالنسبة للشعوب الغربية التي آمنت بنظام فكري إنسانوي، يتضمّن ثغرات أخلاقية تُعتبر أخطاءً إنسانية طبيعية، يلاحقها القانون والإعلام والأجهزة الأمنية، لتصطدم بفضيحة تتجاوز مساحة التسامح المسيحي أو الليبرالي في حدوده القصوى. إنه انكشاف غير متوقّع من حيث الحجم والكيفية لانهيار شامل لكل ما يمكن أن يقرّه العقل والضمير البشري من ضوابط. هو تعبير عن استباحة شاملة لكل معاني الإنسانية ومشاعرها وقيمها وأخلاقيتها، وعن تخلّي النخبة الغربية بشكل تام وكامل وحاسم عن أي احترام للمرأة والطفل، لمشاعرهما وحياتهما وأحاسيسهما وحقهما في الوجود حتى.
جاء انكشاف ملفات إبستين في سياق أميركي خاص؛ إنه عصر ترامب، الرجل الفوضوي العابث والفاقد لأي رؤية لمعالجة أزمة إمبراطورية بدأت ديونها تصل إلى حدود أسطورية. تفكيره مُنصبّ على البقاء في السلطة لولاية ثالثة، وعلى السجالات مع الإعلاميين والخصوم الداخليين، وعلى تحقيق إنجازات إعلامية مضخّمة، يمارس عملية مضاعفة تأثيرها من خلال البقاء أمام الكاميرات أغلب الوقت، مُسرِفاً في مديح الذات، ومتصادماً مع الحلفاء في أوروبا وكندا، وتبعاً لذلك تصادم مع شركائه في الحزب الجمهوري، الذين لا يوافقون على قرارات يتخذها بشكل متعجّل وفق طريقة مساومة التجار، وكأنه يحكم دكانه الخاص، دون أن يكون للآخرين رأي أو اعتبار، مستنداً إلى وزراء يمتازون بالانقياد الأعمى له ويتزلّفون له أمام الكاميرات.
الفساد العظيم الذي أظهرته ملفّات الجزيرة الخبيثة التي يديرها «الموساد»، وضع مصداقية طبقة سياسية بكاملها على المحكّ، والتخويل الذي تضعه الشعوب في حكّامها ونخبتها يقوم على أساس الثقة والمصداقية، ولذلك هذا السقوط وهذا الانحدار غير مسبوقيْن
منذ ولايته السابقة، بدأت تظهر صُور ترامب مع إبستين، في سياق مسار ضغط تمارسه النخبة الأميركية الديمقراطية باتجاه ترامب الذي يعبث بالقواعد التي اعتادت عليها تلك النخبة، اقتصادياً وديموغرافياً واجتماعياً، ولمواجهة مسار تثبيت نفسه كزعيم لأميركا طول الحياة. تزايدت الأزمات والمشكلات التي جمعت بين مخاوف الديمقراطيين وجمهورهم من سياسات ترامب، وبين مخاوف الجمهوريين وقلقهم من عبثيته واضطراب سياساته في كل مجال.
في هذه اللحظة، تقدّم إلى المعترك نائبٌ جمهوري أراد الهروب من سفينة ترامب الغارقة في عام انتخابات نيابية، هو النائب توماس ماسي، الذي يعارض بالمناسبة تسليح الكيان والحرب على فنزويلا وإيران. قام توماس باقتراح قانون يفرض على وزارة العدل التي تقع تحت سلطة ترامب نشر ملفات الفضيحة الأخلاقية الأعظم في تاريخ أميركا. لم يجد أي نائب في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إمكانية لمعارضة القرار، فأي تهرّب سيوجّه إليهم علامات الاستفهام، خاصة أن غالبية كبيرة كانت تؤيد، لذلك جاء التصويت على القانون بأغلبية ساحقة وشاملة في المجلسين. لم يكن أمام ترامب إلا أن يوقّع ويوافق، مدّعياً أن الملفات ليس فيها ما يمسّه شخصياً، ولا يزال يدّعي ذلك للآن رغم وضوح سقوطه في الرذائل من شتى الأنواع.
مع انفجار قضية إبستين الشائنة انتقلت المسألة الأخلاقية إلى قضية داخلية بعد أن كانت مشكلة خارجية تتعلق بالفلسطينيين، الذين أجادوا استدراج قطاعات رئيسية في النخب الشبابية الغربية إلى جانبهم، وبعد ذلك جزءاً من الديمقراطيين والجمهوريين في أميركا، لكنها لم تشكّل محور اهتمام الشعب الأميركي على اختلاف فئاته، بل مسألة هامشية ظلّت محلّ اهتمام مستمرّ.
الفساد العظيم الذي أظهرته ملفّات الجزيرة الخبيثة التي يديرها «الموساد» وضع مصداقية طبقة سياسية بكاملها على المحكّ، والتخويل الذي تضعه الشعوب في حكّامها ونخبتها يقوم على أساس الثقة والمصداقية، ولذلك هذا السقوط وهذ الانحدار غير مسبوقيْن.
تحوّلت كلتا القضيتين إلى أدوات سياسية كذلك، فكل طرف يستخدم الأدلة الجنائية في قطاع غزة وفي جزيرة إبستين ضد الطرف الذي يمكن استخدامه ضده، وقد تشكّلت تيارات وتصاعدت قيمتها السياسية والانتخابية بفعل حرب غزة، هي نفسها التي تستثمر الفضائح المريبة التي كشفتها وزارة العدل مُرغمة.
وهي لا تطاول فقط شخصيات أميركية، بل إنّ إبستين، بحضوره في شركة روكفلر، وشراكته في مجموعة دولية أسّستها عائلة روكفلر، تُسمّى «اللجنة الثلاثية»، تضم أكبر الشخصيات السياسية والاقتصادية مثل كلينتون وكيسنجر وشخصيات الدرجة الأولى من آسيا وأوروبا وأميركا، وباعتباره خبيراً مالياً متميّزاً استطاع تحصيل ثقة عدد كبير من الشخصيات الدولية، فقد تمكّن من تقديم خدمات دولية واسعة لـ«الموساد»، لم تظهر أنواعها وأشكالها المختلفة حتى الآن بشكل واضح وشامل. وبناءً عليه، سيكون لهذه الفضيحة، مضافة إلى تشكّل التيارات الرافضة للإبادة، وتشكّل ديناميات سياسية داخل الدول الغربية بناءً على هذه المتغيّرات، أثر أوسع من الولايات المتحدة حيث أُطلقت موجة الوثائق.
تأثير عجز الغرب عن إخفاء كوارثه الأخلاقية يتفاوت في الظروف والقضايا والساحات، فقد انهارت صورة الغرب وسمعته بشكل غير مسبوق في التاريخ المعاصر، والأهم هو انكشاف دور المجموعة الصهيونية الدولية في التأثير على قرارات الدول الغربية وتسلّطها على كثير من القيادات الغربية بطرق ملتوية، لا تعبّر عن موازين القوى بقدر ما ترتكز إلى أساليب تجنيد قذرة.
بدأت مع السابع من أكتوبر مسيرة انحدار الهيمنة الصهيونية على الغرب، لم تتأثّر صفقات التسليح حتى الآن بشكل كبير، ولا يزال تقاطع المصالح الغربية/الصهيونية أقوى من تأثير قوى الضغط الداخلي المعارضة للإبادة والرذيلة، لكن ما يحصل حالياً هو تغيّر اتجاهات الناخبين بعيداً عن الشخصيات التي وظّفتها الصهيونية، في ظلّ انحدار اقتصادي غير مسبوق يعمّ الغرب كله، بحيث ينحسر بالتدريج استعداد النخب الغربية لتبرير تمويل المشروع الصهيوني في ظل النقائص المعيشية المتزايدة، وعدم استفادة الغرب بشكل فعّال ومؤثّر في معالجة أزمته الاقتصادية من هيمنته على غرب آسيا.
داخلياً، يحتاج الغرب إلى مراجعة شاملة لمشروع عصر النهضة، وكل مستتبعاته، ونخبته الشبابية الآن تشعر بأنها تحتاج إلى تلك المراجعة، فهل أخفقت الإنسانوية في استبدال الدين المسيحي؟ وهل يمكن للنظام الليبرالي أن ينتج قيادة أخلاقية؟ لم تكن هذه الأسئلة مُتاحة في السابق، مع وجود مسافة بين ساحات الجريمة الإبادية أو الرذيلة الأخلاقية، وبين الشباب الغربي، لكن اليوم، أصبح السؤال ملحّاً، وسيكون السؤال عن البديل أكثر خطورة وإلحاحاً.
* مدير مركز الاتحاد
للأبحاث والتطوير
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن