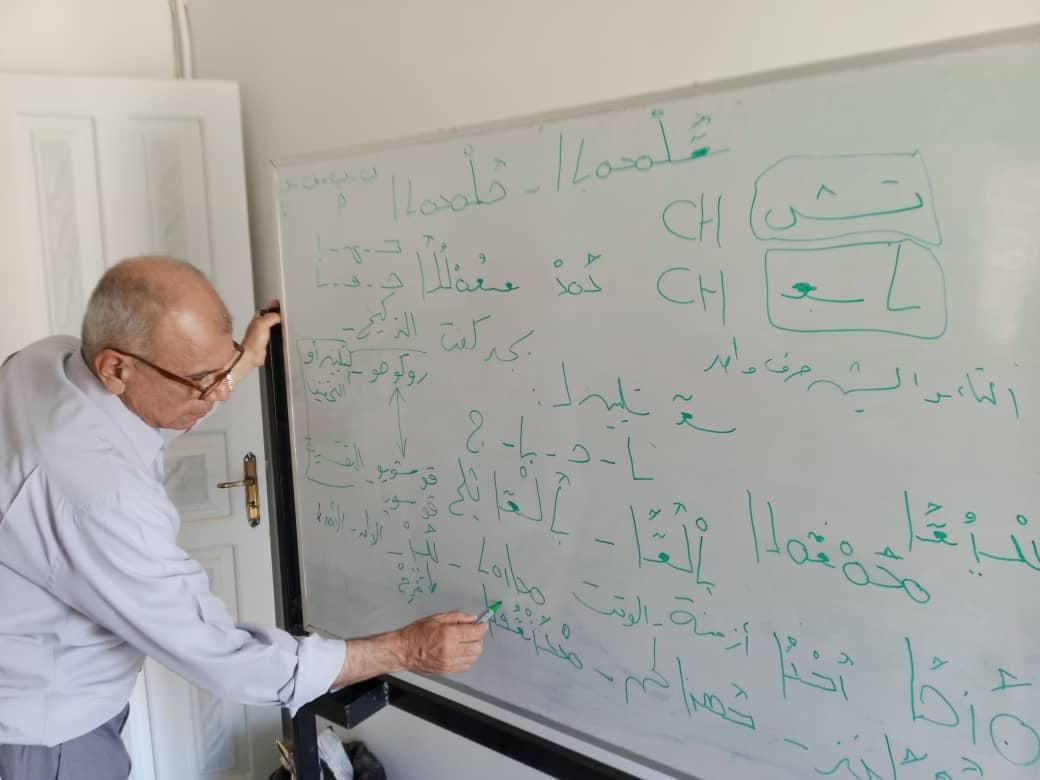سعيد محمد
وظّفت الحركة الصهيونيّة معادلة فاسدة ابتدعها دهاقنة الصهيونية المسيحيّة عن «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» كإستراتيجية لتطهير الأرض من أهلها، وتكتيك لجمع الأموال من يهود العالم وصهاينته في إطار مشروعهم المأفون لإقامة دولة عبريّة. وعلى الرّغم من التهافت النظري لطرفَي هذه المعادلة، إلا أنّها أصبحت صورة مزيّفة عن الواقع القائم في فلسطين طوال عقود ما قبل تأسيس الكيان الموقت، من دون أن يمتلك الفلسطينيون من الأدوات الإعلاميّة لنقضها. مجموعة ثمينة من الصور الفوتوغرافيّة التي سجّلت أجواء الأرض وأهلها في تلك المدة، استعادها مشروع «كرامة» من أرشيف الكونغرس الأميركي وقدّمها، في كتاب مطبوع فاخر، ليكون بمثابة وثيقة مكتملة البلاغة عن شعب الأرض التي قيل إنّها بلا شعب
زعماء فلسطينيون مجتمعون لمناقشة ثورة 1929
هنالك من الدلائل الموثّقة ما يكفي للزعم أن فكرة «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض» نبتت في بيئة المسيحيّة الصهيونيّة الأنغلوساكسونيّة حتى قبل تبنّيها من جانب قادة الحركة اليهوديّة الصهيونيّة الرّواد أمثال يسرائيل زانغويل وثيودور هيرتزل. وكتب أنتوتي كوبر، الذي كان يحمل لقب إيرل شافتسبري السابع، ورئيس «جمعيّة لندن» لنشر المسيحيّة بين اليهود، في عام 1853، إلى جورج هاملتون-غوردن، رئيس وزراء الملكة فيكتوريا، «إنّ سوريا (الكبرى) كانت «بلاداً بلا أمّة» في حاجة إلى «أمّة بلا بلد». فهل هناك شيء من هذا القبيل؟ والإجابة: من المؤكد. فهناك أسياد الأرض القدامى والشرعيون، اليهود! في نصّ من مذكراته يعود إلى عام 1854، ما مفاده أنّ «سوريا تضيع بلا سكان. فهذه المناطق الشاسعة الخصبة ستكون بلا حاكم أو سلطة معروفة معترف بها للمطالبة بالسيادة. إنها أرض بلا شعب. والربّ الآن، بحكمته ورحمته، يوجهنا إلى شعب بلا أرض». وفي عام 1875، أخبر شافتسبري الاجتماع العام السنوي لـ «صندوق استكشاف فلسطين» أنّ «لدينا هناك أرضاً تعج بالخصوبة وغنية بالتاريخ، لكنّها من دون سكان تقريباً، أرض بلا شعب، بينما ينتشر في جميع أنحاء العالم، شعب بلا أرض».
وبالطبع، فإن تهافت طرفَي هذه المعادلة التي أنتجها تلاقح العصاب الدينيّ مع النزق العنصري الأوروبيّ في زمن صعود القوميّات، أمر لا يحتاج إلى عميق بحث. فلا الأرض في فلسطين ـــ سوريا الجنوبيّة ـــ كانت بلا سكان، ولا اليهود كانوا في يومٍ ما شعباً أو عرقاً بالمفهوم الحديث، بل دائماً أتباع ديانة مستلّة من تاريخ بداوة سحيق منتشرين عبر الأعراق والجغرافيات. وقد اصطدم المشروع الصهيوني باكراً بشعب عريق متجذّر في أرضه في فلسطين كما أشجار الزيتون العتيقة، فاليهود الأوكران الذين أقاموا المستوطنات الأولى في رعاية الدولة العثمانية، قبل أربعة عقود من وعد اللورد بلفور بمنح فلسطين المحتلّة إلى اليهود، وجدوا رأي العين أنّ جنوب سوريا ليس ببلاد خالية، وأنّهم إن أرادوا البقاء طويلاً، فلا مناص من الصراع. وأرسل جواسيس ـــــ بعثت بهم جمعيات مسيحيّة متصهينة في الولايات المتحدة لاستكشاف الحقائق على الأرض ـــــ ببرقيّة لهم من القدس مموّهة قالوا فيها: «لقد وجدنا العروس – أي فلسطين – جميلة، ولكنها متزوجة بالفعل». واكتشف يسرائيل زانغويل، اليهوديّ البريطانيّ الذي كان أحد أبرز مساعدي ثيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية اليهوديّة الحديثة، الواقع الديموغرافي على الأرض الفلسطينية بنفسه بعدما طاف في المنطقة عام 1897، وعاد ليعلن في خطاب له «إنّ لفلسطين كما هي قائمة الآن سكّاناً. بل إنّ في قضاء القدس من كثافة السكان الآن ما يفوق كثافة السكان في الولايات المتحدة مرتين، إذ فيه اثنان وخمسون نسمة في الميل المربع الواحد، أقل من ربعهم يهود. لذا علينا أن نستعد إما لطرد القبائل العربيّة، صاحبة الأرض، بحدّ السيف كما فعل أجدادنا، وإما أن نتعامل مع مشكلة وجود عدد كبير من السكان الغرباء، ومعظمهم من المحمديين الذين اعتادوا، ولقرون طويلة، على ازدرائنا».
ومع أن زانغويل حاول مخلصاً إقناع الحركة الصهيونية بتغيير موضع تنفيذ مشروع صهيون بالتعاون مع الإمبراطوريّة البريطانيّة التي لم تكن تغيب عن أملاكها الشمس، إلا أن إرادة كبار حاخامات الصهيونيتين المسيحية واليهوديّة، استقرت على ضرورة الاستمرار في استيطان فلسطين تحديداً بحكم الروابط التوراتية المزعومة، فكان التوجه لتبني المعادلة الفاسدة: «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض»، كإستراتيجيّة وتكتيك في إطار سعيهم لتنفيذ ذلك المخطط الآثم. تتمثل الإستراتيجيّة في إفراغ الأرض من شعبها العربيّ بالإبادة والتطهير العرقي والرشوة وشراء الأراضي من الإقطاعيين العرب المتصهينين ومنع عودة الناجين عبر تدمير أماكن عيشهم وسلب مصادر رزقهم، واستبدالهم بشعب ملفّق: يهود بألوان كثيرة، مستوردون من كل ركن من أركان العالم الأربعة. والتكتيك أن يوظّف الشعار لاستدرار حماسة أثرياء المسيحيين واليهود نحو التبرع بسخاء لمشروع الهندسة الاجتماعيّة الذي كان لا بدّ منه لتحقيق الرؤى التوراتيّة المريضة.
لقد تحوّلت المعادلة الفاسدة إلى ثيمة مركزيّة للعمل الدعائيّ الصهيونيّ طوال عقود تأسيس الكيان الموقت بين دخول اللنبي إلى القدس والحرب العربيّة الإسرائيلية الأولى 1947-1949، وأصبحت بحكم هيمنة الغرب على صناعة المعرفة والإعلام في العالم بمثابة الانطباع المقبول عن حالة فلسطين، بينما كان البريطانيون، بمحض القوّة الفاجرة، يمكّنون المهاجرين اليهود فيها تحضيراً لقيام دولتهم العبريّة، فيما لم يكن للفلسطينيين لا القدرة ولا الأدوات على دحض المزاعم الصهيونيّة، لا على مستوى المعرفة الأكاديمية، ولا في حيّز الإعلام.
من هذه النقطة المفصل في الحكاية الفلسطينية تأتي أهميّة كتاب «صور فلسطين 1898 – 1946» الذي يعتبر أهم وثيقة تاريخيّة مصورة تتوافر لنا، من أجل نفي تلك المعادلة الصهيونيّة الفاسدة. فهنا، ولنصف قرن قبل إعلان قيام الكيان الموقت في عام 1948، تتوافر عشرات المشاهد الفوتوغرافيّة المحترفة بالأسود والأبيض، عن هذي الأرض وناسها: مزاجها الطوبوغرافي، وحياة سكانها بين المدائن والأرياف والمضارب، ومعالم تطوّر أدواته المجتمعيّة في التعليم والصحة والعمارة والتجارة والإعلام والفنون، ونضاله الوطنيّ الباكر سعياً للتحرر والاستقلال، كما بورتريهات لوجوه نبتت من فلسطين وعادت إليها. لمجموعة الصّور في الكتاب قصتان لا بدّ من سردهما. الأولى عمّن التقط تلك اللوحات المبهرة.
لقد كانت نتاج قسم تخصّص في التصوير الفوتوغرافي في إطار جمعيّة «الأميركان كولوني»، وهو تنظيم يوتوبي مسيحي أميركيّ يؤمن بعودة ثانية للمسيح، تأسّس في مدينة القدس عام 1881 وكان قد شرّع في توثيق فوتوغرافيّ للأرض «المقدسّة» اعتباراً من عام 1890. وعندما توقّف هذا القسم عن نشاطه في الأربعينيّات من القرن الماضي، استكمله أحد أعضاء التجمع، جورج إريك ماتسون الذي أسّس مع زوجته إيديث مكتب خدمات تصوير فوتوغرافي أنتج مجموعة من أهم الصور الفوتوغرافيّة عن فلسطين في تلك المرحلة. والمفارقة هنا أنّ هذا النشاط التوثيقي المذهل لم يهدف إلى تسجيل تطور المجتمع الفلسطيني في مرحلة ما بعد الاستعمار العثماني بقدر ما كان ذا دوافع دينية ذات نفس استشراقيّ ظاهر.
أمّا الثانية، فهي مصير تلك الصور، إذ نقلت نيغاتيفات أكثر من ثلاثة وعشرين ألفاً من الصور التي التقطتها جمعيّة «الأميركان كولوني» ومكتب ماتسون إلى مكتبة الكونغرس الأميركي في عام 1966، إذ تحوّل جميعها إلى نسخ رقميّة، ما سمح لمجموعة من محبّي فلسطين في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، أطلقوا على أنفسهم اسم مشروع «كرامة»، باختيار مجموعة منها، وإعدادها للنشر في كتاب فاخر بعد تنقيح أوصافها وتصحيح الأخطاء فيها. ويشير الإهداء إلى دور بارز في تلك العمليّة للمناضلة الأميركيّة ستيفاني جينينغ التي وافتها المنيّة قبل أن ترى ثمرة جهودها النبيلة.
ومع أنّ نسخ الطبعة الأولى كانت قد نفدت بالكامل، إلا أنّ الحرب الإسرائيليّة على غزّة والوعي المستجد بين الأميركيين ـــ والعرب الأميركيين أيضاً ـــ بالقضيّة الفلسطينية، دفع مجلس أمناء مشروع «كرامة» إلى اتخاذ قرار بإصدار طبعة ثانية من «صور فلسطين». ولعلها فرصة هنا لأشكر صديقي الفلسطيني العريق يوسف أبو ديّة، أحد القائمين على مشروع «كرامة»، الذي تفضّل عليّ بنسخة من الكتاب اعتبرها من أثمن ما أمتلك، إن لم يكن أثمنها على الإطلاق، وستكون ميراثي من بعدي لأولادي. إنّ هذي الأرض التي كانت تدعى فلسطين، وصارت تدعى فلسطين، كانت أيضاً شعباً كان يدعى الشعب العربي الفلسطيني، وصار يدعى الشعب العربي الفلسطيني.
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن