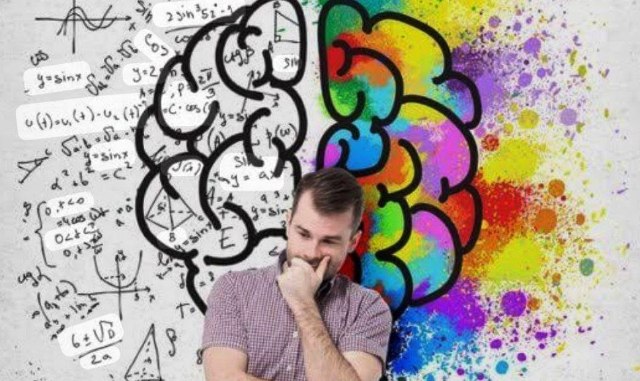عبد المنعم علي عيسى
قد يكون من نافل القول إن الساحة السياسية الأميركية تصبح، مع دخولها «العام الانتخابي»، مفرِّخة للكثير من الظواهر التي تتفاوت في طبيعتها وحدّتها، تبعاً لمعطيات الداخل والخارج على حد سواء. ولربما لا يخرج ذلك عن الحدود الطبيعية، من حيث أن الساكن الجديد للبيت الأبيض سوف يكون ممسكاً بعصا قوة هي الأعتى في ما شهده التاريخ حتى الآن. والظواهر إياها كثيراً ما تصبح محطّ أنظار العالم ومتابعيه الذين يتوجّب عليهم قراءتها، ثم استشراف المآلات التي يمكن أن تصير إليها. والشاهد هنا هو أن تلك الظواهر راحت تتنامى مع صعود القوة الأميركية في زمن القطبية الثنائية، وتتسارع أكثر في زمن انفرادها بالسيطرة العالمية، ولكن ما بلغته هذا العام كان مشوّقاً بدرجة لافتة تفوّقت على الأفلام التي تنتجها «هوليوود» التي لعبت على امتداد قرن، أو يزيد، دور «المفرخة» للأفلام المشوّقة التي غزت الذهنية والمزاج العالميين، وصولاً إلى فيلم «أميركا 2024» الذي بدا الأكثر تشويقاً، بل لربما سيكون من نتائجه المتحصّلة حتى الآن، أو التي سوف تتراكم، أن يحيل الكثير من أفلام «هوليوود»، بما فيها التي حظيت بالأوسكار، إلى التقاعد.تشرح شبكة «إن بي سي» الأميركية، في تقرير لها نشرته الإثنين المنصرم، كواليس اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان الرئيس، جو بايدن، انسحابه من السباق الانتخابي، فتقول إنه كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله على ساحل ولاية دويلاوير، ومعه زوجته وبعض المستشارين المقربين فحسب، وفي مساء ذلك اليوم، فكّر في أنه آن لمسيرته السياسية أن تنتهي. ويضيف التقرير أن «ذلك التفكير كان ناجماً عن العزلة والإحباط والغضب والشعور بخيانة الحلفاء»، ثم يتابع: «وبعد نصف ساعة استخدم بايدن موقع X للكشف عن قراره القاضي بالانسحاب من الترشح والبقاء في منصبه كرئيس». والمؤكد هو أن هذه السردية تصح لأن تصبح سيناريو مشوّقاً؛ ولربما لو جرى عرضه بحرفيته على «هوليوود»، لكان الأكثر إثارة من بين ما عرضته هذه الأخيرة منذ زمن، إذ هل يعقل أن يُتّخذ قرار كهذا، يمثل أحد القرارات التاريخية في السياسة الأميركية من دون شك، بهذه البساطة، خصوصاً أن القائم بالفعل كان قد وعد، إبان حملته الانتخابية عام 2020، بأن يكون «الجسر للجيل التالي»، ولكنه بقراره يخاطر بأن يغدو «جسراً» ما بين ولايتين لخصمه دونالد ترامب.
فيلم «أميركا 2024» بدا الأكثر تشويقاً وقد يحيل الكثير من أفلام «هوليوود» للتقاعد
على الضفة الأخرى، ضفة ترامب، لم تكن السيناريوات أقل «هوليوودية» من الأولى، فبعيد تلقي أذن الأخير رصاصة توماس كروكس في 13 تموز الجاري، انتفض مطلقاً صيحته الشهيرة «القتال… القتال… القتال». كان ذلك مشهداً لا يقل إثارة ولا تشويقاً عن مشاهد الممثل سيلفستر ستالوني، الذائع الصيت في هذا المجال. والراجح هنا أن العمل جار، ما بعد محاولة اغتياله، على تحويل الأول إلى زعيم «هوليوودي» بمرتبة «سوبر»، تجاوزاً لما احتوته الذاكرة لفيلم قديم لم تشر أرقام «شباك التذاكر» إلى نجاحه. ففي 6 كانون الثاني 2021 أدار «المخرج» ترامب عدسة كاميراه صوب «الكابيتول» لتصوير مشهد إسقاط هذا الأخير بوصفه مؤسسة «لم تعد تحظى بالصدقية»، وفقاًَ لما قاله قبل أيام من «التصوير». وهو كرّر مراراً في ما بعد القول إنه «لن يعترف بالهزيمة إذا خسر نتائج انتخابات 2024». والقول يعني بوضوح أن «الديموقراطية» لا قيمة لها إذا ما عاندت رياحها سفنه المقلعة صوب «مجد أميركا»، وفقاً لما يتصوره.
عانى الكيان الأميركي منذ الإعلان عن ولادته عام 1776 جملة من التناقضات والصراعات، لعل أبرزها الصراع بين الذات والآخر، وبين الإنسان والله، ثم بين الأسود والأبيض، وصولاً إلى التناقض الأخير القائم ما بين الإنسانية (تمجيد الإنسان) والرأسمالية (تمجيد المنفعة كأساس لعملية التطور)، الأمر الذي يمكن لحظ طغيان مؤثراته بدرجة فاقعة في أتون العدوان الإسرائيلي الدائر على غزة منذ نحو عشرة أشهر. وما أثبتته تظاهرات الجامعات الأميركية، يقول إن ثمة شرائح مجتمعية وازنة لا تزال ترى أن طغيان قيم الرأسمالية المتوحّشة من شأنه أن يهدّد مسار الحضارة الأميركية ويهوي بها إلى قيعان سحيقة، في حين ظلّت مؤسسات الحكم والمعارضة على حد سواء عند توافقاتها على وجوب دعم «النجمة» الأميركية الواحدة والخمسين، تلك المنزرعة بين ظهراني المنطقة.
هذه الصراعات في مجملها لم تُحسم، بل ظلت عقابيلها تتفاعل، وتتراكم أنى سمحت الفراغات المجتمعية التي راحت تتكاثر على خلفية الحمولات التي فرضتها شعارات فضفاضة تقول بـ«ريادة» أميركا للعالم. ومع أحداث 11 سبتمبر 2001، وما تبعها من مراسيم وقرارات كان بعض بلدان العالم الثالث يخجل منها، بدا أن القرار ماضٍ نحو وضع تلك التناقضات في «مصهرة» جديدة، لعل الفعل ينُتج مزيجاً جديداً قادراً على أن يشكل رافعة لذلك الشعار «الطموح» الذي غاب كثير من موجباته. ولعل هذه المناخات هي التي قادت إلى تنامي التيار «الشعبوي» الذي يقول بضرورة تبني شعارات تناغي الذات المجتمعية، من دون التفكير في واقعيتها. والمؤكد هو أن «الترامبية» التي مثّلت الابن الشرعي لهذا التيار الأخير، هي التي أدت، ولسوف تؤدي، إلى ذوبان الحدود ما بين الواقع وشطحات الخيال، حتى ليكاد الجمهور يكون غير مدرك لما إذا كان ما يراه حقيقة، أم أن «هوليوود» اتسعت لتشمل حدودها أرجاء بلاد العم سام من أقصاها إلى أقصاها.
سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن