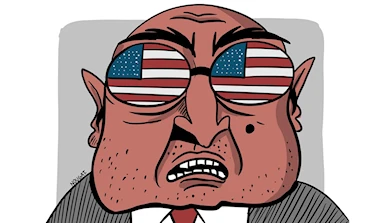شفيق طبارة
يوثّق «فلسطين 36» لآن ماري جاسر بدايات الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني عبر سرد تاريخي واسع وشخصيات متعددة. فيلم طموح بصرياً وتعليمي الإيقاع، يكشف مسؤولية بريطانيا في تشريع المشروع الصهيوني، ويقدّم معرفةً مكثّفةً بالتاريخ أكثر مما يقدّم دراما تهزّ الوجدان
لم يبدأ كلّ شيء مع خطة دونالد ترامب حول غزّة، ولا في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ولا مع اتفاقيات أوسلو، ولا مع هزيمة 1967، ولا حتى مع نكبة 1948: الجذور أعمق بكثير.
قراءتان متوازيتان للتاريخ
من هناك يبدأ فيلم «فلسطين 36»، من تلك اللحظة الأولى التي أُهين فيها أول فلسطيني على يد الجيش البريطاني والميليشيات الصهيونية، في بيته أو بين أشجار الزيتون، هناك بدأ كلّ شيء. لكن الفيلم لا يكتفي باستعادة هذا الجذر التاريخي، بل يضعنا أمام قراءتين متوازيتين: ما يقوله وكيف يقوله.
على مستوى المحتوى، نحن أمام سردية تستعيد ثورة الفلسطينيين ضد الاستعمار البريطاني، في لحظة تاريخية ازدادت توتراً مع وصول الموجات الأولى من المستوطنين اليهود من أوروبا. الفيلم الذي يمثّل فلسطين في أوسكار 2026 عن أفضل فيلم دولي، يغوص في ثورات المزارعين وعمّال المرفأ، ودور الصحافيين والطبقة المخمليّة والقمع البريطاني، ويثريها بمادة أرشيفية آسرة، توثّق ما سُلب. لكن على مستوى الأسلوب، المفارقة صارخة. يُقدّم العمل نفسه عبر إنتاج ضخم، كأنّه يوحي بأن قيمته تُقاس بالزخارف الشكلية أكثر مما تُقاس بوعي الأسلوب السينمائي. النتيجة: عمل ضخم، مؤثر، لكنه يسير بإيقاع مدرسي، ويقدّم شخصيات أقرب إلى شواهد حجرية منها إلى بشر يتوهجون.
تكتيك الاستعمار و… المقاومة
في فيلمها الجديد، تتجه المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر («ملح هذا البحر»/ 2008 ــــ «لمّا شفتك» / 2012، و«واجب»/2017)، إلى الأرشيف والنسيج الاجتماعي الفلسطيني، مستحضرة تكتيكات الاستعمار والمقاومة قبل «الثورة الفلسطينية الكبرى» (1936 – 1939) وخلالها. لا تقتصر الحكاية على عائلة واحدة، بل تنفتح على طيف واسع من الشخصيات، تُوظَّف كجنود مشاة في سرد يلتقط نوبات الصدمة والتمرّد، المتقاطعة مع صور أرشيفية. وهكذا يرسم الفيلم السنوات الأولى من الثورة التي قادها الفلاحون والعمّال.
يُمنح الفيلم حقّ التنقّل في فلسطين، حيث كلّ حقل يشتعل، وكلّ يتيم ينمو وهو يشهد انفجاراً، وكلّ فصل من الحكاية يُعلن بكلمات.
جيريمي آيرونز في الفيلم
جيريمي آيرونز في الفيلم
يأتي العنوان الفرعي الأول، المؤرخ في آذار (مارس) 1936، كجملة مثقلة بالهزيمة: «سنة مهدك». تُظهر لقطات الأرشيف كيف بدأ آلاف اليهود الأوروبيين بالهجرة إلى فلسطين. في تلك السنة، يجد يوسف (كريم عناية) نفسه متأرجحاً بين طبقات اجتماعية مختلفة. هو من قرية البسمة، والده المزارع المسنّ بحاجة إليه، بسبب بدء مصادرة الأراضي والقرى المجاورة، لكنه يعمل سائقاً لزوجين ثريين هما المحرر الصحافي أمير (ظافر العابدين)، وزوجته الصحافية الكاريزمية خلود (ياسمين المصري) التي تستخدم اسماً مستعاراً لكتابة مقالاتها المناهضة للاستعمار.
غير أن الحكاية لا تقتصر على يوسف وحده؛ فقرية البسمة تحتضن شخصيات أخرى مثل حنان (هيام عبّاس)، وأبو رباب (كامل الباشا)، وعفرة، والكاهن الأرثوذكسي بولس (جلال الطويل) وابنه كريم. لم يكن أيّ منهم ميالاً للعنف أو المواجهة، لكنهم وجدوا أنفسهم جميعاً منخرطين في دوامة الاضطهادات التي فرضتها الحماية البريطانية، مدعومة بالميليشيات الصهيونية التي شكّلت عماد النهب والاستعمار.
الثورة هي المتنفّس
يأخذنا العنوان الثاني إلى ميناء حيفا، ليعنون «الثورة هي المتنفّس»، حيث يتحول عامل يدعى خالد (صالح بكري) بسرعة إلى ثائر بعد تعرّضه للضرب عندما طالب بأجور العمل الإضافي، وقد كانت أقل من تلك التي تُدفع للعمَّال اليهود الوافدين حديثاً.
«يا خبز يا رصاص» يقول خالد، لتتوالى العناوين والفصول، «أخذ وعطا»، و«ترنيمة العودة»، و«لا تصدق أن الإنسان ينمو». يبدأ الإضراب وينتهي، فيما تتجلى لجنة بيل بدور أشبه بالإله، تصدر وصية التقسيم التي يتردد صداها بشكل محطّم.
ومع انطلاق الثورة، تختفي العناوين الفرعية، لتصوّر جاسر الاعتقالات والخيانات وحرب العصابات، بينما نكتشف الشخصيات البريطانية وهي تمارس حركاتها القمعية بوضوح، فسكرتير المفوّض السامي (بيلي هاول) يواجه معضلة أخلاقية، بينما يتلاعب المفوّض السامي البريطاني (جيريمي آيرونز) بالكلمات والسياسة عبر الإيحاء بأنّ للعرب تاريخاً من التنازلات، ويظهر تيغارد (ليام كانينغهام) كمسؤول عسكري أُرسل إلى فلسطين لوضع استراتيجية لقمع الانتفاضة، ومعه الكابتن وينغايت (روبرت أرامايو) المكلّف بحملة القمع في القرى.
تتباين الشخصيات بين من يعبّر عن عنصرية صريحة ومن يبدي تعاطفاً محدوداً مع الفلسطينيين، لكنها جميعاً تبقى مرتبطة بأسباب الدولة والتاج، بوصفها أدوات أرسلتها المملكة المتحدة لدعم وتشجيع وحماية وشرعنة المشروع الصهيوني في فلسطين.
استحضار تكتيكات الاستعمار والمقاومة قبل «الثورة الفلسطينية الكبرى»
إيرلندا أخرى!
يضع الفيلم في واجهة السرد جملة بريطانية شهيرة آنذاك: «لا نريد إيرلندا أخرى بين أيدينا»، إذ عبّرت الإدارة البريطانية عن خشيتها من أن تتحوّل تجربتها في فلسطين إلى مأزق طويل ومعقّد شبيه بتاريخها في إيرلندا. لكن الفيلم يوضّح أنه عبر لجنة بيل لتقسيم فلسطين، منح البريطانيون الضوء الأخضر لإنشاء دولة قومية يهودية، ما شرّع مصادرة القرى الفلسطينية وقمع انتفاضات السكان بعنف. كما سمحت الإدارة البريطانية للصهيونية بالتغلغل في المجتمع الفلسطيني عبر تمويل الدعاية، وإحياء جمعيات إسلامية صورية (مثل جمعية أمير) مارست الاسترضاء، وشراء ولاءات من بعض النخب الثرية بوعود كاذبة، مستندة إلى خطاب عن «الكرم العربي» لتبرير سياسات الاستعمار والنهب، بينما كانت النوايا الصهيونية واضحة منذ البداية، مُعلنة بوضوح في قوانينها وفي أسماء جمعيات مثل «اللجنة الصهيونية المعنية بفلسطين» و«جمعية الاستعمار اليهودية الفلسطينية».
بريطانيا أصل العلّة
كل ما سبق يرد في فيلم يمتد قرابة الساعتين، عمل طموح بلا شك، يحمل نوايا ملحمية، لكن الشكل الذي قُدّم به بدا متزعزعاً، ما أضعف الاهتمام بالشخصيات وبالقصة. يتوه السرد بين اللقطات الواسعة، والشخصيات، والميلودراما. يحتوي الفيلم على مشاهد درامية عدة تُظهر الذل والطريقة التي عامل بها البريطانيون الفلسطينيين، الذين رأوا ممتلكاتهم تُنتزع منهم ببطء لكن بثبات. غير أنّ هذه المشاهد لم تؤدِّ دورها كاملاً، لأنّنا منذ البداية لم نُمنح فرصة للتفاعل مع الشخصيات.
ببساطة، لم يُعط الفيلم الوقت الكافي لتطويرها. بدا كأنّ الاهتمام انصبّ على تجميع أكبر عدد من الشخصيات بدلاً من التركيز على بعضها وتعميقها، فجاءت الشخصيات مبتورة وغير مكتملة.
يحمل الفيلم فضلاً كبيراً في تعريف الجمهور بالمراحل التي سبقت تأسيس «إسرائيل» كدولة، وما رافقها من ظلم تاريخي. تكمن قيمته في كشفه المباشر للمسؤولية الأساسية التي اضطلع بها الانتداب البريطاني، مجسّداً ذلك عبر صورة رجاله الذين يظهرون في أقصى درجات الانحطاط، كرمزٍ للإمبريالية والاستعمار الذي مورس ضد الفلسطينيين.
البُعد الطبقي حاضر أيضاً
لا تغفل جاسر أيضاً عن البُعد الطبقي، مبيّنة كيف أن الشرائح العربية الأكثر ثراءً لم تُبدِ معارضة تُذكر، بل رأت في الأحداث فرصاً محتملة للتوسع الاقتصادي.
اللافت أن «فلسطين 36» يخلو تقريباً من شخصيات يهودية، باستثناء بعض الوجوه الخلفية، إذ تشير جاسر بوضوح إلى أن البريطانيين هم الذين تولّوا تنفيذ المشروع الصهيوني. أما الإسرائيليون، فيبقون دائماً في الخلفية، بعيدين من الأنظار، أشبه بكائنات غريبة تختبئ خلف الجدران والأبراج والأسلاك الشائكة.
«فلسطين 36» عمل جيد، صُنع بيد تعرف كيف تُنجز سينما، لكنه وقع في فخ كثرة الشخصيات، ما صعّب عملية التعلّق بها عاطفياً.
لو اكتفى بالتركيز على شخصيتين أساسيتين، لكان أكثر تأثيراً، ومع ذلك يبقى فيلماً مهماً وجديراً بالمشاهدة. يحمل نفساً تثقيفياً بطابع عتيق، يسير بإيقاع ثابت غالباً ما يميل إلى البطء، واضعاً المشاهد أمام ثقل المرحلة التاريخية أكثر مما يضعه أمام دراما الشخصيات. إنه سينما تاريخية ومدنية، لكنه في جوهره يتخذ منحى إيضاحياً.
«فلسطين 36» يعلّمنا التاريخ أكثر مما يحرّكنا وجدانياً، يترك أثره في العقل لا القلب، وهذا ما يجعله مهماً بقدر ما يجعله ناقصاً
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن