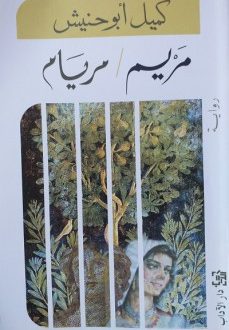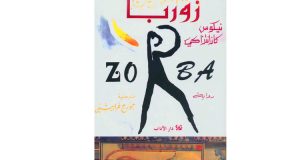يطل علينا الأديب الأسير كميل أو حنيش بروايته مريم مريام بما تحمله من إربكات وطروحات فكرية وسياسية اقل ما يقال فيها أنّها مثيرة للجدل. حاول الكاتب من خلالها التعرض لمسائل اللجوء والنكبة والحلول المقترحة او المتخيّلة لحل معضلة الشعب الفلسطيني وذهب أبعد من ذلك إلى حد طرح تساؤل حول إمكانية او قابلية التعايش المشترك بين الشعبين او بين العرب واليهود.
ينطلق الكاتب في روايته من بلدة صفُّوريّة التي تعرضت للقصف بالطائرات وتم تهجير أهلها بالكامل لجأ البعض منهم إلى شمال الناصرة وأقاموا في حيّ خاص بهم عرف بحي الصفافرة.
الرواية تعتمد أساسا على مريمتين مريم الفلسطينية العربية ومريام اليهودية الأوروبية، وقد عمد الكاتب ولسبب ما إلى إبراز أوجه التشابه في العذابات والمعاناة لكل منهما،. مريم العربية عاشت أحداث النكبة وشهدت على دمار بلدتها صفُّوريّة وقصفها بالطائرات وتهجير أهلها، وكذلك مريام اليهودية شهدت أحداث المحرقة وأسهبت في وصفها وما لاقاه اليهود من عمليات تصفية في معسكر أوشفيتز النازي، وكما أنّ مريم العربية قتل زوجها محمود على أيدي العصابات الصهيونية ،كذلك فإن مريام فقدت زوجها آدم قتيلا في مواجهة الفدائيين الفلسطينيين، هذا التشابه ولو بشكل نسبي بين مأساة كل منهما كأن المُراد منه الولوج إلى فكرة التسامح والتلاقي لذا كان المدخل لهذا الطرح هو الزواج الذي حصل بين إلياس ابن مريّم العربية وبين شلوميت ابنة مريام اليهودية وكان من ثمرة هذا الزواج ولادة ابنهما ابراهيم أو أبرا . ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أنّه رغم التشابه الظاهر في ظروف هاتين المرأتين إلاّ أن هناك فرقا كبيرا بين ما انتهت إليه الأمور، فمريم العربيّة تحولت من مواطنة إلى لاجئة في بلدها غائبة حاضرة كما يقال، في حين أنّ مريام تحولت من شريدة أوروبية إلى مستوطنة ومغتصبة لبيت مريم في فلسطين.
بالعودة إلى زواج الياس وشلوميت والذي اعتبر بمثابة الحل وجسر التواصل وبداية التصالح بين الشعبين، فإنّ هذا الزواج برمزيته يشكل حلا فرديا ولا يمكن التعويل عليه بالرغم من الإيحاءات السياسية التي حملها لكنه أثبت عدم جدواه وعدم قابليته ليكون الحل المنشود بدليل انهما عاشا في عزلة تامة عن الجميع ولم يلتفتا إلى ما يجري من تطورات سياسية واكثر من ذلك أنجبا ابراهيم الذي عاش طفولة معطوبة تملأها التشوهات ويعوزها الإنتساب الحقيقي، وعانى طويلا من عقدة تعدد الهويات.فالبعض من أفراد أسرته بشقيَّها العربي واليهودي يعمل على تعريبه والبعض الآخر يجهد على تهويده.
لقد أبدع الكاتب في وصف المكان وخاصة بلدة صفُّوريَّة التي هي أجمل مكان في العالم، وتتربَّعُ فوق سفح جبلٍ، تلالها مكتظَّة بأشجار السَّرو والصنوبر والبلُّوط والتين والزيتون. تطالعك الناصرة من جهة الجنوب ومن الشمال تجد ديرٌ للقدِّيسة حنَّا وفي رأس البلدة تشمخ قرية ظاهر العمر. وكذلك عين الماء وشجرة التين العسالي والتي هي برأيي إحدى شخصيات الرواية.كما يذكرنا الكاتب ببعض ما تجود به البراري والجبال مثل الزعرور، التوت البرِّي، الزعتر، النرجس والحُميّض وغيرها من النباتات والأزهار.
تطرح الرواية فكرة الانتماء الإنساني وتقدّمُه على بقية الإنتماءات المتعددة كما قال عيسى أبو سريع : “إنّ الانتماءات العرقيَّة والدينيّة والقوميّة والطائفيّة ليست هي الاساس،إنّها انتماءات زائفة متخيَّلة وتحجب الهويّة الإنسانيَّة المشتركة للبشر، أمَّا الانتماء الإنساني فهو الانتماء الأرقى والأعمق والأكثر صدقاً وانسجاماً مع النفس البشريَّة”.
انطلاقا من هذه النظرة حول البعد الانساني وسموه، يمكن اعتبارالهوية بأنّها انتماء إنساني وأخلاقي ووجداني قبل كل شيء، أمّا الوطن فهو المسألة الثقافية والأخلاقية وهو الانحياز للهويّة الإنسانيَّة وللحب والعدل،وكما يقول تشي غيفارا “أينما وُجد الظلم فذاك موطني”.
هذه النظرة الإنسانية والدعوة إلى الانتماء الإنساني تبدو في جوهرها دعوة راقية تستحق التوقف عندها، ولكن يبقى السؤال هل يستطيع الإسرائيلي أن يرتقي إلى هذه الدعوة وأن يتخلى عن عنصريته وجبروته ويعود إلى إنسانيته المفقودة، ويتوقف عن إقتلاع البشر والحجر من جذورهم وأيضا عن إقتلاع الشجر كما فعل بحناس عندما اقتلع شجرة التين العسالي رغبة منه في قطع كل ذكرى وأمل لمريم بهذه الأرض . الإجابة على هذا السؤال أظنها معروفة سلفا ولكن لا بد من طرحه.
وفي سعيّه لتوضيح الفكرة والعودة إلى الجذور الموحِدة فقد أحسن الكاتب في اخيار الأسماء وتوظيف معانيها في خدمة تلك الفكرة، مريم ومريام هما في الأصل واحد ويؤديان نفس المعنى الكنعاني القديم الذي هو نتيجة زواج الإله مُر بالآلهة يّم فنشأ اسم مريم أو مريام، وأيضا إنّ اعتماد هذين الإسمين في الرواية فيه محاولة ربط غسم مريم بالتوحيد بين الديانات من خلال الإشارة إلى مريم الممتلئة بنعمة الربّ ومباركة ثمرة بطنها يسوع الناصري والتي خصّها القرآن الكريم بسورة من سوره. وكذلك جاء اختيار اسم ابراهيم وهو ثمرة زواج العربي من اليهودية دلالة أيضا على ان الشعبين يعودان في الأصل إلى جدّ واحد هو نبيينا إبراهيم. ناهيك عن تسمية زوجة الياس بشلوميت بمعنى السلام. كما قدمت الرواية شرحا مفصلا عن تاريخ اليهودية الصحيح وليس كما ورد في إدعاءاتهم.
قدّم لنا الكاتب بعضا من الحلول المطروحة سابقاً وحاليا لحل القضية، ومنها ما طرحته مريام على مريم بأن تعيد لها بيتها او تمنحها التعويض الملائم، هذا الطرح أقل ما يقال فيه أنّه طرح مفخخ وهو إشارة بشكل أو بآخر إلى ما طُرح ويُطرح في بعض المنتديات بمعنى عودة مجتزأة ومنقوصة لبعض من تم تهجيرهم وتقطيع لأواصر النسيج الفلسطيني بحيث يعود الأصل وتمنع العودة على الفروع الذين سيبقون في أرض الشتات والمخيمات. لهذا كان رفض مريم لهذا الطرح حاسما جازماً.
واضح للجميع أنّ الرواية تتحدث عن أجيال ثلاثة، جيل مريم ومريام وجيل الياس وشلوميت وأخيرا جيل ابراهيم وعنّات.
لو أردنا التوغل في تحليل شخصيات هذه الأجيال ومن الجانب الفلسطيني تحديدا نجد ان جيل الأجداد المتمثل بالجدَّة مريّم، هو الجيل الأكثر إخلاصاً والتصاقاً بالأرض والقضية، تحدثنا الرواية كيف أن مريم جمعت ما في حوزتها من حليّ ذهبيَّة ووضعتُها في كفّ محمود، وقالت له بحسم: بِعْها واشترِ بثمنها بارودة. وهنا يبرز دور المرأة الفلسطينية المجاهدة والمُضَحيّة بكل ما تملك في سبيل العزة والكرامة، وأيضا تُبرز الرواية تعلق هذا الجيل جيل مريم بحق العودة والأمل بتحقيق هذا الحلم، لذا كان ما يشبه البروفة للعودة تمثلت في رحلة الربيع التي أقامتها مريم مع بقية النسوة للإطلالة على مشارف وتلال صفُّوريّة وعادت من هناك بشتلة من شجرة التين العسالي لتزرعها في احواض الزرع في حي الصفافرة لتبقى الشاهد والشهيد على بقاء القضية حيّة في الوجدان. بالرغم من الفارق الكبير بين هذه الشتلة وتلك التينة، فهذه التينة هي الأصل أمّا هذه الشتلة فهي الفرع ، التينة عنوان صمود لا تنفك تقاوم أمّا الشتلة فهي عنوان استسلام ولاجئة في حوض الزرع في حي الصفافرة كبقية اللاجئين.
أيضا فإن الجدّة مريّم تمتعت بمنسوب عالٍ من الوعيّ والثقافة السياسية لمدوامتها على تتبع نشرات الأخبار، وهي التي أصرّت على المشاركة في المظاهرات المنددة بالاحتلال ولم تنخدع يوما بالسلام المزعوم الذي أنتجته معاهدة أوسلو وكان تعليقها الأشد بلاغة وإيلاما: “اليوم فقط أدرك أنّي لن أعود إطلاقاً إلى صفُّوريّة؛ لقد تهاوى الحلم الكبير بعد أن أصبحت فلسطين هي الضفَّة وغزَّة فقط وهذا يعني أنَّنا بتنا خارج الحسابات.”. وكانت مؤمنة بمقولة ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة وبأن بالعودة الى البلدات والبيوت تحتاج إلى حرب.
ولإثبات أحقيتها بهذه الأرض وبأن مريام مجرد طارئة ودخيلة على فلسطين جاءت من أقاصي الدنيا لتحتلَّ مكان مريم وتقيم سعادتها فوق حطامها وحطام أهلها تطلب مريم من حفيدها إبراهيم أن يسأل جدّته اليهودية مريام هل جرَّبت أن تقيم علاقة مع الطبيعة من حولها؟ هل تعرف ما ينبت في جبال القريّة؟ وهل باستطاعتها أن تسمّي نوعاً واحداً من أنواع النباتات والأشجار البريَّة؟.
وفيما يشبه إحدى سيناريوهات المفاوضات التي تصل دائما إلى الطريق المسدود، تبرز الرواية ما قام به ابراهيم من نقل رسائل تفاوضية بين جدتيّه العربية واليهودية للتوصل إلى نوع من التسامح والغفران والتعايش المشترك وفي هذا الشأن تسأل مريم ماذا خسرت مريام بسببي لكي تسامحني او تغفر لي ؟ ستقول لي إنّها خسرت زوجاً كان يقاتل الفدائيين الذين هجَّرهم من ديارهم؟ هل نحن من قتلنا أهلها وتسببنا في المحرقة؟ وهل هي على استعداد أن تخلي مكانها وتعيد لي بيتي مقابل التسامح والغفران؟. ليأتيها الجواب بلسان مريام معترفة بأحقية مريم بالبيت ولكن أين سأذهب بعد ذلك، هل أغادر بيتي لأغدو لاجئة، وبمنطق المنتصر المتعجرف تقول إنّها الحرب، والعرب هم من اختاروا الحرب فليتحملوا نتائجها، والمنتصر هو من يقرر مصير المهزوم.
الجيل الثاني الذي تحدثت عنه الرواية وهو جيل الأبناء وقد برزت منه فئة تدعو للتعايش والتسامح ونبذ الخلافات تمثل بكل من الياس وزوجته شلوميت، فئة يمكن القول عنها أنّها ارتضت الأمر الواقع والتطبيع الكامل ونأت بنفسها عن كل الصراعات السياسية والإيدلوجية دون أن تبذل أي مجهود او تطالب بحق.
أمّا الجيل الثالث فهو جيل الأحفاد، ومنه كان ابراهيم أو أبرا ضائعا بين انتمائين وهويتين عربية ويهودية وفي هذا إشارة ولو خفية إلى المخاطر التي تهدد الهوية الحقيقية للشعب الفلسطيني إذا ما جرى التمادي او التغاضي عن الخصوصيات الضامنة لهذه الهوية.
ختاما نقول هذه الرواية رواية سياسية وفكرية بامتياز حاولت البحث عن حل لمسألة الصراع القائم والأمل بمجيء يوم تستعاد فيه الحقوق والأرض، يوما يراه المحتل بعيدا ونراه قريباً بهمّة وسواعد الأبطال والمجاهدين.
سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن