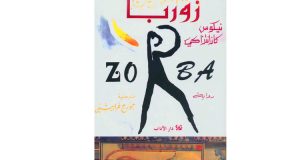تقديم وتحليل الدكتور خلف الجراد
هناك مقولة لأحد فلاسفة التاريخ مفادها: ” من لا يعرف تاريخ أرضه التي يعيش بين جنباتها.. لن يعرف حقيقة حاضره، وسيكون بعيداً تماماً عن سماع نبضها, بل وغير قادر على رؤية مستقبل هذه الأرض، أو التنبؤ بما ينتظرها من أحداث وتغيرات وتحولات”.
لقد استذكرت هذه المقولة الفلسفية الدقيقة والعميقة فور صدور الجزء الأول من كتاب السيدة الدكتورة نجاح العطار (أيام عشناها وهي الآن للتاريخ)، منذ أيام قليلة ضمن منشورات “الهيئة العامة السورية للكتاب”.
والحقيقة أنّ مؤلفة هذا العمل الفكري- الأدبي- التاريخي الماتع – وقبل أن تكون نائباً لرئيس الجمهورية العربية السورية من تاريخ 23 آذار 2006، وأوّل سيّدة عربية تصل إلى هذه المسؤولية الوطنية الرفيعة- هي أديبة وكاتبة ولغوية وباحثة معروفة، وهي التي ارتبط اسمها بإنجازات مهمة جداً في وزارة الثقافة مذ كانت في مديرية التأليف والترجمة، وبخاصّة عند توليها شؤون هذه الوزارة في العام 1976(حيث بقيت وزيرة لها حتى عام 2000)؛ فشهدت تلك المرحلة المفصلية من عمل الوزارة: اكتشاف آثار حضارة “إيبلا” التي دحضت كثيراً من تزييفات القراءات والتحليلات الاستشراقية المتصهينة بشأن تاريخ سورية والمنطقة العربية، وإقامة مجموعة من الندوات العلمية – التاريخية لعدد من العلماء الآثاريين المتخصصين، والمساهمة في إطلاق أوّل مشروع لإنشاء متحف الفنون في سورية، والإشراف على إنجاز بناء المعهد العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للموسيقى، والمكتبة الوطنية العامة (مكتبة الأسد) ودار الأوبرا، بالإضافة إلى إقامة علاقات ثقافية متميزة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية وغيرهما من الدول والشعوب الصديقة ذات الثقافات العريقة المتنوعة.
وللسيدة الدكتورة نجاح العطّار كما يعرف القرّاء الأكارم عشرات المؤلفات الثقافية والفكرية وفي الأدب السياسي، ومئات المقالات التي سطرها قلمها المبدع على مدى نصف قرن من الكتابة والمتابعة المباشرة لشؤون الوطن وقضاياه المختلفة.
وبالعودة إلى كتابها الجديد موضوع العرض والقراءة, فهي تصدّره بإهداء أو إجلال “للراحل الكبير حافظ الأسد القائد الذي صنع التاريخ، وإلى الرئيس بشار الأسد، الباسل في مواقفه، والصادق في تضحياته، والفريد المتفرد في قيادته”.
والكتاب – كما تقول مؤلفته – نثار من مقالات كتبتها من النصف الثاني من السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات، حيث رأت أنه من المفيد إعادة نشرها لما حملته من نذر الحاضر، ومن ملامح مؤامرة ومخططات تجلّت بوضوح وجلاء في العقود والسنوات اللاحقة.
فهي تردّ بقوة على بعض الأقلام المتخاذلة اليائسة التي تزعم أن أمتنا لا تجيد سوى الكلام، وردّها المدوّي يأتي من خلال استلهامها الصادق لبطولات حرب تشرين المجيدة (1973).
وفي مقالها “معاً في تشرين” (المنشور في عام 1976) في الذكرى الثالثة لحرب تشرين التحريرية، إشارات مهمة للمعاني البعيدة والعميقة لهذه الوقفة البطولية في وجه الصهيونية المجرمة، ودعوة للمزيد من دراستها من الوجوه والمناحي كافة.
ويتبع هذا المقال مقال آخر (في المناسبة ذاتها) يشير إلى أن احتفالاتنا “يجب ألا تكون مهرجانات وأعياداً” وحسب، بل يجب أن تتحول إلى دراسات نستعيد فيها الانتصارات التي حصلت، والعوامل الإيجابية التي أدت دوراً كبيراً في الانتصارات؛ وإلى جانبها دراسة العوامل السلبية التي تلت هذه الحرب وامتصت الكثير من منجزاتها وغير ذلك من عوامل وظروف.
والدكتورة العطّار ترى – بحقّ- أن ما قيل في النازية القديمة، إنما ينطبق على النازية الجديدة، ممثلة بالصهيونية العنصرية، الاستيطانية، الغاصبة. فالصهاينة هدموا الكنائس، ودمّروا الصلبان، وخرّبوا الآثار وحرقوا المسجد الأقصى.. أمّا “أدباء التطبيع” الساداتيون، فخطورتهم تتمثل بدعواتهم المشبوهة “لحبّ الإسرائيليين” المحتلين القَتَلة، وإلى التسامح والتعامل معهم، ونسيان أن “إسرائيل” عدوّ محتل، وأنها تغتصب حقوقنا وتشرّد أهلنا ؟! (ص 43).
وفي مقال آخر تدافع الأديبة والكاتبة د.العطّار بشدّة عن الشعب المصري الشقيق المنتفض ضد السادات وحكمه المتخاذل، مؤكدة أن الأيام أثبتت أنْ لا سيادة مع وجود الاحتلال، ولا تحرير والأرض منتهكة من العدو، ولا مندوحة لمصر عن العرب، ولا قوة لمصر إلا بالعرب، ولا ديمقراطية بعيداً عن العروبة أو في العمل ضدّها، ولا موقف وسط، في حدّ الحدّ، ولا مكان لمتفرج والنار تشتعل (ص 82).
وهي تربط بدقة وموضوعية بين ما يجري في لبنان ( من حرب أهلية في عام 1975/ 1976)، وما جرى من تآمر شامل ضد سورية و”جريمة المدفعية بحلب” والغارات والتهديدات الإسرائيلية، التي أظهرت يأس الأعداء من ضرب سورية من الخارج فعمدوا إلى تفجيرات الداخل عبر أداوتهم الإجرامية القذرة.
وفي مقال لها في العام 1979 تتحدث حول استعادة سورية المبادرة السياسية في المنطقة،مركّزة على الإنجازات التي تحققت في هذه المرحلة: داخلياً، ولبنانياً، وعربياً. كما تستعرض الإستراتيجية العربية القومية من عبد الناصر إلى حافظ الأسد.
وتحلل الدكتورة العطّار في مقال آخر أوراق القوة التي تمتلكها سورية، والمتمثلة في ثلاثة محاور هي: 1- القوة العسكرية الضاربة، المواجهة للكيان الصهيوني؛ 2- السياسة الداخلية، المرتكزة على وحدة الصف الداخلي من خلال الجبهة الوطنية التقدمية، وبقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، لحشد القوى وراء تحقيق المبادئ الثابتة في الخط القومي والوطني، وتحقيق التنمية الاجتماعية – الاقتصادية الشاملة؛ 3- السياسة الخارجية، المتميزة في الخط القومي، وتبني التضامن الكفاحي في وجه أمريكا و”إسرائيل” والسادات، ومعاداة الامبريالية، وتبني أفضل العلاقات السياسية والكفاحية مع الدول الإسلامية والدول المؤيدة للحق العربي (ص115).
في عام 1980 كتبت الدكتورة نجاح العطّار مقالاً ربطت فيه بين وحدتنا الداخلية وتضامننا العربي، وأشارت فيه إلى أبرز معالم استراتيجية الصمود والتصدي والتنمية التي يتبعها الرئيس حافظ الأسد في سورية، وإلى نهجه الدينامي المتمثل بربط قوة سورية والمقاومة لمواجهة العدوّ الصهيوني، وبنظرته المبدئية القائلة إن العرب لقادرون على التصدي لكل الغزاة والطامعين شريطة أن يتضامنوا ويتكاتفوا في ما بينهم بكل ما يملكون من قدرات وطاقات.
وفي مقال آخر (إدانة السادات.. و”تبرئة” الساداتية) لا تفرّق الدكتورة العطار بين السادات ومبارك وأبو غزالة.. فكلهم سواء في مدرسة أمريكا والنهج التسووي الاستسلامي.
وقد أثبتت الأيام والسنوات والأحداث صحة ما قالته سورية وما حذرت أشقاءها العرب منه؛ حيث تقدم الدكتورة العطار إشارات موجزة لأبرز ما حصل في السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة (المقال منشور في عام 1981)، وهو ما يبرهن تماماً على صوابية سياسة سورية العربية والدولية التي قادها بحنكة ونجاح ووضوح ومبدئية الرئيس حافظ الأسد.
وتستمر الدكتورة العطّار في تحليل مرحلة ما بعد السادات معدّدة أبرز سماتها وملامحها، المتمثلة بتلميع حسني مبارك الذي وضع تحت الحماية الأمريكية مباشرة، “أو بالأصح تحت قبضتها” (ص 189). وتخلص من ذلك إلى القول: إنّ خط الحكّام الجدد (من بعد مقتل السادات) هو: الاستمرار في خط السادات، الأمر الذي أكّده حسني مبارك بنفسه مرات عديدة. كما تنبأت الدكتورة بتوسيع “الحلف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي” ليضم إضافة لمصر “بعض الدول العربية المعتدلة” (ص 191). لكن تبقى سورية عصية، وقلعة، وقوة قادرة أن تقلب كل الحسابات، رأساً على عقب.
في ذكرى حرب تشرين المجيدة تكتب الدكتورة نجاح العطّار في عام 1981، كيف أن هذه الحرب ألبستنا ثوباً أبيض بدلاً من ثوبنا الحزيراني الأسود، ومنذ تلك اللحظة التاريخية المفصلية (تشرين الأول 1973)، أشرعنا السيف الذي تنكّس من غدر لا من جبن، واستعدنا الثقة، وحررنا الإرادة، وذررنا في الرياح الأربع أسطورة التفوق الإسرائيلي، ومرّغنا عنجهية “الجيش الذي لا يقهر”، وحططنا من سمعة “الطيران المخيف” الذي أقمنا له في سماء دمشق المجزرة الكبرى (ص 198).
وهي إذ تقدّم التحية للحركة التصحيحية في عيدها الحادي عشر، تشير إلى أبرز الإنجازات التي حققتها هذه الحركة في داخل البلاد وخارجها، والتي شكلت أساساً متيناً لسورية الحديثة، التي أصبحت تعتمد بقوة على مواردها الخاصة وعلى إنتاجها المحلي واكتفائها الغذائي وسواعد أبنائها الوطنيين المخلصين.
ولهذا أراد المستعمرون الجدد والدول الإقليمية الضالعة في مخططاتهم القذرة، معاقبة سورية بسبب نهجها الوطني المستقل والقوي، والذي نتجت عنه تحولات اجتماعية – اقتصادية – ثقافية كبيرة وحاسمة، فكان ردّها مزيداً من هذه التحولات وإصراراً كبيراً على الاستمرار في خططها التنموية الشاملة المتلاحقة، ما أفرز صموداً داخلياً أقوى، ونجاحات خارجية واسعة المدى (ص 234 وما بعدها).
والخلاصة أنّ هذه الرؤية الثاقبة الصادرة عن قيادة لا تتحلى بالتمرّس والفهم وحدهما، بل بالجسارة التي يتأسسان عليها، قد برهنت الأحداث على صحتها الكاملة (ص 246)؛ وذلك أن رجل الدولة الكبير حافظ الأسد لا يقول كلاماً كبيراً إلا ويرفقه بعمل كبير.
في مقال لها بعنوان “كنت في مجدل شمس” (نشر في العام 1982) تنقل حواراً جرى بينها وبين سيدة أجنبية أصيبت بصدمة شديدة لهول التدمير المتعمد والممنهج والعنصري الذي قامت به القوات الصهيونية في القنيطرة قبيل انسحابها منها. وكيف أنّ عدداً من السيدات الأجنبيات وصفن ذلك الذي جرى “بأفظع مما فعله النازيون”. ومع تقدّم الحافلات بهنّ في الجزء المحرر من الجولان العربي السوري تتعالى حولهنّ الهتافات الحماسية العفوية من حناجر الجولانيات: “الجولان لنا…الجولان لنا”.
وتتجاوب مئات بل آلاف الحناجر من القسم المحتل من الجولان من نساء ورجال وأطفال، ويدوي نداؤهم مردداً بتحد للجيش الصهيوني: “حافظ.. حافظ.. الله أكبر.. يا شباب العرب هيّا”. وتحاصرهم سيارات الاحتلال من كل مكان، لكنهم لا يتراجعون بل تعلو هتافاتهم رافعين أعلام الوطن صارخين: “حافظ.. حافظ”.
وتذيع وكالات الأنباء في اليوم التالي أن منعاً للتجول قد فرض هناك، وأن اعتقالات قد تمت لنساء ورجال، وأنّ عديدين منهم تعرضوا للضرب والإهانة.
وكالعادة لم تقدّم وسائل الإعلام العربية الصورة بأبعادها الكاملة، فضلاً عن الإعلام الغربي الذي يسعى دائماً لتشويه الكفاح العربي والمقاومة المشروعة للاحتلال الصهيوني الغاصب.
وفي معرض تحليلها للعدوان الصهيوني الشامل على القطر اللبناني في عام 1982، تشير إلى حقيقة واضحة مؤداها: “أنّ إسرائيل لم تغزُ لبنان وحده، بل غزت كل قطر عربي، ولم تحاصر بيروت وحدها، بل حاصرت كل عاصمة عربية، ولم تسع لفرض سياداتها بقوة الاحتلال على “قصر بعبدا” فحسب بل هي تسعى لفرض هذه السياسة على كل القصور وكل الدور والمضافات.” (ص 273).
وهي إذ تسجّل ملامح المواجهة السورية – الإسرائيلية الشرسة على الأرض اللبنانية، تؤكد أمراً أصبح شديد الجلاء والوضوح، وهو قدرة المقاتلين العرب، وبخاصة القوات السورية، على التعامل مع سلاحها تعاملاً فعالاً، واعتراف المعلقين والمحللين العسكريين أن القوات السورية البطلة قاتلت في هذه الحرب بأفضل مما قاتلت في حرب تشرين، على كل روعة تشرين، صموداً ومناورة وقدرة على إيقاع الإصابات المباشرة بالعدوّ وتحطيم آلياته وقدراته العدوانية (ص 277).
في مقاليها الأخيرين المدرجين في الكتاب والمنشورين في عام 1983، تؤكد السيدة الدكتورة نجاح العطار أن المغامرة الإسرائيلية العدوانية ضد سورية ما تزال قائمة، وأنّ “الزمرة العربية المتواطئة” مع أمريكا و”إسرائيل” تسعى لعزل سورية (بل عملت بكل الوسائل على تحطيمها وتدميرها لاحقاً /خ.ج). لكنها تنطق بصوت كل سوري وطني وعربي شريف عندما تخاطب أمريكا و”إسرائيل”… وكل المتخاذلين والمتواطئين معهما أننا: “نرفض الاستسلام. ولا نخشى الحرب”، وأنّ سورية واعية تماماً للعبة المسارات السياسية المتعددة، وخطورة الاستفراد بكل طرف عربي على حدة.
وبعد أن استعرضنا ما أمكن أبرز المحاور التي تضمنها هذا الكتاب الذي يمهّد لما سيأتي بعده، فإننا نستطيع القول إنّ الأديبة الكبيرة والباحثة المدققة والسياسية المحترمة والكاتبة المثقفة المتميزة الدكتورة نجاح العطّار استطاعت تماماً أن تنعش الذاكرة الوطنية- القومية الجمعية من جهة، وتهيئ وتحضّر أذهان ومدارك أبنائنا من الناشئة والجيل الجديد للولوج في مرحلة نضالية جديدة أو بالأصح إلى حلقة أخرى في سلسلة تاريخية متتالية الفصول والصفحات من جهة أخرى.
أما رسالتها الأساسية والقوية والواضحة في هذا العمل ، فإنها – من وجهة نظرنا-تتمثل في التأكيد مجدداً أن التاريخ يكتب هنا في سورية، في النقطة المحورية والمركزية لانطلاق الحضارة الإنسانية جمعاء في دمشق التي كانت وستظل عاصمة العرب الأولى، ومحور التاريخ ومركز صناعة القرار، ومهوى أفئدة العرب وقِبلة أنظارهم وتطلعاتهم نحو الكرامة والعزة القومية، وهي التي كانت دوماً وستبقى القلعة الحصينة والمستحيلة على جميع الغزاة والمرتزقة والطامعين، وهي اليوم كما الأمس وفي الغد ستظل الرمز الأعظم والأسمى لحضارة هذه الأمة وشمس مجدها التي لا تغيب ولن تغيب إلى أبد الآبدين.
(سيرياهوم نيوز-الثورة16-6-2021)
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن