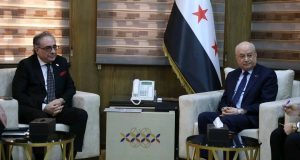| عصام النقيب
في مقال له في «الأخبار» (19/3/2022)، بعنوان «الموت السياسي للعرب: كيف استقلنا من التاريخ؟» قدّم د. أسعد أبو خليل مجموعة من الأفكار والتحليلات الأولية الصادمة بصراحتها للأحداث العربية، فسّر من خلالها مضمون مقالته أنّ العرب خرجوا من التاريخ، بعدما كانوا قد دخلوا بقوة إلى داخل مجراه العريض بزعامة جمال عبد الناصر، الذي وثقت الشعوب العربية بشخصه وقيادته. من الصعب الاختلاف مع مقولة خروج العرب المعاصرين من التاريخ، لأن كل الأحداث تشهد بذلك، كما أصبح الشعور بالتراجع في كل الميادين وغياب العرب عن التأثير في مجرى الأحداث، التي تخصّ مصير أوطانهم، يخيّم على معظم الأقطار العربية، وبخاصة بلدان الهلال الخصيب واليمن وليبيا، التي أصبحت شعوبها تعيش في أوضاع كارثية، غير مسبوقة في تاريخها.
جمهوريات الصمت والخوف
أدّى نجاح التجربة الناصرية في مراحلها الأولى إلى حدوث عدة انقلابات عسكرية، في المنطقة العربية، لتحلّ مكان الأنظمة التي كانت سائدة، على غرار ما حصل في مصر. وقبل مضي عقد من الزمن على رحيل عبد الناصر، استتبّ الأمر، بصورة خاصة، لأربعة قادة جدد أعطى كل منهم لانقلابه صفة الثورة التي تُنهي كلّ الثورات، وليقف على قمّة نظامه دون منازع: ليبيا (1969)، سوريا (1970)، العراق (1978)، اليمن (1978). وقد سبق ذلك، في حالتي سوريا والعراق، صراع دموي دام سنوات، داخل الحزب والجيش (لم تُدرج التجربة المصرية الهامة ضمن هذه المجموعة، فقد جرى التعرّض لها بالتفصيل، كما لم تُدرج التجربة الجزائرية، لخصوصيّتها، ولبُعدها النسبي عن مسرح الأحداث في المشرق).
كان يقود كلاً من النظم العسكرية الأربعة فرد مغمور، مغامر محدود التعليم والثقافة، متمرّس في الصراعات الحزبية أو العسكرية الداخلية، إضافة إلى كونه شديد الطموح الشخصي والاعتداد بالذات، وذا ذكاء وقسوة فطريّين.
ونظراً إلى افتقار كلّ من القادة الجدد للحد الأدنى من شرعية الموافقة أو التمثيل الشعبي الحر، فقد اعتمدوا جميعاً على عصبيات فئوية أو قبلية لضمان البقاء في الحكم، وعلى نظام شمولي، يعتمد على الحزب الواحد والجيش العقائدي الموجه، وعلى أجهزة الشرطة والمخابرات المتعددة التي تراقب المواطنين وترصد تحركاتهم على مدار الساعة، علماً بأن قادة كل من هذه الأجهزة يكون مسؤولاً مباشرة أمام رأس النظام. واستكملوا ذلك بتفعيل دور المؤسسات الحكومية والمجالس التشريعية والقضائية الضرورية لإدارة شؤون الحكم المدني. إلا أن هذه المؤسسات كانت، من حيث الصلاحيات العليا والقرارات النهائية، مجرّد واجهة للنظام، الذي يتحكم في كل قراراته، رأس النظام، بالاعتماد على الجيش والمخابرات والحزب (قد يكون من أقصر الطرق للتعرّف إلى التكوين الهيكلي الاستبدادي للأنظمة الأربعة المذكورة مطالعة الدستور الخاص بكل دولة، وكذلك النظام الأساسي للحزب الحاكم. وينطبق الأمر ذاته على «القانون الأساسي المعدّل» الذي تعتبره السلطة الفلسطينية دستورها، والنظام الأساسي لحركة فتح في الداخل والتي تقوم بدور الحزب الحاكم).
صمّم كلٌّ من القادة منظومة حكمه ليستمر مدى الحياة، معتبراً أن وجوده وبقاء نظامه ضروري لمستقبل بلده ومستقبل المنطقة، ولتحقيق أهداف المنطقة العربية. أي هو الخليفة المؤهل، بصورة أو بأخرى، دون غيره، لتحقيق الأهداف العربية للمشروع الناصري، في التحرير والوحدة والعدالة الاجتماعية. ولمّا كانت صياغة هذه الأهداف الإقليمية ما زالت فضفاضة، لم تخضع بعد للحد الأدنى من المراجعة والتطوير الفكري في ضوء التجربة، فقد كان سهلاً على كلٍّ من القادة الجدد أن يفسرها ويفصلها وفق مصالحه ومصلحة النظام، دون أن يلزمه ذلك بأي التزام أو إنجاز محدد.
وكما كان متوقعاً، فسرعان ما اختفت في البلدان المعنية، نتيجة لكل ذلك، مظاهر ومقومات الحياة السياسية المتعارف عليها حضارياً، كأحزاب المعارضة والقضاء المستقل، والنقابات المستقلة، ومنابر الصحافة والإعلام غير الموجه، وهيئات النفع العام المستقلة، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتحولت تلك الجمهوريات إلى ما يمكن تسويته بجمهوريات تحكمها المخابرات والصمت والخوف. ولأن النظم الجديدة كانت تمارس الشمولية والاستبداد في مجتمعات ما زالت دون عتبة التطور الاقتصادي، فقد تحولت بسرعة إلى «جمهوريات وراثية»، تسندها عصبيات فئوية أو قبلية، أقرب في مفاهيمها وممارساتها إلى نظم الحكم في عصور الانحطاط، ولكن بوسائل وأدوات قمع ومظاهر الحضارة الحديثة. أنظمة فاشية ومتخلّفة في آن واحد.
جدران الفصل الثلاثة
وكما هو متوقع، فقد كان حق الجماهير في ممارسة العنف السياسي، الذي افتقده أبو خليل، من أوّل ضحايا الأنظمة الجديدة. إلا أنّ أخطر ما حققته الأنظمة، دون أن تدرك أبعاده، هو أن كلّاً منها، بعد أن حبس شعبه في قفص من الاستبداد الشرس، عزل ذلك الشعب أيضاً، في آن واحد، عن مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية، وعن التفاعل مع محيطه العربي، وعن المشاركة المباشرة في الصراع العربي الإسرائيلي.
ففي مجال التنمية الاقتصادية، فرض الاستبداد، في كل من تلك البلدان، سقفاً منخفضاً على وتيرة التنمية في ميادين النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المختلفة، نتيجة انغلاق النظام على نفسه، وعدم قدرة المواطنين على المشاركة بحرية، في ظلّ فرص متكافئة، باستخدام كل ما يملكونه من مواهب ومبادرات، وابتكار، وقدرات تنافسية، في تطوير حياتهم وحياة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم. لقد وجدوا أنفسهم يعيشون في نظم يتحكم فيها مجموعات ووجوه جامدة ثابتة لا تتغير، من أصحاب المناصب والنفوذ في الحزب أو الجيش أو المخابرات، وأبنائهم والملتفين حولهم، ليس نتيجة لكفاءتهم في خدمة وطنهم، بل لولائهم للنظام أو موقعهم في هرمه، أو لصلاتهم العائلية. وهو ما وفّر بدوره مناخاً مثالياً لازدهار الفساد، وتسرّب الثروة الوطنية إلى جيوب المتنفّذين والمنتفعين على حساب المال العام ومشاريع التنمية الوطنية. إضافة إلى الإنفاق الهائل، بعيداً عن المراقبة، على أجهزة الحكم والقمع وعلى مشاريع التسلّح. وكما تقول الحكمة السياسية: «السلطة تفسد، والسلطة المطلقة تفسد بصورة مطلقة».
وقد أبقى ذلك كله البلدان المذكورة دون عتبة النهوض الاقتصادي على مدى عقود طويلة. وذلك في الوقت الذي انتقل فيه العديد من المجتمعات، التي كانت أيضاً تعاني من التخلّف الاقتصادي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما في بلدان الشرق الأقصى مثلاً، إلى مسار التطور الاقتصادي المتسارع، ومعدلات الدخل القومي، ومداخيل الفرد العالية. كما أنّ إسرائيل، التي كانت تملك أصلاً اقتصاداً ذا تكوين متطور، بحكم تكوينها، كغزوة استعمارية قادمة من أوروبا، تابعت تطورها بسرعة متزايدة في ميادين الاقتصاد، والتعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا العالية، وصناعة وتصدير منتوجات الأسلحة المتخصصة المتطورة، بما في ذلك أحدث وسائل التجسّس، وقمع التظاهرات.
وفي مجال التفاعل العربي ــ العربي، كان من أوّل إنجازات أنظمة القمع، وبحكم الهاجس الأمني وحرصها المتزايد على بقائها، أنّ كلاً منها أنشأ، منذ لحظة استلامه للحكم، نقاط مراقبة أمنية تخضع مباشرة لإشراف وقرارات مراكز المخابرات، على نقاط المعابر الحدودية كافة الجوية والبرية والبحرية، بالإضافة إلى مراكز المخابرات الداخلية. وأصبحت نشاطات السفر، بين كلٍّ من الدول المعنية والدول العربية الأخرى، تتميّز بالمعاملات الروتينية المعقّدة، وصفوف الانتظار الطويلة والمهينة عند المعابر، والقلق والخوف ممّا تقرّره المخابرات، التي تعمل في الداخل بعيداً من شباك المعاملات، وذلك بالنسبة لمواطني البلد المعني، وللعرب الزائرين، على حدٍّ سواء. وهو ما قلّص بصورة مأساوية من فرص التفاعل الحياتي الطبيعي، في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي، بين شعوب الدول المعنية، وكذلك بينها وبين الشعوب العربية الأخرى، علماً بأنها كلها يجمعها لغة أولى واحدة، وتاريخ وثقافة مشتركة، وطموحات إنسانية متشابهة، وعلاقات أسرية. وبذلك، تحولت الأنظمة التي احتكر كل منها المناداة بالوحدة، والتنمية الاقتصادية، إلى أكبر العقبات في طريق الوحدة والتنمية العربية، ما جعل الناس تترحّم بحسرة على أيام الانتداب والسنوات القليلة اللاحقة التي سبقت عهود الاستبداد.
في مجال التنمية الاقتصادية، فرض الاستبداد، في كلٍّ من تلك البلدان، سقفاً منخفضاً على وتيرة التنمية
وفي مجال مواجهة إسرائيل والحركة الصهيونية، كان من أهم عواقب محاصرة شعوب البلدان المعنية داخل أقفاص الاستبداد، إن لم يكن أهمّها، هو أنّ تلك الأقفاص كانت أيضاً بمثابة جدار كثيف عازل بين الشعوب العربية وبين فرص لدعم الشعب الفلسطيني، ومواجهة الدولة الصهيونية، بصورة مباشرة ودون حواجز. وكان ذلك نتيجة طبيعية لاحتكار النظم القمعية لكل أنواع الحراك السياسي والجماهيري والإعلامي، داخل وعبر حدودها، وحصر ذلك فيما تنظمه أجهزته من نشاطات أو تظاهرات، أو ما يصدر عن أبواقها الإعلامية من بيانات وتفسيرات، وكلها ذات طبيعة معروفة ومكررة، لا وقع لها.
فلم يكن بإمكان جماهير المجتمع المدني، في تلك البلدان، مثلاً، تنظيم مسيرات شعبية غير مسلّحة نحو الحدود بصورة مكثّفة ومتتابعة لا تتراجع، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى وطنهم في فلسطين والجولان، وتنبيه العالم لحقوقهم كل يوم، أو لدعم الانتفاضات الفلسطينية، أو مسيرات العودة من غزة، أو يوم الأرض في الداخل. ولم يكن بالإمكان المشاركة في مسيرات القوارب البحرية المطالبة بفك الحصار عن غزة، أو الانضمام إلى فلسطينيّي الداخل والمتطوّعين الدوليين دفاعاً عن البيوت المهددة بالمصادرة والإخلاء في حيّ الشيخ جرّاح، وسائر أحياء القدس العربية، أو الأراضي المعرّضة للمصادرة في الضفة. وهو ما جعل الشعوب العربية غائبة، بالقول والفعل، عن المساهمة المباشرة في دعم الشعب الفلسطيني، وحرمانها، بين أمور أخرى، من الكشف ميدانياً، وعلى مرأى من العالم، عمّا يجري في الداخل من جرائم دولية من التطهير العرقي الممنهج، وعن قوانين الأبارتايد التي تستند إليها المحاكم الإسرائيلية في إضفاء الشرعية المزوّرة على تلك الجرائم، علماً بأن ذلك يضع تلك القوانين والمحاكم، وعلى رأسها المحكمة العليا، في قفص الاتهام الدولي.
الاستبداد يصبح، مع مرور الوقت، قفصاً للحاكم المستبد أكثر ممّا هو للشعب المحاصر، لأن الشعب يظل في النهاية يملك خيار المقاومة، فيما لا يملك الاستبداد من خيارات سوى الإمعان في الاستبداد. فهو يخشى من أي نشاط شعبي لا يخضع لتحكّمه المباشر، لخوفه من تحوّل الحراك الشعبي ليصبح ضد النظام في أي وقت، أو من التعرّض، كنظام معزول عن شعبه، للغضب من قبل الدول المستهدفة بالحراك الشعبي، ولتهديدات ليس في مقدوره مواجهتها.
ولهذه الأسباب، لم تسمح تلك الأنظمة أيضاً بأي عمليات مقاومة شعبية مسلّحة تنطلق عبر حدودها، أو تخاطر باستدراج الدولة الصهيونية إلى حرب عصابات شعبية تستنزف قدراتها، كما فعل حزب الله مثلاً، وبنجاح تاريخي، لتحرير الجنوب اللبناني. ومع الوقت، وتصاعد الهوة التنظيمية والتكنولوجية العسكرية بين إسرائيل وجيرانها، تحوّلت الأنظمة العربية القمعية إلى أسود من خشب، لا تستأسد إلا على شعوبها، وإلى عبء ثقيل على تلك الشعوب، بعد أن فشلت في تحقيق أي من الأهداف التي نادت بها، عند وصولها إلى الحكم.
جدران أوسلو الثلاثة
وليس أدلّ على أهمية ما أنجزته تلك الأنظمة، في خدمة المصالح العليا للحركة الصهيونية، دون وعي أو إدراك من مدى التطابق الوظيفي بين الجدران التي بنتها تلك الأنظمة حول شعوبها، وبين الجدران العازلة التي بنتها إسرائيل، خاصة من خلال اتفاقية أوسلو، وبإشراف الداهية الصهيوني المخضرم، شمعون بيريز، بالتواطؤ مع قيادة المنظمة، حول وداخل التجمعات الديموغرافية الفلسطينية في الأراضي المحتلة. فمن خلال احتفاظ الاحتلال بالأراضي والمياه الفلسطينية التي تضمّها المنطقة جيم، والمناطق الشاسعة المحيطة بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، التي ضمّتها إسرائيل مع مدينة القدس الشرقية، في نطاق ما سمّته بمحافظة القدس الكبرى، ومن خلال انتزاع حق المواطنة من فلسطينيّي القدس، وفرض الحصار الدائم حول غزة، حرمت أوسلو فلسطينيّي الأراضي المحتلة من الحد الأدنى اللازم من مقومات بناء اقتصاد وطني منتج، وحاصرت جماهير الشعب الفلسطيني داخل المدن التي تشرف عليها السلطة، بهدف تحويلهم إلى حالة خيرية تعيش على معونات الدول المانحة.
ومن خلال الالتزامات السياسية والاقتصادية الدقيقة والمتشابكة التي فرضتها الاتفاقية على السلطة، ومحاصرة مناطق السلطة (ألف وباء) من الجهات كافة بالمنطقة جيم المخصصة للاستيطان، والخاضعة أمنياً وإدارياً وسيادياً للاحتلال، عزلت الاتفاقية الشعب الفلسطيني في الداخل، ليس فقط عن محيطه العربي، بل عزلت الجزر السكانية الفلسطينية عن بعضها، وعن المنطقة جيم والقدس، وعزلت المناطق كلها عن غزة، وعن 1948 والشتات.
وغني عن القول أن الدور الموكل للسلطة بموجب الاتفاقية، كحارس أمني وسياسي للاحتلال، وكما ذكر بالتفصيل سابقاً، قام بدور الجدار العازل الذي يحمي نشاطات الاستيطان وقوات الاحتلال التي تحميها، من المواجهة المباشرة مع جماهير الشعب الفلسطيني، وجنبها بذلك تحمّل التكاليف الباهظة للاحتلال المباشر، سياسياً وقانونياً وعسكرياً ومالياً وبشرياً.
الحصاد المر
مع نهاية الطريق المسدود التي وصلت إليها أنظمة الاستبداد العربية والفلسطينية، تسارعت وتشابكت التدخلات الخارجية والإقليمية والدولية التي أوصلت المنطقة إلى أحوالها الحاضرة، وهو ما يخرج عن الإطار المحدد الذي التزمت به هذه المداخلة، ما يوجب التوقف عند هذه النقطة. ويكفي الإشارة، لمجرد التذكير، وعلى مستوى العناوين فقط، إلى أنّ الأمور بدأت تأخذ منحى خطيراً على مستوى المنطقة نتيجة لحربَي الخليج العدوانيتَين اللتين شنّهما رأس النظام العراقي، آنذاك، ضد إيران (1982) والكويت (1990)، على التوالي، مما مهّد الطريق أمام الحربين اللتين قادتهما الولايات المتحدة ضد العراق: الأولى (1990) لطرد صدّام من الكويت، والثانية (2003) لاحتلال العراق ونهب ثرواته، ثم اضطرارها للخروج منه بالفشل وسوء السمعة، بعد أن تسبّب تدخّلها في حروب داخلية وإقليمية مدمّرة، وبعد أن نشرت قواعدها العسكرية في سائر دول الخليج النفطية. وتلا ذلك ما سمّي عالمياً بثورات الربيع العربي (ابتداءً من خريف 2010)، وما أعقبها من صراعات داخلية وتدخلات خليجية وإقليمية ودولية طاحنة، خاصة داخل كل من الدول الأربعة المعنية. وما رافق ذلك كله من ظهور وممارسات وحشية عدمية الأهداف، للجماعات الإسلامية الأصولية، من ذوي العقول المغسولة بتفسيرات سيد قطب الفاشية للإسلام، وبمعتقدات الإسلام الوهابي السلفي والتكفيري. ويكفي الإشارة، مثلاً، إلى أن ثلاثة من البلدان المعنية الأربعة، على الأقل، أصبحت تعيش غالبية شعوبها دون خط الفقر، وفي حالات مروعة من التقسيم الجغرافي، والاحتلال الخارجي، والدمار العمراني، والنزوح الداخلي والخارجي، والصراعات الفئوية الدموية الداخلية، التي ليس في الأفق المنظور ما يعد بانتهائها.
خاتمة
يمكن أن نستنتج ممّا سبق، أنّ خروج العرب المعاصرين من التاريخ بدأ، بصورة جدية ومتسارعة، مع وصول أنظمة الاستبداد العسكري إلى الحكم، أي منذ السبعينيات من القرن الماضي. ولم تكن أوسلو إلا الصيغة الفلسطينية لسقوط أنظمة الاستبداد العربي في مصيدة الحركة الصهيونية، في سعيها الدؤوب لتهويد الأرض الفلسطينية، كحد أدنى، وللهيمنة السياسية والاقتصادية على شؤون المنطقة.
كما نستنتج أن التحديات التي واجهها الشعب الفلسطيني، منذ بدء الحملة الصهيونية، كانت دائماً متداخلة مع التحديات التي تواجهها الشعوب العربية، ولا يمكن الفصل بينهما. وفي الوقت الذي تبّنت فيه معظم الأنظمة العربية، بما فيها النظام الفلسطيني، بحكم تكوينها الفوقي، أجندات متضاربة، في سعي كل منها للمحافظة على بقائه وامتيازاته، على حساب مصالح وحقوق شعبه، فإنّ أوليات الشعوب العربية، بما فيها الشعب الفلسطيني، كانت دائماً متشابهة في طبيعتها. فكل منها يسعى، وفق ظروفه والتحديات التي يواجهها، إلى امتلاك القدرة على تقرير مصيره، أي أن يعيش كشعب، وكل مواطن فيه، سيّداً حرّاً موفور الكرامة، كامل الحقوق، فوق كل بقعة من ترابه الوطني، أي حرّاً من أي استبداد داخلي أو خارجي.
لقد حرصت الصهيونية، ونجحت حتى الآن بصورة مدهشة، فيما عدا استثناءات معدودة، في تجنّب مواجهة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية مباشرة، طوال مسيرتها الطويلة من الحروب والدماء والدمار، الذي فرضته على شعوب المنطقة وأجيالها المتعاقبة. ومن جهة أخرى، فإن أكبر درس تعلّمه الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية الأخرى، هو أن لا تسلّم زمام أمورها لأي منظومة حكم أو قيادة وطنية لا تخضع مساءلتها ومحاسبتها وتبديلها من خلال هيئات مستقلة ممثلة للقواعد الشعبية وقواعد مؤسّسية ملزمة.
تدل تجارب التاريخ الحديث أن الشعوب التي تملك مقاليد أمورها، وتتصرف من خلال قيادات مسؤولة أمام شعوبها، تعرف كيف تطوّر أساليب الكفاح التي تناسب قدراتها، وتفتح باب المشاركة للغالبية الشعبية في الكفاح وبذل التضحيات الهائلة، كل من موقعه ووفق ظروفه، فيما تشل بالتدريج قدرة المستعمر على استخدام تفوقه العسكري والاقتصادي. أي أن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني والشعوب العربية هي وحدها القادرة على مواجهة الحركة الصهيونية وحلفائها، بصبر، ونفس طويل واستعداد دائم للتضحيات. وذلك عند خطوط التماس كافة مع تلك الحركة، في الداخل الفلسطيني، وفي المحيط العربي، وفي الشتات، وداخل المجتمعات اليهودية ذاتها في إسرائيل والعالم. وهو ما يعد بتمكّن الأجيال الجديدة من العرب المعاصرين من الدخول المتجدد للتاريخ، من بوابة الحرية الواسعة.
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن