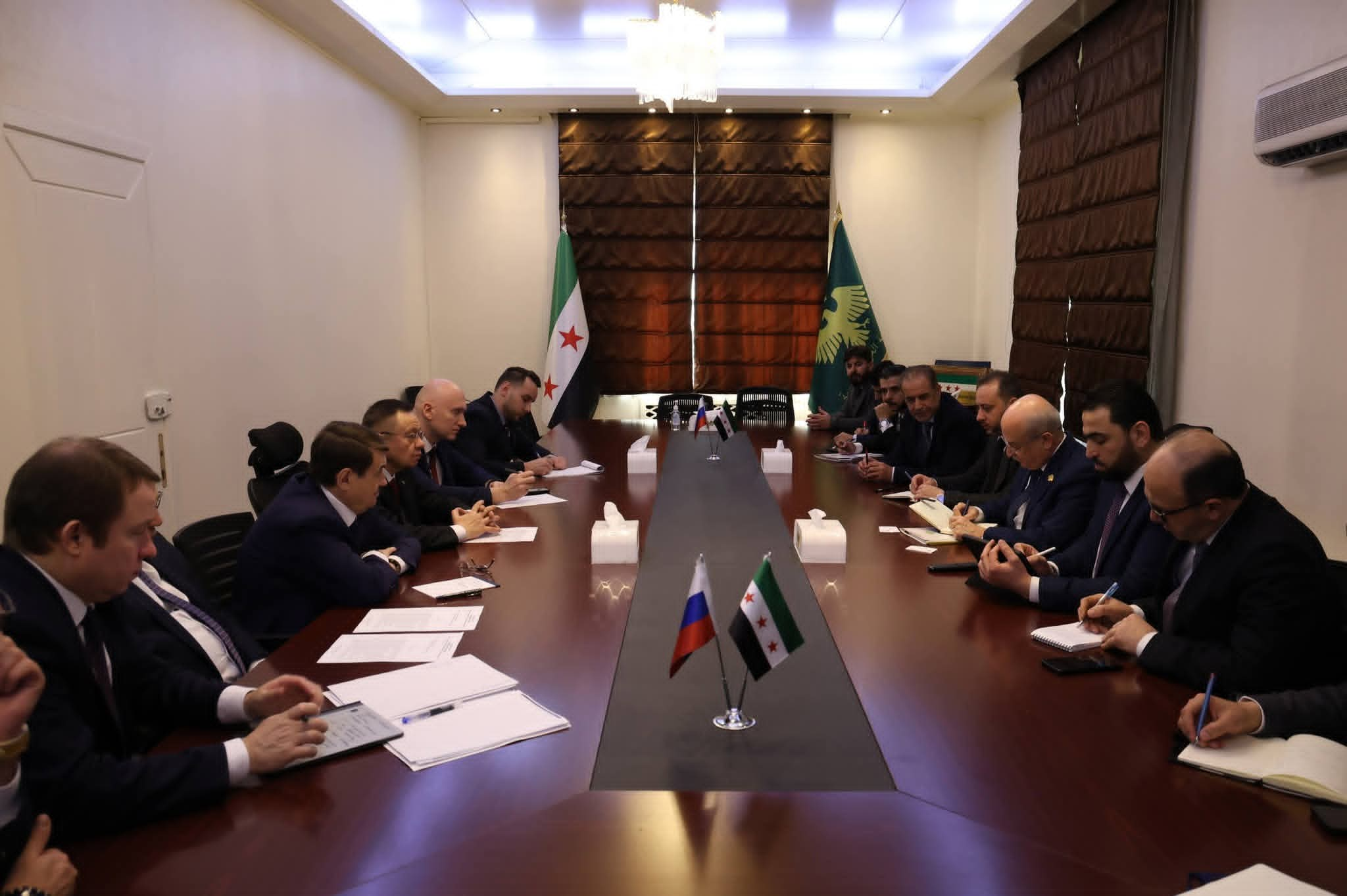ما أحوجنا اليوم بعد نجاح الثورة والتحرير إلى ثورة زراعية، تعيد بناء القطاع الزراعي الذي تدهور خلال السنوات الماضية فاقداً أكثر من 70 في المئة من إمكاناته وإنتاجيته وثرواته الزراعية والحيوانية.
فهل يعقل أن يتدنى متوسط إنتاج محصول القمح الاستراتيجي إلى أقل من 700 ألف طن بعد أن كان في 2010 أكثر من 4 ملايين طن محققاً الاكتفاء الذاتي، حيث بلغ متوسط الاستهلاك حوالي 2.5 مليون طن وتراوح فائض التصدير حوالي 1.5 مليون طن وفق إحصائيات المكتب المركزي للإحصاء، وأصبحنا نعتمد على الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد على القمح.
التراجع الموجع
الخبير في الاقتصاد الزراعي ودراسات الجدوى الاقتصادية المهندس حسام قصار، شرح في تصريحه لصحيفتنا “الحرية” أسباب التراجع في إنتاجنا للقمح لموسم 2024 – 2025 الذي يعود بالدرجة الأولى إلى التغيرات المناخية المتمثلة بالجفاف وانحباس الأمطار هذا العام حيث لم يتجاوز 25 في المئة من المعدل العام السنوي، إضافة إلى ممارسات النظام البائد التي أدت إلى نزوح الكثير من المزارعين من أراضيهم، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الزراعية وتدهور الأراضي، عدا خروج الأراضي الزراعية في المنطقة الشرقية التي تعتبر خزان القمح لسوريا والمسرح الرئيسي لزراعته عن سيطرة الحكومة.
واعتبر أيضاً ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي من (أسمدة وبذار ومبيدات ومحروقات.. ) وانخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وعدم استقرارها وتناسبها مع التكاليف من أسباب التراجع الأهم، ما دفع بعض المزارعين لترك زراعة القمح وتحويل أراضيهم إلى زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وأكثر ربحاً كالكمون واليانسون وحبة البركة وغيرها.
ولفت إلى أن السياسات الزراعية لعبت دوراً في تراجع إنتاج القمح كعدم توفير الدعم الكافي للمزارعين وتأخير زراعة المحصول بسبب تأخر هطل الأمطار وارتفاع تكاليف الري الذي يؤدي لانخفاض إنتاجية الدونم، مؤكداً بيع مزارعين لمحصول قمحهم قبل حصاده لرعي المواشي بسبب عجزهم عن إتمام العمليات الزراعية وتكاليفها العالية.
وعليه، قدَّر قصار نسبة الضرر في الأراضي الزراعية ما بين 40 – 75 في المئة، إذ لم يغطي إنتاج هذا الموسم الذي بلغ أقل من 300 ألف طن نسبة 19 في المئة من الحاجة المحلية، مشكلاً نقصاً في سد الاحتياج المحلي من القمح ما نسبته 80 في المئة حسب التقديرات، ما يشكل تهديداً للأمن الغذائي وارتفاع أسعار الخبز وزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
إدارة المشكلة
تقودنا أسباب التراجع آنفة الذكر إلى تساؤل مهم، كيف يمكننا إعادة إنجاح مواسم زراعة القمح؟
وهنا يبيّن قصار لـ”الحرية”: أن ذلك يتم بدعم المزارعين اقتصادياً من خلال توفير القروض الميسرة والدعم الفني في إعادة تأهيل التربة، وتحسين نوعية البذار واستخدام أصناف مقاومة للجفاف، والآفات وتحسين إدارة الموارد المائية وترشيد المياه، وتطوير تقنيات الري الحديث واعتماد برامج تخصيب الأراضي والتقنيات الحديثة كالزراعة الذكية.
وفي سياق متصل، يرى قصار أنه لا بد من التكيف مع التغيرات المناخية، طالما أنه شر واقع لا محالة باختيار أصناف جديدة مقاومة للجفاف والملوحة وتعديل مواعيد الزراعة والتوجه لزراعات بديلة تتحمل الجفاف كالعدس والحمص والنباتات العطرية والطبية لضمان التنوع.
الدور الحكومي
المشكلة ليست بسيطة، ولهذا يقع على عاتق الحكومة ومؤسسات الدعم الزراعي اتباع آليات جديدة لتوفير التمويل والدعم الفني والتقني لمشاريع الري والتحديث الزراعي، وتقديم التدريب اللازم والإرشاد الزراعي للمزارعين، وخاصة بما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مجابهتها، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحيتة لشبكات الري والطرق والمختبرات، ووضع سياسات محفزة تتضمن دعم أسعار القمح، وتسهيل عمليات التسويق وتوفير البذار المحسنة وتشجيع الأبحاث الزراعية على استنباط أصناف جديدة مقاومة.
لمَ لا نجرِّب تجربة العراق؟
لعامين متتاليين، انتقل العراق من استيراد القمح إلى تصديره وإلى تحقيق فائض كبير، حيث بلغ إنتاجه للقمح في 2024 حوالي 7 ملايين طن مسجلاً بذلك مستوىً قياسياً في الإنتاج ومحققاً الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للخارج، وبهذا الخصوص ينوه قصار بأنه من المهم الاطلاع على تجربة العراق والاستفادة منها بما أنها حققت الاكتفاء من القمح ودراسة السياسات الزراعية العراقية المتبعة لفهم كيف تمكنت من ذلك وأسباب النجاح، علماً أن ظروفنا متشابهة من ناحية التغيرات المناخية.
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن