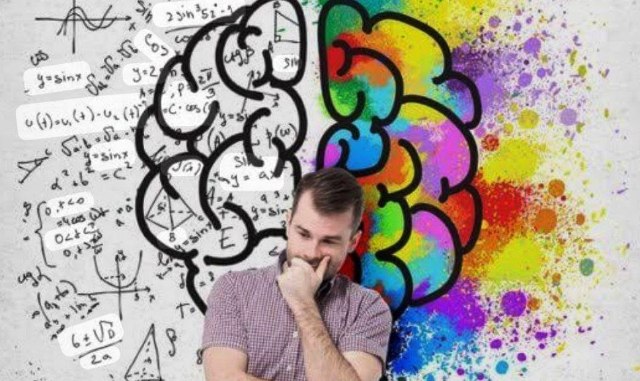حسن نافعة
الولايات المتحدة تريد أن تستثمر صعود الهند في النظام الاقتصادي العالمي لخلق مركز ثقل سياسي جديد مواز ومناهض للثقل الصيني.
انعقدت في نيودلهي يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر القمة الثامنة عشر لمجموعة العشرين. وبينما كان الجدل ما يزال محتدماً حول ما إذا كان بمقدور هذه القمة إصدار بيان ختامي يعبّر عن توافق آراء المشاركين بشأن الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، لا سيما ما يتعلق منها بالحرب في أوكرانيا، وإذا بانتباه العالم يتركز فجأة على اجتماع آخر عقد على هامشها، وضمّ قادة كل من الولايات المتحدة الأميركية والهند والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ففي أعقاب هذا الاجتماع، تم الكشف عن مشروع عملاق يقضي بإنشاء ممر اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وهو المشروع الذي بدأ البعض يطلق عليه “طريق التوابل”، للتمييز بينه وبين “طريق الحرير” القديم الذي قررت الصين إعادة إحيائه عام 2013 تحت مسمّى “الحزام والطريق”، وأنفقت عليه حتى الآن ما يقرب من تريليون دولار.
ويتضح مما نشر عن هذا المشروع الجديد حتى الآن أنه يتكوّن من ثلاثة ممرات أو مسارات منفصلة ومتكاملة في الوقت نفسه. الممر الأول: شرقي، يستهدف تشييد خط بحري يبدأ من الموانئ الهندية وينتهي عند ميناء “جبل علي” في دولة الإمارات العربية، والممر الثاني: جنوبي، يستهدف تشييد خط سكة حديد يمتد من دولة الإمارات إلى ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط، مخترقاً أراضي كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية و “إسرائيل”، والممر الثالث: شمالي، ويستهدف تشييد خط بحري يربط بين “إسرائيل” والدول الأوربية.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربطها بالموانئ البحرية، من أجل تدعيم عملية التبادل التجاري، ونقل الكهرباء والهيدروجين النظيف، والنقل الرقمي للمعلومات عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية.
وفي تقديري أن هذا المشروع يثير جملة من الملاحظات يمكن أن نجملها في الآتي:
الملاحظة الأولى: تتعلق بالقوة الدافعة وراء هذا المشروع. فالمعلومات الصحفية المتاحة حوله حتى الآن تفيد بأنه مشروع أميركي أولاً وقبل كل شيء، تم تصميمه في الولايات المتحدة، ومنها جرى تسويقه إلى بقية الدول المعنية.
إذ بدأت إدارة بايدن تخطط له منذ شهور طويلة. ففي تموز/يوليو عام 2022، أدلى بايدن بتصريحات تحدث فيها عن حاجة دول منطقة الشرق الأوسط الماسة إلى تكثيف عمليات التكامل الاقتصادي فيما بينها وإلى ربط اقتصادياتها أكثر بالاقتصاد العالمي ككل، لكنه لم يفصح في ذلك الوقت عن أي تفاصيل. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، وعندما أصبحت معالم هذا المشروع أكثر وضوحاً وتحديداً في ذهن إدارة بايدن، بدأت تجري مشاورات تمهيدية مع الدول المعنية، طرحت خلالها تصورها الأولي لهذا المشروع ولأهميته بالنسبة إلى كل الدول المشاركة، وسعت للحصول على موافقتها على الفكرة من حيث المبدأ.
ثم، وبحلول الربيع الماضي، شرعت هذه الإدارة في إعداد الخرائط والتقييمات الفنية للبنية التحتية المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق منها بالسكك الحديدية.
وما إن اكتملت اللمسات الأخيرة لهذه التفاصيل الفنية حتى قام كل من جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي، وبريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، وآموس هوكستين، مستشار البنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، بجولة في المنطقة خلال شهر أيار/مايو الماضي، التقوا خلالها المسؤولين في كل من السعودية والإمارات و”إسرائيل” والهند، وتم الاتفاق على الإعلان عن إطلاق هذا المشروع رسمياً عقب اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بين قادة الدول الأربع على هامش اجتماع قمة العشرين.
من هنا، يجب النظر إلى هذا المشروع باعتباره أحد مكونات الرؤية الاستراتيجية الأميركية التي تسعى لتحقيق أهداف عديدة في الوقت نفسه:
1-عرقلة النمو الصيني، وذلك بالعمل على إيجاد مشروعات منافسة لمشروع “الحزام والطريق”، وربما أيضاً تأجيج الخلافات بين الصين والهند للحيلولة دون حدوث أي تقارب بينهما.
2-عزل إيران والعمل على محاصرة نفوذها في المنطقة من خلال عرقلة مشروعاتها الاستراتيجية الرامية إلى تزويد أوروبا بالنفط والغاز عبر خطوط نقل تمتد من أراضيها حتى شواطئ البحر المتوسط، مروراً بالعراق وسوريا ولبنان.
3-تعميق علاقات التعاون القائمة بين بعض الدول العربية و”إسرائيل”، والعمل على توسيع نطاق “اتفاقات أبراهام” للتطبيع مع “إسرائيل”، بضم السعودية إليها. 4-الرد على الصفعة التي وجّهتها الصين إلى الإدارة الأميركية، حين نجحت في التوسط بين إيران والمملكة السعودية، وتمكّنت من إقناعهما باستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة فيما بينهما.
الملاحظة الثانية تتعلق بالتأثيرات السلبية المحتملة لهذا المشروع على مصر. فبمجرد الإعلان عن إطلاق هذا المشروع ظهرت تعليقات عديدة في وسائل الإعلام العربية تؤكد أنه سيلحق ضرراً بالغاً بمصر، وسيؤدي إلى تهميش دور قناة السويس ومكانتها، في حين سيساعد “إسرائيل” على أن تصبح هي حلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب.
ضاعف من حدة الشعور بالقلق ما صدر عن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، من تصريحات فورية مرحّبة بهذا المشروع، ربما بطريقة مبالغ فيها تماماً، حين وصفه بأنه “أكبر مشروع تعاون في تاريخ إسرائيل”، وبأنه “يأخذ المنطقة إلى حقبة جديدة من التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي غير المسبوق”.
من هنا، اعتقاد كثير من المحللين العرب أنه حلقة في سلسلة المشروعات الرامية إلى محاصرة مصر وتهميش دورها في المنطقة. ومع ذلك، تقضي متطلبات العدالة والإنصاف أن نشير هنا إلى وجود وجهة نظر أخرى تشكك في قدرة هذا المشروع على منافسة قناة السويس بأي حال من الأحوال، وتؤكد أن هذه القناة ستظل الشريان الذي لا يمكن للتجارة العالمية أن تستغني عنه بأي حال من الأحوال.
وقد استندت وجهة النظر هذه إلى أن تكلفة نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية ستكون أعلى بكثير من تكلفة نقلها عبر البواخر العملاقة التي يمكنها المرور الآن من قناة السويس. وأياً كان الأمر، فلا شك أن هذا موضوع خطير يستحق المتابعة الدقيقة من دون تهوين أو تهويل.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالتأثيرات المحتملة للتحولات الراهنة في النظام الدولي، والتي تستهدف نقله من نظام أحادي إلى نظام متعدد القطبية. فمن الواضح تماماً أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا المشروع إلى إعادة ترتيب أوراقها، والاستعانة بحلفائها لتمكينها من استمرار هيمنتها المنفردة على النظام الدولي لأطول فترة ممكنة.
ذلك أن الهدف الأساسي لهذا المشروع، وكما سبقت الإشارة، هو محاصرة الصين وإضعاف إيران واستعادة السعودية إلى حظيرة نفوذها، وذلك بتقوية مركز ودور كل من الهند و”إسرائيل” ودولة الإمارات العربية المتحدة.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن الولايات المتحدة تريد أن تستثمر صعود الهند في النظام الاقتصادي العالمي لخلق مركز ثقل سياسي جديد مواز ومناهض للثقل الصيني، الذي يسعى لمدّ نفوذه إلى كل مكان في العالم من خلال مبادرة “الحزام والطريق”.
فقد أصبحت الهند حالياً خامس أكبر اقتصاد في العالم، متفوقةً على المملكة المتحدة، ويشير بعض التقديرات إلى أنها ستتفوّق على ألمانيا بحلول عام 2028، إذ حققت خلال السنوات الأخيرة معدلات نمو قوية بلغت نحو 9% خلال عام 2022. وإذا استمرت في النمو وفق هذا المعدل، فقد يصبح الاقتصاد الهندي بحجم اقتصاد منطقة اليورو بحلول منتصف القرن الحالي.
صحيح أن المشروعين (الحزام والطريق، من ناحية، والممر الاقتصادي، من ناحية أخرى) يشتركان في مسألة أساسية، وهي أنهما يتمحوران حول البنية التحتية العابرة للبلدان، مع وجود فوارق جوهرية بينهما. فمبادرة “الحزام والطريق” مشروع صيني يستهدف إيجاد شبكة تواصل عالمية بؤرتها الصين، في حين أن “طريق التوابل” مشروع متعدد الأطراف والمحاور، وبالتالي أقرب ما يكون إلى مشروع شراكة عالمية لها تعقيداتها.
بعبارة أخرى، يمكن القول إن المقارنة الموضوعية بين المشروعين تكشف، في تقديري، عن خلل كبير في بنية المشروع الذي تسعى الولايات المتحدة لتسويقه حالياً. فمشروع “الحزام والطريق” يتمحور حول دولة مركزية واحدة هي الصين، التي ينطلق منها، رؤية وتخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً، ثم يعود إليها بعد أن يكون قد تمكن من ربط البنية التحتية لمختلف أطراف العالم بهذه الدولة التي تتولى بنفسها تصميمه وتمويله عبر اتفاقات ثنائية مع كل المستفيدين، ووفقاً لقاعدة المصالح المتبادلة والمتكافئة.
أما المشروع الجديد فيعتمد تنفيذه على إرادة أطراف دولية عديدة قد لا يكون من السهل تحقيق التوافق بينها في كل الأوقات. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أنه يبدو، في بعض جوانبه على الأقل، وكأنه محاولة التفافية لدفع عملية تطبيع العلاقات بين السعودية و”إسرائيل”، وهي مسألة لا تزال تكتنفها صعوبات هائلة لم تحسم بعد، لتبيّن لنا أن هذا المشروع ربما ينتمي إلى عالم الأحلام والتمنيات أكثر من انتمائه إلى عالم الحقيقة والواقع.
وإذا كان هناك من درس يتعين على قادة العالم العربي استخلاصه من هذا المشروع الأميركي الجديد فهو أن المصالح الإسرائيلية والتمكين لدولة “إسرائيل” كي تصبح القوة الرئيسية وضابط الإيقاع الرئيسي لتفاعلات المنطقة، هو أهم ما يشغل تفكير الإدارات الأميركية المتعاقبة. فمتى نستوعب الدرس؟
سيرياهوم نيوز1-الميادين
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن