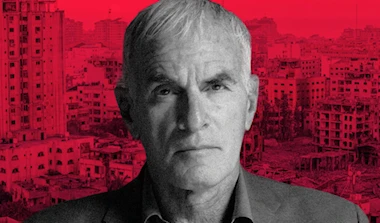| مهدي زلزلي
على سريرٍ في المستشفى البحري بالإسكندرية، رقد البحّار الشاب صالح مرسي، بعد عملية مستعجلة لاستئصال الزائدة الدودية، وحوله تحلّق أصدقاؤه حسن الدريني وحسن الحداد وعلاء الدين، أو “الفرسان الثلاثة” كما يحبّ أن يسمّيهم.
“قلنا لو جبنالك ورد الورد هيدبل.. إنما الكتب عمرها ما تدبل”، قال الدريني وهو يقدّم له رواية نجيب محفوظ “بداية ونهاية”، قبل أن يضيف “اقراها هاتخفّ على طول”، من دون أن يعلم أحد منهم أنَّ هذه الرواية بالذات سوف تغيّر مجرى حياة مرسي، الذي جاب شواطئ العالم فلم يجد أجمل من الغردقة وشرم الشيخ.
انصرف الأصدقاء، وانصرم اليوم حاملاً معه الآلام الحادّة، لينكبّ المريض العائد من الموت على الكتاب الجديد، غارقاً في لجّة لا قرار لها، متنقلاً بين الأشقاء الثلاثة حسن وحسين وحسنين، وطباعهم ورغباتهم المتناقضة، ومعهم نفيسة القبيحة الخلقة والجميلة النفس، والأم “حرم المرحوم كامل أفندي علي”، وما أن سرى أذان الفجر من مئذنة مسجد “المرسي أبو العباس”، حتى كان يطوي صفحات الرواية وقد جفّ دمعه.
لم يكن نجيب محفوظ جديداً على البحّار المولع بالقراءة، فقد قرأ له من قبل “رادوبيس” و”كفاح طيبة” و”همس الجنون”، ولكن “بداية ونهاية” كانت كعلامات الطريق المرشدة بالنسبة إليه، هو الذي جرَّب قبل ذلك الكتابة بغرض التحدّث مع نفسه بصوت مرتفع، من دون أن يخطر في باله النشر، ففي هذه الرواية اغترف محفوظ من الواقع المصري مجموعة من الناس، ثم ألقى بهم فوق الورق وتركهم يتحرَّكون ويعيشون حيواتهم من دون تدخّل منه.
هكذا امتلأت نفس مرسي بعد قراءة الرواية بالرضى الذي يولّد رغبة شديدة بالبكاء، تشبه الرغبة التي تنتاب البحّار إذا ما طال به الترحال وعادت سفينته أخيراً إلى مرفئه ورحمه الذي جاء منه. وهكذا صار كوكباً صغيراً يدور في فلك محفوظ، وزائراً دائماً لمتحفه الفذّ للنماذج الإنسانية، منتظراً أعماله الجديدة شهراً وراء شهر وعاماً وراء عام، ولكنّه ظلَّ على وفائه للقصة القصيرة من دون أن يكتب الرواية، حتى جاءت قصته “زقاق السيد البلطي” عن الريّس “حديدي” وفلوكته “كايداهم” وفلسفته الخاصَّة “من لا يعش حياته لا يستحقها”، والتي يحيل عنوانها فوراً إلى رائعة محفوظ “زقاق المدقّ”، ليكون قدر هذه القصة أن تتحوّل إلى رواية تلتها روايات.
فردٌ في “قبيلة” نجيب محفوظ

لاحقاً، سيبتسم القدر للكاتب الشاب والبحّار السابق، فيقوده العمل في مجلة “الهدف” الثقافية إلى لقاءٍ لم يحلم به مع صاحب “قنديل أم هاشم” يحيى حقي “بجلالة قدره”. وفي مكتب “صائغ الكلمات” المتواضع هذا سيجتمع بحبيبه ودليله نجيب محفوظ، ليعرّف حقي محفوظ إلى فردٍ جديد “من نفس القبيلة”، هو “الأستاذ صالح مرسي اللي كان بحار وساب البحر علشان الأدب”، فتشرق ابتسامة محفوظ مرحِّباً: “نوّرت الأدب”.
ولكنَّ آخر ما توقّعه الكاتب الذي كان بحّاراً، في غمرة سعادته بين عملاقين وأستاذين عظيمين، ومحفوظ يسأله عن قصصه مهتماً بكتابته عن البحر، المجال الذي لم يطأ أرضه قلمٌ عربيّ من قبله، أن لا تكون هذه الجلسة مناسبةً أولى للتعارف كما ظنَّ في البداية، فما أن نهض محفوظ وفي نيّته الانصراف حتى فاجأه بسؤال عن قصَّته “أم”، المنشورة في مجلة “روز اليوسف” قبل أسابيع، مشدّداً على يحيى حقي بضرورة قراءتها.
مراسلات مع يوسف إدريس: وقت للمعارك وآخر للصداقة

حكاية صالح مرسي مع يوسف إدريس لا تقلّ غرابة وإبهاراً عن حكايته مع نجيب محفوظ، فإن كان محفوظ هو الرائد الذي اهتدى بخطاه، فإن إدريس هو القنبلة التي فجرت من حوله كل ما كان قد أقامه من أبنية فنية وأدبية. كان مرسي قد انتهى من قراءة “أرخص ليالي”، مأخوذاً بما فيها من براعة في القصّ تجعلها منجماً من موهبة خالصة، لا صناعة فيها ولا اصطناع لحدث أو تركيب لجملة، فقرّر على عادة الكُتّاب المبتدئين في تلك الأيام مراسلة كاتبها للتعبير عن إعجابه بما كتبه، من دون أن يخامره ظنّ كبير بأنّه سيردّ، ورغبته بعرض قصة من قصصه عليه ومعرفة رأيه بها إن كان سيردّ.
ولكنّ جواب الرسالة وردَ في 2 آب/أغسطس 1954، وكانت المفاجأة في مضمونه. كان يوسف إدريس قد قرأ الرسالة بعين ثائرة لسبب لا يعلمه غيره، فأساء فهمها، وكتب جوابه في نوبة لا تُستَحبّ معها الكتابة (كما قال هو نفسه في رسالة لاحقة)، فقال كلاماً كثيراً كان يصحّ أن يقول غيره.
فهم يوسف إدريس حديث مرسي عن وصوله إلى هذا المستوى الفني الرفيع، الذي يحبّ أن يسأله عن “روشتة” له كأنّه طبيب، حسداً وحقداً وأسفاً لما وصل إليه، ومن ذلك إشرافه على باب القصة في مجلة “روز اليوسف”، فأنّبه وأخبره أنَّه وصل لأنَّه لم يُرِد أن يصل، ولم يتملّق غرائز القراء ورئيس التحرير، ولم يحقد على أحد أو يصعد على أكتاف أحد، وأنّه سوف يتّخذ موقفاً حازماً من أولئك الذين يضعون اسمه كمشرف على الباب، وهو من ذلك براء.
كان لا بدّ لصاحب “السجين” من كتابة توضيح وإرساله إلى صاحب “أرخص ليالي”، ولو لم يقرأه الأخير، كي يتمكّن من إطفاء الغضب المشتعل في صدره، فكتب له: “لست حاقداً ولا حاسداً، فأنا في غنى عن هذا وذاك، أنا يا سيدي معجب أراد أن يسألك عن روشتة للفن الرفيع الذي جادت به قريحتك. أصابني خطابك بغضب هائل، وكدت أجلس إلى الورق كي أردّ بحمم غضبي، لكنّي أمام فنّك هذا الذي أمتعني وفتح لي أبواباً جديدة، قرَّرت أن أوضح لك الأمر لا أكثر، إن كنت قد آذيتك فأرجو أن تغفر، وإن عدت إلى خطابي ولم تجد فيه ما وجدت، فليس عليك جناح”.
وسرعان ما أتى ردّ يوسف إدريس بلهجة مختلفة تماماً هذه المرة، متضمناً عبارات عن تسرعه في الحكم على هذا الذي يراه اليوم شخصاً آخر، بل كنزاً إنسانياً مخبوءاً يمدّ يده إليه بكل ما فيها من حبّ وصفاء، بعد أن عرفه من خطابه وأحبّه.
وفي رسالة ثانية يعود إلى هذه الحادثة، ليقول إنّها جزء من أعراض أزمة نفسية وفكرية مرّ بها، وفي رسالة أخرى يتحدّث بإسهاب عن موهبة الكاتب الشاب الذي سبق له أن طلب رأيه، فيقول: “عزيزي صالح: قرأت “زقاق السيد البلطي” و”الحياة تسير” و”خمر وناس” و”الأمواج”. أنت لست بكاتب قصة فقط، ولا أنت مجيد فقط، ولكن مستواك غير عادي في الكتابة، أنت فنان! أنت بقصصك هذه قد وضعت قدمك على أول الدرج، وبدت فيها موهبتك الفطرية كقصاص، والباقي ليس بالأمر السهل أبداً، الباقي كفاح رهيب لتصعد السلم قدماً، وتضيف إلى موهبتك كل ما تستطيع إضافته من تراث البشرية الثقافي، وتضيف إلى تجاربك التي لم تزل غضَّة، تجارب أكثر عمقاً وأكثر نفوذاً في قلب الحياة الملتهب. في يدك الآن مادة خام دسمة، وعليك وحدك تشكيلها، قد تصنع منها بهلواناً، وقد تصنع منها مسخاً، وقد تصنع كاتباً عظيماً، وأريدك أن تصنع هذا الكاتب. أريدك أن تقرأ وتعيش وتكتب، وأريدك ألا تمل القراءة والعيش والكتابة، فبهذا وحده ستستطيع أن تضيف إلى تراث البشريّة الثقافي شيئاً، وتضيف إلى الأدب الإنساني مادة جديدة!”.
رائد أدب الجاسوسية

قبل “زقاق السيد البلطي” وبعدها، كتب صالح مرسي عن البحر رواية “البحّار مندي”، والمجموعتين القصصيتين “الخوف” و”خطاب إلى رجل ميت”، وكتاب “البحر” في أدب الرحلات.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نشر قصته “دموع في عيون وقحة” في السبعينيات، التي كانت تجربته الأولى في كتابة القصص المأخوذة من ملفات المخابرات، وقد حوّلها لاحقاً إلى مسلسل تلفزيوني أخرجه يحيى العلمي ولعب بطولته عادل إمام، ليكون المسلسل الوحيد في مسيرة “الزعيم” حتى مرحلة متأخرة منها، قبل أن يعود إلى الدراما في سلسلة أعمال في السنوات الأخيرة.
هكذا كان “جمعة الشوّان” فاتحة خير في رحلة أخرى، سعى فيها صالح مرسي إلى مواجهة الدعاية الإسرائيلية، التي لا تنفكّ تزرع اليأس في نفس الإنسان العربي بواسطة الإعلام المزيف والأخبار الملفقة، مصوِّرةً رجل مخابراتها على أنَّه لا يُقهر، وأنَّه الوحيد الجدير بحكم الأرض ومن عليها.
نجح مرسي بوضع أسافين في الصرح الإسرائيلي، تهدم أسطورة تفوّقه المزعوم في “الحفار”، التي كشفت عن أصالة الإنسان المصري بحضارته وتراثه وإيمانه وقدرته على تحقيق النصر، وكذلك من خلال شخصية سامية فهمي التي سلّمت خطيبها الخائن إلى المخابرات المصرية، وكشفت أخطر شبكة تجسس إسرائيلية في أوروبا، ودرّة التاج “رأفت الهجان”، التي أثبتت هشاشة الادّعاء الإسرائيلي المزيف، وحوّلت بطلها الفريد الذي وَهَبَ عمره لوطنه وأمّته إلى رمز لأجيال عديدة من الشباب العربي التائق للنصر.
نُشِرَت “رأفت الهجان” أولاً مسلسلةً في مجلة “المصوّر” القاهرية وجريدة “الشرق الأوسط” اللندنية في الوقت نفسه، وحققت نجاحاً كبيراً وأثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأدبية والثقافية.
وبعيداً من الكمّ الهائل من الأسرار التي كشفت عنها في تلك الحرب الخفية والمستعرة بين مصر و”إسرائيل”، كان الأسلوب الذي تناول به الكاتب أحداث تلك القصة الواقعية، والإضافات الفنية التي أراد لها أن تمتزج بالواقع امتزاجاً كيميائياً، قد ارتفعت بالعمل كله إلى مستوى العمل الفني الخالص، ولكن الآراء انقسمت حولها بين من يرى أنَّ مثل هذه الأعمال لا تندرج تحت راية الأدب بمفهومه التقليدي والمحافظ، وبين من يرى أنَّ هذا نوع من الأدب لم نتعوَّد عليه في العالم العربي، ولكنَّه معترف به في بلدان أخرى.
ولعل من دلالات الانزعاج الإسرائيلي من عمل مرسي سعيه إلى إسقاط هذه الرموز من الوجدان الشعبي، من خلال ادّعائه مثلاً من دون مناسبة عبر صحيفة “هآرتس”، في العام 2017 وبعد أعوام طويلة من الصمت، أنَّ رفعت الجمال (رأفت الهجان) ليس في الواقع سوى عميل مزدوج، عمل بشكل أساسي لصالح “إسرائيل” وساعد في تمكينها من الانتصار في حرب 1967، بعد أن استغلّت الثقة التي اكتسبها لدى المخابرات المصرية وزوّدته بمعلومات مضللة!
يردّ ضابط المخابرات المصري محمد نسيم، الذي تعامل مع الجمال، على هذه الادّعاءات بقوله: “تتحرك إسرائيل كرد فعل لما أحدثه نشر قصة رأفت الهجان، الذي عاش في إسرائيل 20 سنة من دون أن تعرف إلا بعد أذاعت المخابرات المصرية القصة بنفسها، ولو كان الهجان عميلاً مزدوجاً كما يدَّعون، فلماذا ظلّ في إسرائيل؟ ولماذا لم ينتقل للإقامة في مصر أو في إحدى الدول العربية؟ كيف يكون عميلاً للموساد وهو يعيش فى إسرائيل؟”، وأضاف نسيم أنّ “هذه الأسئلة لن تجرؤ إسرائيل على الإجابة عنها”.
زهرة من كل حديقة

ليس بعيداً من هذه المجموعة الشيّقة من روايات الجاسوسية، أضاف صالح مرسي إلى نتاجه وإلى المكتبة العربية كتابه “السير فوق خيوط العنكبوت”، وهو عبارة عن دراسة حول نشأة الجاسوسية وتطوّرها، منذ القديم وحتى آخر قصص التجسّس التي أثارت الناس في كل مكان، و”نساء في قطار الجاسوسية”، الذي يقدّم من خلاله مجموعة منتقاة من قصص النسوة اللواتي قُدِّر لهن أن يخضن في معترك تلك الحرب الخفية بكل ما فيها من غرائب ومخاطر.
أما روايته “أقوى طفل في العالم”، فتقوم على تصوّر يدور حول سؤال: “هل يورث العقل الإنساني كما تورث الأموال والطباع والعقارات والوجوه؟”، فيما ينقل من خلال روايته “الكدّاب” تجربة من واقع الحياة قرَّر أن يعيش أحداثها بكل حواسه وجوارحه، من خلال وصف طبيعي لحي شعبي تثمر محبة أهله البسطاء بذور مشاعر صافية ورغبة بالاعتراف وإعلان الحقيقة، ولكنّ الصيحة تبقى في أعماقه “أنا كدّاب”.
وفي “رحلة السندباد البري”، يبحر في رحلة عجيبة لسبر أغوار النفس البشرية ومعرفة الحقيقة، التي تتعدَّد وجوهها ولكنّ جوهرها واحد مهما تغيَّر المكان والزمان، ويضع بين أيدينا في “المهاجرون” قضيَّة من إفرازات المجتمع المعاصر الريفي والحضري، متناولاً حقائق وأزمات تنمو داخل كل بيت وقرية ومدينة، ومعبّراً بصدق وعفوية ومن خلال تسلسل الحدث عن موقفه والتزامه.
هذا التنوّع في مؤلفات صالح مرسي يمكن أن تختصره مجموعته “حب للبيع”، التي تضمّ قصصاً مختلفة في مواضيعها ومتشابهة من حيث جودة السبك والسرد، كما لو كانت كل قصَّة فيها زهرة تم اختيارها بعناية من حديقة عطرة.
سيرياهوم نيوز3 – الميادين
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن