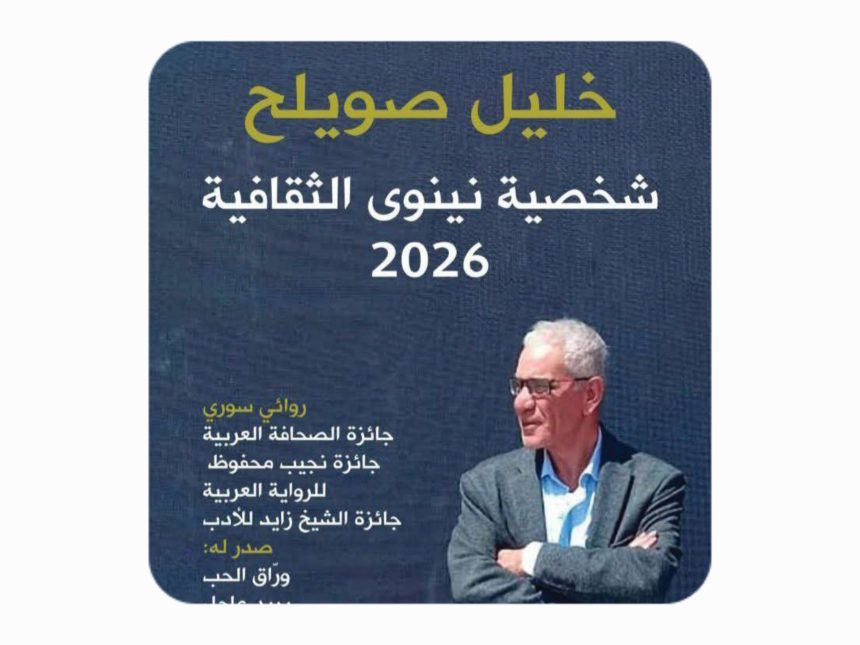وأنا أمارس هوايتي باستذكارات أحداث وعُقَد وأغاني المسرح الرحباني، طرأت ببالي فكرة أنّ الأخوين رحباني ومعهم فيروز، رغم كل عطائهم الفني، إلّا أن تميزهم الرئيس جاء من كونهم حافظوا على أنفسهم ضمن ذلك النوع النادر من المبدعين القادرين على تجاوز أنفسهم عاماً بعد عام، والذين تتسارع قدرتهم على تجاوز ذاتهم كلما مرّت بهم الأيام والأعوام.
أربع وعشرون مسرحية للأخوين رحباني وفيروز تغذّت من الطبيعة اللبنانية بتلالها الصخرية، أشجارها، شتائها وعواصفها، ربيعها الأخضر، صيفها المُثمر، وخريفها المُذَهَّب، ومن الواقع الاجتماعي والسياسي في لبنان كمنهل أساسي للرؤية الفنية الرحبانية بكل خصوصيتها وفرادتها ولغتها البيضاء جداً، استطاعت على مدى ربع قرن أن تجعل من هذا المسرح الغنائي بأقانيمه الثلاثة بحثاً مسرحياً لا ينتهي، وزاداً غنياً للشعر والموسيقى والكثير الكثير من الحب.
المسرح الرحباني بصيغة الحاضر المستمر
لم تستطع الأيام أن تفصلنا عن أعمال الرحابنة في المسرح الغنائي؛ فمنذ “ليالي الحصاد” على مسرح معبد جوبيتر عام 1975 وحتى “بترا” التي عُرضت في الأردن أولاً ثم على مسرح البيكاديلي بين عامي 1977 و1987، استطاع المسرح الرحباني أن يجتاز مفهوم الزمن المسرحي الافتراضي الذي ليس ريفاً أو مدينة، لا واقعاً ولا خيالاً، ولا تستطيع التأكد من أنه خرافة أو تاريخاً، بل هو زمن من كل شيء دون أن يكون شيئاً معيناً، هذه الصيغة الزمنية الرحبانية هي من يمتلك المعنى الذي يحمله العمل ككل، بما فيها من ذاك الدمج الافتراضي الذي يقوم بما يشبه المعجزة، في تثبيت جذور المسرح الغنائي الرحباني في وعينا الجمعي كجزء لا يتجزأ من الروح الرحبانية التي أغنت الفن العربي شعراً ومسرحاً وموسيقى، واستطاعت أن تستمر في انتزاع الإعجاب والإبهار، فالفن الرحباني بدأ منذ خمسينيات القرن الفائت وحافظ على ألق البدايات المتكررة، ليرسم ملامحه الجادة وخصوصيته المعاصرة دائماً، بحساسية عالية لما سماه “عاصي الرحباني” مرة (الوقت المُسرَّع) حيث التفكير المسرحي المعاصر، بمعلومات ليست معقدة على الإطلاق بل على العكس خفيفة ليكون الثقل كله للشعر والموسيقى، ولاسيما أنه لم يحمل على عاتقه إلّا أن يضع المشاهد أمام ظلال الصور ويترك له أن يكتشف بذاته تلك الصور، وانطلاقاً من ذلك امتلك المسرح الرحباني عظمته وعدم انتهائه، بل استمراره جديداً ومعاصراً كتركيبة فنية مسرحية رسخت ذاتها بصيغة الحاضر المستمر دوماً.
مسرح الأخوين رحباني حدّ الكذبة
لغة الأخوين رحباني كانت كما موسيقاهم تُطرح دائماً ضمن خط درامي يتزاوج مع الخطاب المسرحي الاجتماعي، السياسي، الفلسفي، الديني، والفكري عموماً، “وفق رؤية تنطوي على تمويه الواقع وإزاحته عن مكانه الفعلي، مع اضطرارها للاعتراف ببعض أجزائه، في سياق إنجازها لمهمتها، من دون أن يعنيها تماسك منطقها بقدر ما تشغلها فعالية هذا المنطق في التأثير على المتفاعلين معها” وهذا واضح في مسرحية “جسر القمر”، وفي جواب المختار في “بياع الخواتم” عندما تسأله بنت أخته ريما ما إذا كان كذب على الناس فيقول “هيدي يا ريما مش كذبة، هيدي شغلة حدّ الكذبة”، بمثل هذا المنطق وهذه الفلسفة يتعامل الأخوان رحباني في أعمالهم المسرحية وذلك مع الإشارة دوماً إلى العطب الذي يصيب المجتمع المدني اللبناني، ولاسيما حين يتحول هذا العالم بكل مفرداته البسيطة المستمدة من الريف الذي أصبح شعراً وأغنيات قبل أن يندثر، حين يتحول إلى سلطة ، أي عندما يخرج الحالِم في مشروعه من الشعب، ويتحول إرادةً إنسانية منعزلة لا تشبه ذاتها، ولا بيئتها، ولا محيطها، بل يصبح مجرد وحش مادي إلى أبعد الحدود؛ بعيداً عن الروحانيات كلها، من هذا الواقع بكل مشكلاته الاجتماعية الكبرى ذات التوتر العالي كان المسرح الغنائي الرحباني يستلهم مواضيعه ويغذي شعره الغنائي وموسيقاه مؤكداً حضوره الاجتماعي والسياسي على الساحة اللبنانية.
فيروز.. شاعرة الصوت
يتفق الكثير من النقاد على أن المسرح هو الذي طور الأغنية الرحبانية، تلك الأغنية التي كانت قبل كل شيء رسالة محبة مكتوبة بلغة أدخلت الشعر على العادي واليومي، لتحوِّل الكلام كله إلى موسيقى، ولتجعل خشبات المسارح الرحبانية بمثابة أرضٍ خصبة تنمو فيها الأغنيات، هذه الأغنيات التي توغل عميقاً جداً في الروح، وتعلن في كل لحظة صباحاً جديداً، وانبلاجاً لنور يطوف على مكنونات النفس والذاكرة، وينبش كنوزها الصادقة، أكثر من ذلك تقوم الأغنية الرحبانية بكل فصولها بحمل قلوبنا أعلى فأعلى لنستطيع أن نجاهر بها، مع إيماننا أن سعادتنا وحزننا سينحنيان أمام حقيقة تلك الأغنيات وصدقها، فكيف إن كانت بصوت السيدة فيروز “شاعرة الصوت” أو “ملحنة اللحن” كما يحب “أنسي الحاج” أن يسميها، هي ذاتها بعينيها الواسعتين وصوتها الفارع “تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر” بحسب محمود درويش، إنها
“خرافتنا التي نلتهمها باستمرار” على ما كتب محمد أبي سمرا، وهي أيضاً “الصوت على نحو ما هو المسيح الكلمة” بتعبير وضاح شرارة، وبحسب “عاصي الرحباني” فإن وجودها بقدر ما كان مساعداً على إضفاء الجمال على العمل المسرحي فإنه كان متعباً، من ناحية أنه يفرض على الأغنية أن تظل في مستواها، ولأنها بنسبة ما تؤدي لحناً ممتازاً فهي تتطلب لحناً ممتازاً آخر، ودائماً ذا جدة كبيرة تقف ملحوظة أمام سيطرة شخصيتها في كل أغنياتها”، ويؤكد عاصي ذلك مستشهداً بمسرحية “يعيش يعيش”، حيث أن سفيرتنا إلى النجوم “جسدت في هذا العمل خمس مطربات مبدعات في آن واحد” والكلام هنا لعاصي “ففي أغنية “كفر حالا”، كان صوتها يقوى على تمثيل الطرب الشعبي اللبناني، وفي أغنية “ليلية بترجع يا ليل” حمل صوتها الطرب الشعبي الكلاسيكي، وفي “أنا هويت وانتهيت” الطرب الشعبي القديم، وفي أغنية “شادي” طرب الجيل الرومنطيقي، وفي أغنية “حبيتك بالصيف” أدّت فيروز آخر نبرات الموسيقى الحديثة في العالم والصرخة المنغمة الأوروبية، وفي الحوار مع الشاويش ذروة الكوميك مع المحافظة على الجمال الصوتي ورشاقة الأداء. إذاً، استطاعت فيروز أن تكون خمس مطربات ناجحات ومتميزات في آن واحد، هذا بالإضافة الى قدرتها التمثيلية الطبيعية، غير المفتعلة ولا المعقدة”.
مسرح غنائي وليس “أوبريت”
هذا المسرح لم يكن له ليخطو تلك الخطوات الواثقة لولا فهم الأخوين رحباني الحقيقي لحدوده العلمية؛ التي تحدد خطواته بدقة تامة من حيث تقدير دور الإحساس بالجو العام للمسرحية درامياً وموسيقياً، مع الانتباه إلى تحقيق الانسجام بين كل خطوة يخطوها الممثل وربطها مع الرقص بروح إيقاعية واحدة منسجمة مع جو المسرحية بحيث تأتي الرقصات متداخلة مع المواقف الدرامية الغنائية، وكذلك وضع الأغاني بطريقة تتلاءم مع المواقف الدرامية بدقة متناهية من ناحية النص واللحن والإيقاع والسرعة والتعبير، ولتحقيق ذلك لطالما وضع عاصي ومنصور ومعهما المخرج “صبري الشريف” أنفسهم مكان المشاهد ليحددوا حاجاته المتنوعة والمتغيرة مع تسلسل الدراما، لذلك كانوا يقدمون له دوماً ما من شأنه الاستمرار في جذبه وضمان غبطته وسلواه، عبر فواصل ترفيهية تشد من حبكة النسيج من دون أن تخرج عن إطار الوحدة الفنية، وهذا ما تحدث عنه منصور الرحباني مميزاً بين مسرح الأخوين رحباني الغنائي وبين أوبريتات السيد درويش مثل أوبريت “العشرة الطيبة” حين قال في أحد لقاءاته: “نحن أنجزنا مسرحاً غنائياً، أما السيد درويش فأنجز الأوبريت؛ التي هي دراما موسيقية غنائية خفيفة مرحة، تتخللها فواصل من الإلقاء السريع بهدف الإسراع بالحدث الدرامي، في حين أن ما قدمناه كان يندرج تحت تسمية المسرح الغنائي الذي يحتوي على نص أدبي درامي موسيقي وأغانٍ ورقصات، كما أنّ المواضيع التي عالجناها في مسرحنا كانت متوترة وحادة تطرح مشكلات اجتماعية كبرى. مسرحنا منذ البداية كان متمرداً وتغييرياً، وهو مختلف عن مسرح سيد درويش، مع إن كلا النوعين من المسرح ساهم في تبلور الأشكال الموسيقية واتساع آفاقها”.
يقول أنسي الحاج: “القصيدة قبل الغناء غابةٌ عذراء وبعده أرض مأهولة. اللحن هو الكشّاف والصوت هو الرسول. ومستحيل تناغم العناصر الثلاثة ما لم يكن الثلاثة شعراء”.
هذا ما تحقق في المسرح الغنائي الرحباني، بثالوثه القلق دوماً، الأخوين رحباني مع فيروز، الأوّلان شاعرا الكلمة واللحن، والثالثة شاعرة الصوت، وثلاثتهم يتصيدون الجمال ويقدمونه لنا في أغنية.
سيرياهوم نيوز 2_تشرين
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن