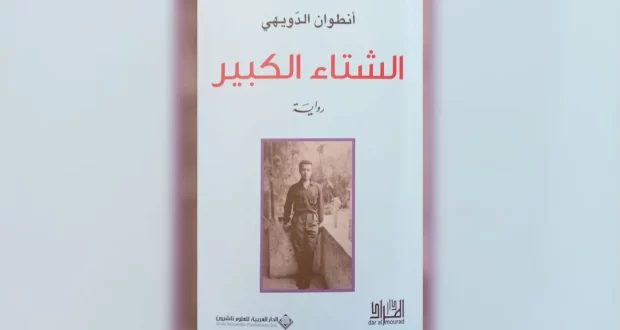سلمان زين الدين
تُشكّل ظاهرة الأخذ بالثأر في المجتمع العشائري التيمة المحورية في رواية “الشتاء الكبير” للروائي اللبناني أنطوان الدويهي، الصادرة عن “دار المراد” و”الدار العربية للعلوم ـ ناشرون” في بيروت. وهي ظاهرة خطيرة تعود في بعض جذورها التاريخية إلى الجاهلية، وتقوم على مبدأ القوة الفردية والقَبَلية بمعزل عن القانون الذي يُفترَض أن يحكم العلاقات بين الأفراد. ولعلّ أخطر ما في هذه الظاهرة أنّ الانتقام لا يقتصر على القاتل الفرد بل يتعدّاه إلى جميع أفراد العائلة أو القبيلة أو العشيرة، ما يطيح كثيراً من الأبرياء الذين لا ناقة لهم في عملية القتل ولا جمل، وذلك عملاً بقاعدة المسؤولية الجماعية التي تجعل من “الشخص في حدّ ذاته لا قيمة فردية له ولا وجه، فهو مجرّد رمز ومجرّد وسيلة لإثبات الوجود ولتحقيق توازن المستويات الجماعية، ولا فرق في ذلك بين إنسان وآخر”، على ما ورد في الرواية (ص 132).
مدينة متخيّلة
يعبّر الدويهي عن هذه الظاهرة الخطيرة في “الشتاء الكبير”، من خلال اصطناع مدينة متخيّلة، ذات شطرين، شرقي وغربي، يطلق عليها إسم موريا، ويرصد العلاقات المتوتّرة بين الشطرين، القائمة على العنف في إطار صراع تاريخي بينهما على السلطة والنفوذ، ناجم في بعض خلفياته عن الانتقال من المجتمع الزراعي إلى مجتمع الخدمات، في خمسينيات القرن الماضي. ولعلّ ما يُذكي أوار هذا الصراع هو أنّ المجتمع الذي ينتظم تلك العلاقات هو مجتمع عشائري، يقوم على التعصّب العائلي، ويُمجّد القوّة، ويعمل بقاعدة المسؤولية الجماعية عن الجرم، وينفّذ أوامر الزعيم المحلّي من دون اعتراض، وينصر الأخ فيه أخاه “ظالماً أو مظلوماً”، ما يرتّب سلسلة من حوادث العنف التي أودت بنحو “مئة وخمسين قتيلاً ومئات الجرحى”، على ذمّة الراوي، وتبلغ هذه السلسلة الذروة بارتكاب مجزرة في كنيسة غسقا، في المنطقة الجبلية بين موريا وجيناتا، ذهب ضحيّتها كثيرون.
شهادة روائية
وعليه، تُشكّل الرواية شهادة من صاحبها على مرحلة تاريخية آفلة، في بيئة اجتماعية محافظة، في شمال لبنان، شديدة التمسّك بالعادات والتقاليد، في محاولة منه لتفكيك ظاهرة خطيرة، والدعوة إلى الإقلاع عنها، وهو ما يتحقّق في نهاية الرواية بفعل تدخّل عامل خارجي غير متوقّع، بحيث يُضطرّ أهالي الموريّتين، الغربية والشرقية، بفعل يالهزّة الأرضية العنيفة التي ضربت المدينة، إلى اللقاء في ساحة كنيسة السيدة وأمام بوّابة دير الراهبات، فيتحوّل الشارع الطويل الفاصل بين الشطرين “من “خطّ نار” إلى ما يُشبه الملتقى الشعبي” (ص 197)، ما يُؤذن بانتهاء مرحلة وبداية أخرى.
غلاف الرواية.
غلاف الرواية.
وقائع تاريخية
وغنيٌّ عن التعبير أنّ الوقائع الأساسية الروائية تُحيل على وقائع تاريخية لبنانية، خلال القرن العشرين؛ فانقسام المدينة الروائية إلى شطرين، شرقي وغربي، يتبادلان العنف، يذكّر بتبادل القصف بين شطري بيروت، خلال حرب السنتين، في ثمانينيات القرن الماضي. وحادثة كنيسة غسقا تعيد إلى الأذهان حادثة كنيسة مزيارة في شمال لبنان، في خمسينيات القرن نفسه، والتي ذهب ضحيّتها عدد من أقرباء الكاتب. وتنقّل الأهالي بين موريا شتاءً وجيناتا صيفاً يشبه التنقّل بين مدينتي زغرتا وإهدن، على سبيل المثال لا الحصر. وبذلك، يتّخذ الدويهي من حوادث تاريخية معيّنة مادّة أوّلية لروايته، ويعيد تشكيلها في ضوء سيرته الذاتية وثقافته المتنوّعة وخبرته الكتابية، مستخدماً تقنيات السرد الروائي بإتقان، لتتشكّل من ذلك كلّه “الشتاء الكبير”. وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى تقاطعه مع قريبه الدويهي الآخر جبور الذي تناول حادثة الكنيسة في روايته “مطر حزيران”، وإلى التصادي بين مفردتي “الشتاء” و”مطر” في العنوانين.
متضادّات متجاورة
يضع الدويهي روايته في 83 وحدة سردية مرقّمة، ويُسند عملية الروي إلى راوٍ شريك، يُشكّل قناعاً له ومرآة، في الوقت نفسه، فيروي الأحداث التي انخرط في بعضها أو شهد عليها أو تناهت إليه من آخرين يتعالق معهم في الرواية، بشكل أو بآخر، وفي هؤلاء أمّه وأبوه وصديقاه كميل وأرميا. ويُشكّل الشخصية المحورية في الرواية والشاهد على مرحلة تاريخية في طور الأفول. على أنُه لا بدّ من الإشارة، هنا، إلى أنّ الراوي كان قد بدأ الرواية في السابعة عشرة من العمر، وعاد ليكملها من حيث توقّف، بعد خمسين عاماً، وهو في السابعة والستّين، لكنّه يفعل ذلك بعيني ابن السابعة عشرة. وعليه، فإنّ تحليلنا هذه الشخصية المحورية سيتناولها في هذه المرحلة العمرية. وفي هذا السياق، يجمع الراوي بين إقامته في الحيّ القديم من موريا الغربية، وتعلّقه بالمكان فلم “يعرف الأسفار، ولا الأمصار، ولا وصال الأجساد، ولا ما يستحقّ ذكره خارج موريا القديمة ومحيطها” (ص 7). وتتجاور فيه مجموعة من المتضادّات؛ ينشأ في بيئة عنيفة ويرفض ممارسة العنف. يقيم مادياً في موريا ويقيم نفسياً في قارة شاسعة وقصيّة داخل نفسه. يعيش في حيٍّ مضطرب ويُقبل على طلب العلم. يصادق كميلاً المقيم في فرنسا والمقبل على الحياة وأرميا المندمج في الصراع بين شرق موريا وغربها. يعيش على أرض الواقع، ويتمسّك بوهم فتاة الشرفة التي يراها من بعيد، فتلازمه صورتها ولا يستطيع إلى التحرّر منها سبيلاً. يرى السلوكيات تطفو على السطح ويغوص في تفسيرها على الأعماق. يراقب الظواهر ويمعن في تحليلها في ضوء ثقافته المتنوّعة مستنداً إلى الأنثروبولوجيا وعلم النفس وسواهما من الحقول المعرفية. وبذلك، نكون إزاء شخصية مركّبة، بسيطة على عمقها، مثالية على واقعيتها، شاهدة على الأحداث وغير منخرطة فيها، ما يجعل من الراوي شاهداً محايداً، وقناعاً للروائي ومرآة له، في الوقت نفسه.
شخوص ثانوية
تحفّ بهذه الشخصية المحورية شخوص أخرى ثانوية. تتعالق معها في علاقات أبوّة أو أمومة أو صداقة، في إطار تكاملي في ما بينها. وفي هذا السياق، يحضر الأب في مسالمته واعتداله، وتربية أسرته على نبذ العنف والتطرّف، وتفانيه في سبيلها. وتبرز الأمّ في تعلّقها بأولادها، وحثّهم على طلب العلم، وحرصها على تربيتهم، ونقل الذاكرة الجماعية الإيجابية إليهم. ونتعرّف إلى كميل في سفره إلى فرنسا، وابتعاده عن الأجواء الموبوءة بالعنف، وحثّه الراوي على اللحاق به للدراسة، لا سيّما أنّ طبعه الهادئ وكلامه يتناسبان مع أخلاق الفرنسيين. ويطالعنا أرميا المهجوس بمجزرة الكنيسة وجمع المعلومات المتعلّقة بها وتوثيقها تمهيداً لمعاقبة مرتكبيها، وهو، في الوقت نفسه، يرفض تطبيق قاعدة المسؤولية الجماعية في العقاب. وهكذا، تكون جميع الشخوص المذكورة مفارقة للواقع الذي تعيش فيه، رافضة للعنف والتطرّف. وهو ما يندرج في إطار أضعف الإيمان، بحيث تكتفي بمحاربة المنكر بالقلب واللسان ولا تبادره بما ملكت أيديها، ولعلّها لا تملك الكثير، في بيئة تُمجّد القوّة، وتنحو نحو التعصّب العائلي، وتأخذ حقّها بأيديها. من هنا، تبرز الحاجة إلى تدخّل خارجي، يُخرجها من الانقسام، ويُوحّد شطري المدينة، وهو ما يتحقّق في نهاية الرواية بالهزّة الأرضية، على قاعدة “ربّ ضارّة نافعة”، فتُعلن نهاية مرحلة الخصام، وتُؤذن ببداية مرحلة السلام والوئام. وهكذا، تنتهي الرواية بمنظور إيجابي مفتوح على المستقبل، وهو ما تأتي الأيام لتثبت صحّته.
تتعدّد في “الشتاء الكبير” مصادر الروي، وطبقات السرد، وأنماط الكلام؛ فيُصدر الراوي عن أخبار الأمّ، ورسائل كميل، واستقصاءات أرميا، وما يتناهى إليه من أخبار، وما يتواتر من ذكريات، وما يعاينه بنفسه. ويجاور بين سرد الأحداث، ووصف الطبيعة، وتحليل الشخوص، وتحديد المواقع، وعرض الأفكار، ودراسة الظواهر. ويتحرّك بين السرد والوصف واليومية والرسالة والحلم وغيرها، ما يجعلنا إزاء نصٍّ متنوّع على كلّ المستويات، يعكس ثقافة الكاتب المتنوّعة، وكفاءته في استخدام أدواته، ونظرته الثاقبة في ما يتعدّى الظواهر المدروسة، وتحليله العميق للأحداث، ما يجعل “الشتاء الكبير” يروي أرض السرد اللبنانية التي يدهمها الجفاف في مراحل معيّنة من تاريخها.
أخبار سوريا الوطن١-النهار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن