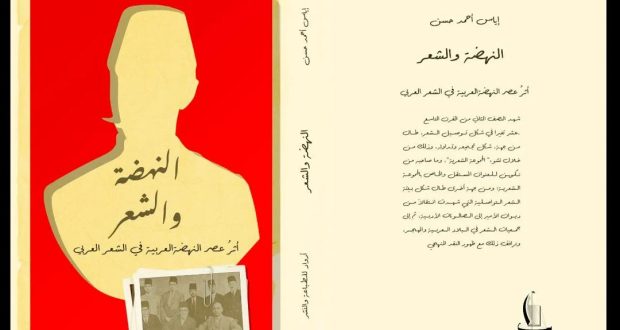مفيد عيسى أحمد
تطوّر المنجز الإبداعي الشعري في الشكل وأداة التوصيل وأغراض الشعر، على ضوء متغيرات عصر النهضة، هذا ما عمل عليه الدكتور “إياس حسن” في كتابه ” النهضة والشعر ” الذي صدر عن دار “أرواد” للطباعة والنشر؛ عام 2025.
أتبع العنوان الرئيس بعنوان شارح هو “أثر النهضة العربية في الشعر العربي” وحدد مجال البحث الذي تضمنه الكتاب في الصفحة الداخلية للعنوان ببندين هما: نشوء المجموعة الشعرية وتطوّر بيئة الشعر التواصلية وظهور المنهج النقدي.
خصّص الباحث الفصل الأول لنشوء المجموعة الشعرية وقدّم لذلك بالتعريف بالمجموعة الشعرية؛ وتناول المواضيع التالية:
ظهور المجموعات الشعرية
يرى الباحث أنه كان للإرساليات الدينية القادمة من الغرب، وللنهضة التي شملت نواحي الحياة كلها أثر جليّ في ظهور المجموعة الشعرية. هذا الشكل الجديد المادي من حوامل الشعر، كذلك يعيد الباحث التطور الذي حدث على نظم الشعر وتجميعه إلى ظهور الجمعيات الثقافية كجمعية شمس البر التي أعلن عنها عام 1868 وجمعية زهرة الآداب التي أعلن عنها عام 1869 إضافة إلى تأثير انتشار الطباعة التي أدت إلى ظهور المكتبات كمكتبة بطرس الأمريكاني التي افتتحت عام 1876 والمكتبة الظاهرية التي افتتحت عام 1879. تأثير آخر كانت له أهمية كبرى هو الاستشراق الذي ساهم في نشر التراث العربي وإن كان بنظرة مغايرة للمعتاد التقليدي الذي تناوله كموروث ثابت جامد يقترب من الكامل لا يجوز تناوله بالنقد.
أثر الكتاب المطبوع كحامل مادي جديد:
تغيّرت وسيلة التواصل الشعري بالخروج من الحالة الشفاهية التي كانت تقوم على المنشد الراوي، إلى وسيلة جديدة تمثلت بالكتاب كحامل مادي، وبذلك انتقلت الوصاية على النص من المنشد إلى الناسخ في حالة الكتابة، الوراقة، ثم الناشر في حالة الطباعة.
تبدّلت هذه الوصاية بعد ذلك، فعملية تجميع القصائد، صار الشاعر يقوم بها، بينما كان سابقاً أصدقاؤه أو المهتمون يتكفلون بهذا العمل. هذا ما فعله أحمد شوقي في ديوانه “الشوقيات”.
لكن سلطة الشاعر ظلت ناقصة؛ فمراجع الديوان أو الناشر ظلّ يغيّر في عناوين القصائد وترتيبها، كما فعل أحمد الخوفي في ديوان أحمد شوقي، توضّح ذلك بعد ظهور الديوان المطبوع، والذي اقتضى عنواناً للديوان ومكاناً خاصاً لهذا العنوان، كذلك ظهر الغلاف وصار عتبة للديوان بتطوّر شكله وإخراجه، بدل أن كان مجرد حافظ مادي في المخطوطات.
تطوّر العنوان وعلاقته بالحامل المادي:
يتناول الباحث التطورات التي مرّ بها العنوان، في خضّم تطورات أخرى شملت المنتج والحامل الشعري، بيّن أن العنوان لم يكن مفرداً على الغلاف، بل كان يسبقه تعريف بجنس الكتاب والكاتب، مثل “كتاب كذا ” و “ديوان فلان”، ويورد مثلاً لذلك ديوان (ناصيف اليازجي) الأول الذي نشره عام 1852 وعلى غلافه نبذة عن الديوان.
ظهر بعد ذلك العنوان الترويجي لكنه لم يكن مستقلاً مثل ” نفحة الريحان ” مالبثت مسألة التعريف بجنس الكتاب أن أخذت سمة عامة كما في ديوان (خليل الخوري) المعنون “زهر الربى في شعر الصبا” والذي نشر عام 1857 وقد سبق هذا العنوان كلمة “كتاب” لكن (الخوري) تخلى عن التعريف بجنس الكتاب في ديوانه التالي واقتصر على عنوان ترويجي هو ” العصر الجديد”.
تابع الباحث تطوّر العنوان حتى صار جزءاً من العملية الإبداعية وذلك بفعل عوامل منها الطباعة وانتشــار الصــحف والمجلات، كجريدة (الوقائع) التي صدرت في القاهرة عام 1828، وجريدة (حديقة الأخبار) التي صدرت في بيروت عام 1858، وجرائد ومجلات أخرى.
يربط الباحث بين ظهور الصحافة وانتشارها وظهور عناوين جديدة للمجموعات والدواوين الشعرية؛ مركزاً على الدواوين التي صدرت في سورية ومصر وذلك كون المنطقتين تشكلان وحدة ثقافية بتجارب مشتركة متقاربة.
تطور النص الشعري في الشكل والأسلوب:
يعزي الباحث للصحافة تأثيراً هاماً على النص الشعري؛ هو تجديد أسلوب الكتابة بالابتعاد عن الإنشاء، فقد بدأت النصوص الشعرية تتخلّى عن السجع والبديع، وهذا ما أوجد الحاجة لعلامات الترقيم لتدّل أين تنتهي الجملة ولضرورتها في إيصال المعنى، جرى استعمالها في أواخر الثلاثينات من القرن التاسع عشر، مما دفع “أحمد زكي باشاستة” لوضع دليل بعنوان “الترقيم وعلاماته في اللغة العربية” وقد صدر عن المطبعة الأميرية في مصر.
تحوّل آخر للمجموعات الشعرية والقصائد؛ هو التحقيب الذي يدّل على زمن إنشاء القصائد، وزمن نشر الديوان، والتحقيب كما ذكر الباحث-أتى بصيغ مختلفة قد يكون بالترقيم الذي يدّل على تسلسل إصدار المجموعات، أو الإشارة إلى مرحلة من العمر مثل ” أشعار الصبا” أو “عبرات الشباب”.
يذكر الباحث أنّ جماعة “الديوان” اعتمدوا صيغة أخرى للتحقيب وهي المواربة، وفيها يشار إلى زمن إنشاء القصيدة بالإيحاء أو الدلالة كاستخدام تسلسل زمني (الفجر، الصباح، الظهيرة.) مثل “أنداء الفجر” لـ “أحمد زكي أبو شادي “.
الفصل الثاني من الكتاب جاء بعنوان: التطوّر الموازي في بيئة الشعر التواصلية وظهور النقد المنهجي.
استعرض الباحث في هذا الفصل روافع الشعر الذين كانوا يروّجون له ويشرحونه على مدى تاريخه، ثم تطرّق إلى ظهور الرواة في العصر الأموي والعباسي، لنصل إلى عصر النهضة حيث ظهرت الدواوين والمجموعات، وعلى إثرها ظهر المقرظون الذين كانوا يقومون بالتراجم وتقريظ العمل بما يقوم مقام المقدمة فيما بعد.
أغراض جديدة للشعر ومقدمات بدل التقريظ:
يقارب الباحث النص الشعري من ناحية الذائقة، فالذائقة التي كان يعبّر عنها بالتقريظ لم تستمر أمام التغيرات الكثيرة التي شملت العلاقات الاجتماعية في أواسط القرن التاسع عشر، إثر الإصلاحات العثمانية، والتي أدت إلى انتهاء حكم العائلات وبروز دور المؤسسات، فمع هذه التغيرات تغيرت وحل محل التقريظ التقويم الموضوعي الذي شكّل إرهاصاً للمقدمة.
المقاربة الأخرى أتت لموضوع الشعر وغرضه، فالتغيّر الأهم والذي كان من المفترض أن يعطى مساحة أكبر في البحث، هو تغيّر مواضيع الشعر وأغراضه، حيث بدأت القصائد تدور حول مواضيع غير مطروقة شعرياً، بدأ ذلك على يد “خليل الخوري” و”سامي البارودي”، هذه المواضيع رتبت ظهور المقدمات بمحتواها الجديد الذي علب عليه مناقشة ماهية الشعر ومفهومه.
موصلات أخرى للشعر:
يعود الباحث إلى ما حسبناه أغفله سابقاً، حيث يتناول مجالات أخرى لتوصيل المنتج الشعري، مجالات تقليدية كانت معروفة تاريخياً منها “الأغورا” عند اليونان، و “الفوروم عند الرومان، والأسواق عند العرب، إلى أن يصل إلى حلقات المساجد التي كانت تعقد في المساجد والجوامع في البلاد الإسلامية، كحلقة الشيخ “طاهر الجزائري” في دمشق.
ونتيجة للإصلاحات التي أقرتها السلطات العثمانية عامي 1839 و1856 والتي منحت الأقليات بعض حقوقها؛ ظهرت الجمعيات العلمية، ثم المجالس التي أخذت لنفسها خطاً تنويرياً.
كذلك لعبت المقاهي دوراً هاماً في التوصيل الثقافي والشعري، ثم ظهرت مجالس البيوت التي اضطلعت بها الطبقة العليا، كمجلس الأميرة نازلي فاضل ومجلس محمود باشا البارودي، أعقب ذلك ظهور الصالونات الأدبية كصالون “مريانا مراش” في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في حلب، وصالون “ألكسندرا الخوري؛ أفرينوه” في أواخر القرن التاسع عشر في مصر. الصالون الأشهر كان صالون مي زيادة التي أعلنت عن مولد صالونها عام 1913.
ظهرت بعد ذلك الجمعيات والروابط الأدبية التي لعبت دوراً هاماً في النقاش والسجال حول الشعر كنتيجة لعملية التطّور والتحوّل الذي كانت تحدث، هذا السجال والنقاش شكّل أساساً للنقد المنهجي.
الكتاب تضمن بحثاً هماً وجديداً ربط بين النهضة بمفاعليها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وبين تطور الحامل والموصل الشعري على صعيد العنوان والتبويب، المواضيع والأغراض الشعرية؛ لكنه لم يأخذ بالاعتبار تطوّر المنجز الإبداعي الشعري العربي من الناحية الفنية إلاّ لماماً، ربما لأن ذلك لم يكن موضوع وغاية البحث، التي حددها الباحث في الخاتمة بقوله “كانت غاية هذا البحث تقصّي العوامل التي ساهمت في ظهور المجموعة الشعرية بصفتها ظاهرة تاريخية.”
(أخبار سوريا الوطن 1-صالون سوريا)
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن