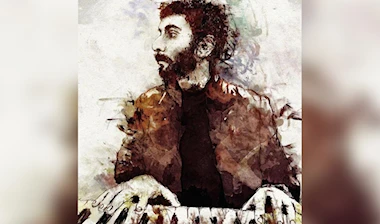ورد كاسوحة
زياد بكلمة؛ هو «بحر الموسيقى». قبله وقبل عاصي، لم يكن ثمّة صياغة هارمونية فعليّة للإيقاعات والقوالب في الموسيقى العربية، إلا في بعض الالتماعات الخاصّة بتجربة محمّد عبد الوهاب، على محدوديّتها وقلّتها. الهارموني هنا هي أن تُعزَف النغمة أو الميلودي الأساسية للأغنية، سواءً في المذهب أو في الكوبليهات، ويتمّ معها في الوقت نفسه توزيع النغمات الفرعية على آلات أخرى، حتى لا يكون العزف بمنزلة صدى أو ظلّ للصوت كما يحدث في الموسيقى الشرقيّة عادةً.
إدارة هذه التعدّدية أو ما يطلق عليه موسيقياً بالبوليفونيّة هي السمة الأهمّ لموسيقى زياد، إلى جانب التجديد الكبير في الموسيقى الشرقية، ومعهما التداخلات التي أحدَثها مع البوسانوفا أو الجاز اللاتيني الذي فُتِن به أثناء عمله على مسرحيّة «بالنسبة لبكرا شو».
في حديث له مع محطّة لبنانيّة في مطلع الألفية، يقول ردّاً على سؤال عن التوزيع الجديد الذي قام به لأغنيات فيروز في ألبوم «إلى عاصي» الذي صَدَرَ في عام 1996 ما معناه ــ وبتواضعٍ شديد ـــ أنه لم يقم بشيءٍ جديد. كلّ ما فعله أنّه وضع ميكروفونات أمام الآلات التي كانت تعزف الميلودي الخاصّ بالأغنية التي لم تكن التقنيات البدائية السابقة تسمح لأصواتها بالوصول إلى المستمع، كما يجب.
بهذه الطريقة، التي لا تنكر أسبقية عاصي في تثبيت الهارموني الخاصّ بنغمات الأغنيات الرحبانية، قدّم زياد لأنماط التوزيع الموسيقيّة التي استحدثها، وقد غيّرت على نحو كامل، شكل التوزيع الموسيقي في الموسيقى العربية، باعتراف معظم الموسيقيين المحدّثين، لجهة غنى البنى اللحنية وتعدّديتها المذهلة، وغير المسبوقة.
في ألبوم «معرفتي فيك» الذي صَدَر عام 1984 وكان بمنزلة انعطافة في تجربته مع فيروز، أجرى توزيعين مختلفين لأغنية واحدة هي «حبيتك بالصيف». ما فعلَه بالتركيب اللحني للأغنية لم يكن جديداً. فقد سَبَقَ له أن أجرى توزيعاً ثورياً آخر، إذا صحّ التعبير لمقطوعة موزار التي غنتها فيروز تحت عنوان «يا أنا يا أنا أنا وياك». لكن الفارق بين التوزيعين أنّ الأول كان أقل شيوعاً بكثير من الثاني، لأنه اقتصر على الموسيقى، ولم يندرج ضمن إطار ألبوم لفيروز كما حصل مع أغنية «حبيتك بالصيف» المُعاد توزيعها.
التوزيعان في الألبوم للأغنية نفسِها كانا مختلفين جذرياً؛ المشترك الوحيد بينهما هو استخدامُه كالعادة لصوت فيروز كأداة أو معادل لحني لأصوات الآلات، وهو أمر كان يحرص عليه في بدايات تعامله مع فيروز، لتأكيد تمايزِه عن مدرسة عاصي ومنصور، لجهة اعتبار المساحة المعطاة للموسيقى ضمن الأغنية، أمراً لا يقلّ شأناً عن الصوت نفسِه، حتى لو كان صوت فيروز.
في التوزيع الأوّل، لا توجد أصوات بشريّة لنقل الشحنة الغنائية التقليدية، حتى صوت فيروز استُخدم «أداتياً» بغية خدمة المساحة الأكبر في اللحن المعطاة للبيانو، هو يعزف السولو الأكثر اكتمالاً.
ثمّة متعةٌ خاصّة في الاستماع إلى الأغنيات والمقطوعات الموسيقيّة التي ألّفها، إذ تحتلّ الكتابة للبيانو المساحة الأكبر، ليس لأنه كان الآلة الأساسية في أعماله التي تقود الجملة اللحنية أو الميلودي، بل لأنّ طريقة التأليف للبيانو عند زياد، كانت تأتي من عالمٍ لا تعرفه كثيراً الموسيقى العربية أو الشرقيّة.
ثمة تجربتان أخريان ـــ بالإضافة إليه في التأليف للبيانو في الموسيقى العربية ـــ هما تجربة عمّه الياس الرحباني، وتجربة عمر خيرت في مصر.
موسيقى الياس الرحباني انشدّت أكثر إلى مناخات الأغنية الفرنسية. ورغم مهارته التقنية العالية في التأليف والعزف، إلا أنّ موسيقاه بقيت من دون تجذير كونها لم تلعب مثل موسيقى زياد على التقاطعات القائمة بين الموسيقى العربية ونظيرتها الغربية.
في المقابل، كانت تجربة عمر خيرت في التأليف للبيانو أقرَبَ إلى تجربة زياد، لجهة الانطباع بالهويّة المحليّة، مع أنها لم تضاهِها، لناحية غنى البُنى اللحنية والإيقاعيّة.
ثمّة فارقٌ أساسيٌّ في هذا السياق بين التجربتين، وهو أنّ الميلودي لدى عمر خيرت كانت متكرّرة كثيراً، حتى ضمن الأغنية الواحدة في حين كان التعدّد في النَغَمات أو الجمل اللحنية.
من أجمَل المقطوعات التي كتبها للبيانو والكمنجات، ولم تنَل الشيوع الذي لاقته أعماله الأخرى، بحكم أنها لم تكن في أيٍّ من الألبومات التي أنجزها لفيروز، رائعة «آثار على الرمال». هي أساساً لم تكتب للتداول في السوق الموسيقيّة، بل أُنتجت في سياق عمل تلفزيوني لبناني قديم يحمل الاسم نفسه، ووقع الخيار على زياد ليؤلّف الموسيقى التصويرية للعمل، فضلاً عن الشارة التي تحوّلت فيما بعد، إلى إحدى أجمل مقطوعاته الكلاسيكيّة وأكثرها ندرةً.
قبله وقبل عاصي، لم يكن ثمّة صياغة هارمونية فعليّة للإيقاعات
النُدرة هنا نابعة من كونه لم يتمرّس كثيراً في الموسيقى الكلاسيكيّة، رغم إتقانه المطلق لها عزفاً، وحتى توزيعاً، فبقي إنتاجه فيها مقتصراً على عمل أو عملين. وقد أتى على ذكر ذلك أكثر من مرّة. إذ أشار في إحداهما إلى ندمه على عدم متابعة دروسه مع أستاذه الذي كان يدرّسه الموسيقى الكلاسيكية بوغوص جلاليان.
وفي المرّة الثانية، أشار في معرض حديثه عن الفواصل الموسيقية في مسرحيته الأخيرة المزدوجة «بخصوص الكرامة والشعب العنيد» و«لولا فسحة الأمل» إلى استعانته بابن عمّته، الموسيقار بشارة الخوري، لتأليف فواصل موسيقية تحتاج إلى إلمام أكبر بالموسيقى الكلاسيكيّة.
في الحالتين كان ثمّة نقص في الإحاطة.
المقطوعة كُتبت للبيانو والكمنجات بشكل أساسي، حيث تتبادل الآلتان عزف أكثر من ميلودي. وثمّة أكثر من زمن موسيقي أو مازورة إذا صحّ التعبير، يتوزّع عليها التأليف والعزف. ليس ثمّة إيقاع هنا، والمقطوعة مضبوطة بالنوتات المكتوبة للكمنجات، لأنّ نمط التأليف الكلاسيكي لا يحتمل ضوابطَ إيقاعية كثيرة. ويكفي العودة إلى الكمنجات ـــ بعد كلّ «ارتجال» أو سولو يعزفه البيانوـــ حتى تنضبط المقطوعة في إطارٍ من الهارموني المتكاملة. لكن ما هو مختلف هنا بالنسبة إلى سولوات البيانو مقارنةً بمقطوعات أخرى لزياد في مراحل متقدّمة حين انحاز إلى البوسانوفا والجاز اللاتيني، أنّ التأليف والعزف كلاسيكيان.
وهذا يعكس حجم الإلمام بالموسيقى الكلاسيكية رغم أنه لم يطوّر مهاراته فيها كما يجب، واقتصر نتاجه الخاصّ بها على التوزيعات الاستثنائية التي شاعت كثيراً، لموسيقى موزار، لا سيّما لحن أغنية «يا أنا يا أنا أنا وياك» لفيروز.
أيضاً من المتع الخالصة، الاستماع إلى المقطوعات أو الأغنيات التي حوَّلها بفعل التركيب الموسيقي المتعدّد إلى كرنفالات من الأصوات والجمل اللحنية والإيقاعيّة.
كان ذلك موجوداً بمقدارٍ معيّن لدى الأخوين رحباني، لكن في إطار موروث وتقليدي أكثر، تحديداً في الأغنيات التي ينضبط فيها الإيقاع بأصوات خبطات الأرجل على الأرض، بما يجعل هذه الإيقاعات المعروفة بالدبكة، هي المحدّد في أعمال الأخوين، ليس فقط للأهازيج التراثية التي يختلط فيها صوت فيروز والجوقة بالكرنفاليّة المحتفية بالريف، بل أيضاً لعلاقة الجمل اللحنية أو الميلودي في هذا النوع من الغناء بالإيقاع.
مع زياد، تمّ تطوير موسيقى الكرنفال إذا صحّ التعبير، مع إدخال آلات النفخ التي تضيف على عمل الوتريّات أبعاداً غير مطروقة. ويضاف إليهما الدور المركزي للبيانو، حتى حين لا يُتاح له عزف سولوات كما في أعمال أخرى لزياد، مكتوبة خصيصاً له، أو معرّفة به، كآلة تقود ولا تسهم في العزف فقط.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك، أغنية «رح نبقى سوا» في ألبوم «معرفتي فيك». شكّل الألبوم بمجمله انعطافةً في مسار تعاونه مع فيروز، باتجاه تجذير القوالب الموسيقيّة الخاصّة بالبوسانوفا والجاز اللاتيني، كمحدّدات أساسية للتأليف والعزف، حتى كإطار لغناء فيروز. غير أنّ هذه الأغنية بالتحديد، كانت بالمقارنة مع أغنيات الألبوم الأخرى، الأكثر خفوتاً ورصانةً، بمنزلة طقس كرنفالي للاحتفاء بالحياة، عبر خلطة من الإيقاعات الصاخبة والميلوديات التي يمتزج فيها الصوت البشري بأصوات الحياة نفسِها. ثمّة في البداية تناقُض مقصود بين رصانة التركيب الشعري لكلمات جوزف حرب والفوضى المحسوبة التي أحدَثها زياد في التركيب اللحني، بغرض إيصال المعنى إلى ضفافٍ، لم يكن ممكناً بلوغها، لولا تحويله الأغنية برمّتها إلى كرنفال أصوات وإيقاعات وميلوديات.
هذا يشبه إلى حدٍّ كبير ما قاله طلال حيدر مرةً عن لحن أغنية «وحدن»، إذ أشار إلى أنّ آخر ما كان يتوقّعه أن يكون نصّه الشعري محمولاً على تركيبة لحنية غير شرقيّة بالمرّة، بحيث يصل التقاطع مع إيقاعات الجاز فيها، إلى حدود غير مسبوقة في الغناء العربي.
الأفق الذي انفتح أمام قصيدة طلال حيدر بهذا المعنى، لتحلّق في سماء التقاطعات الموسيقية التي جذّرها زياد، هو نفسُه، الذي توفَّرَ لنظيرتها التي كتبها جوزف حرب، وفي باله ربّما، مثل طلال حيدر، أنها ستكون أقرب إلى الإطار المحدَّد مسبقاً، على جمالِه، الذي عبّرت عنه ألحان فيلمون وهبي لفيروز، من شعره وشعر حيدر.
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن