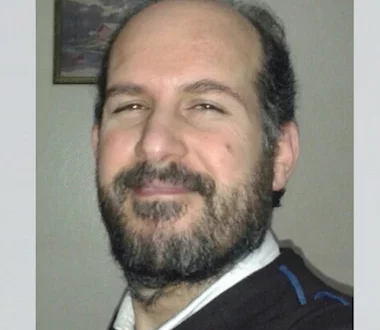ورد كاسوحة
ابتداءً من مطلع هذا الشهر الذي شَهِد مضاعفة ضريبة استهلاك الكهرباء بأكثر من أربعين ضعفاً، سيكتشف السوريون، على اختلاف انتماءاتهم، حجم الوهم الذي رافَقَ انهيار المنظومة السابقة، بكلّ ما كانت تنطوي عليه من تناقضات شكّلت بمجملها فحوى حياتهم لما يزيد عن ستين عاماً. التكثيف الذي مثّلته لحظة رفع الدعم عن الكهرباء بهذه الطريقة، لا يعكس فحسب حجم الاقتصاص من بقايا الهياكل الاشتراكية للنظام السابق، بل كذلك مقدار الجهل بالجغرافيا الاجتماعية للبلاد، لجهة كونها الأكثر تعبيراً، طوالَ عقود، عن المنابت الطبقية لأكثرية السوريين.
مناخ ما قبل التأميمات وإرساء الدعم
في المرحلة التي سبقت وصول «البعث» إلى السلطة، كانت البلاد تحت تأثير توجّهات رأسمالية لا تقيم كثيرَ اعتبار للملكية العامّة لوسائل الإنتاج، أو لمسائل غدت محورية في حياة السوريين لاحقاً، مثل دعم السلع والخدمات الأساسية، ودور الدولة التدخّلي في الطبابة والاستشفاء والتعليم والنقل والاتصالات…
الأجيال التي لم تعاصِر الاشتراكية ابتداءً من عام 1963، كانت معاناتها كبيرة من غياب الدولة عن هذه الحقول جميعها، ابتداءً من مسألة الملكية التي عجّلت أكثر من سواها في دفع البلاد باتجاه الاشتراكية، ومروراً بالكلفة الباهظة للمواد الأساسية والخدمات، وليس انتهاءً بعدم شمول الفئات المُفقَرة بالمزايا الخاصّة بالتعليم والطبابة، كونها لم تكن قد تأمّمت بعد. وبالتالي، كانت مقتصرة، حتى ذلك الوقت، على الفئات القادرة على الإنفاق عليها، مثل الإقطاعيين والأعيان والتجار وسواهم من الفئات المحظيّة لدى الحكم ذي الملامح الرأسمالية الذي كان قائماً.
الدعاية المناهِضة للتأميمات التي حصلت على مرحلتين لاحقاً، لم يكن تركيزُها منصبّاً على مسألة الدعم، على اعتبار أنّ هذا الشكل من الدعاية كان سيُحرِم الفئات المناهِضة للحكم الاشتراكي من القدرة على الاستقطاب الاجتماعي، حتى ضمن الطبقات التي فقدت امتيازاتها مع صعود الاشتراكية إلى الحكم في كلٍّ من سوريا ومصر. طوال المرحلة التي حكَمَ فيها «البعث» هنا، كانت المناهَضة له ضمن الفئات التي فقدَت امتيازاتها مترافقةً مع نمط إنتاج لم يستثنِ أيّ فئة أو شريحة اجتماعية من الدعم المُقدَّم للسلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك طبقة التجّار والمصرفيين، التي كانت تعارض إجراءات التأميم والإصلاح الزراعي وإلغاء المُلكيات الكبرى.
هذا جَعَلَ استفادة هؤلاء، «المتساوية مع سواهم» من الدعم، تتعارض مع التوجّه العام الذي يقودونه لمناهَضة الإجراءات الاشتراكية، وهو ما أوقعهم منذ البداية في تناقض لم يكن ممكناً الخروج منه إلا بتبنّي السردية الليبرالية التي تتمحور حول غياب الديمقراطية والتعدّدية السياسية، بدلاً من الاستمرار في لوكِ خطاب متناقض وغير شعبي حول مساوئ الاشتراكية، وإتيانها، حسب زعمهم، على البنية الأساسية ذات الطبيعة التنافسية للاقتصاد السوري.
ملامح الانتقال إلى الحقبة الاشتراكية
العامل الأساسي الذي أفضى إلى هذا الصراع، هو مساس الحكّام الجُدُد، الآتين من خلفيات بعثية وناصرية، بالمُلكية الخاصّة للأراضي والعقارات والمصانع، التي كانت تتبع في معظمها لإقطاعيين ووجهاء وعائلات سياسية كان لها نفوذٌ كبير في الحقبة التي أعقَبت الاستقلال.
حَصَل ذلك على مرحلتين:
الأولى، أثناء حكم الوحدة، حيث كان نطاق التأميمات التي بُوشر العمل بها محدوداً، بغية عدم تأليب الوجاهات والزعامات التقليدية بالكامل على النظام الجديد.
والثانية، بعد انتهاء حكم الانفصال ومجيء البعث إلى السلطة في عام 1963.
لم يقتصر الأمر مع «البعث» على توسيع نطاق عمليات التأميم، بل شَمَلَ كذلك سلّةً متكاملة من الإجراءات التي لم يجرؤ حكم الوحدة على اتخاذها نظراً إلى جذريتها ومساسِها بمصالح الفئات المتنفّذة التي كانت تقف وراء النظام التمثيلي السابق. أبرَز ملامح هذه الإجراءات، بالإضافة إلى التأميمات والإصلاح الزراعي وإقرار مجانية التعليم والزاميّته، هي حزمة الدعم الحكومي التي كانت بمثابة الواجهة الفعلية للسياسات الجديدة، كونها كانت الأكثر تماسّاً، من بين مثيلاتها، مع الفئات الشعبية صاحبة المصلحة في حصول التنمية لمصلحة السواد الأعظم من السوريين. والحال أنّ هذه الأخيرة كانت تعيش حينها مرحلةً انتظارية، ككلّ الحقبات الانتقالية، سرعانَ ما انتهت لمصلحة انتقالِ أجزاء كبيرة منها، بفعل قوّة وجذريّة سياسات الدعم، إلى صفّ الحاضنة الاجتماعية والاقتصادية للنظام الجديد.
التمثّل هَزَلياً بالنموذج الضريبي الرأسمالي
الدعم المُقدَّم هنا، والمُستوحى من النموذج الاشتراكي السوفياتي، لا يقتصر على تأمين السلطة كلفة المواد الأساسية، عبر الكوبونات أو سواها، بل يتعدّاه إلى دعم الخدمات المُقدَّمة من الدولة، بحيث لا تصل إلى الفئات الاجتماعية المختلفة إلا بسعر رمزي أو متناسب مع الدخل. وذلك في تعارُضٍ كامل مع نموذج الفوترة المُطبّق في الدول الرأسمالية، والذي لا تتحمّل الدولة بموجبه أيّ مسؤولية عن الخدمات المُقدَّمة للناس، إلا كهيكل عامّ شكليّ، في الدول التي تتبع النموذج الاشتراكي الديمقراطي، وتحافظ على الحدّ الأدنى من ملكية الدولة للمؤسّسات ووسائل الإنتاج.
والحال أنّ استحضار النموذج الرأسمالي في تعويم الخدمات المُقدَّمة من الدولة، وتركها لمنطق العرض والطلب الخاصّ بالسوق، يغفِل وجود أحزاب سياسية في الغرب تتبنّى الفكر الاشتراكي وتُسائِل الحكومات عبر المؤسّسات المُنتَخَبة حين يحصل إفراط في اللبرلة الاقتصادية ورفع الدعم عن الخدمات والسلع الأساسية. بالإضافة إلى الافتقاد هنا إلى آلية المُساءَلة عن السياسات الضريبية، مقارنةً بالغرب الذي يجري التمثّل به شكلياً فحسب، وبعد إفراغ نموذجه الضريبي من مضمونه السياسي، ثمّة أيضاً غياب التماثل أو التناظُر في بنية الدخل، والتي تتيح هناك، بفعل القيمة المُضافة العالية للإنتاج والاستهلاك، تغطيةَ جزءٍ يسير من المُعدّل القياسي للزيادات الضريبية.
الافتقار إلى كلّ ذلك، قياساً إلى النموذج الرأسمالي، يجعل من هذا المُعدّل القياسي في الزيادات الضريبية ليس مجرّد قفزة في الهواء، بل أيضاً نكوصاً عن البنية الاقتصادية الضريبية السابقة التي كانت أفضل، حتى في ذروة الحرب، مع كلّ ما شابَ الهياكل الاشتراكية السابقة من تشوّهات سلالية ومافيوية.
هكذا، تتعامَل السلطة مع بنية اقتصادية اجتماعية أقرَب إلى النموذج العالمثالثي الذي لا تصلح معه الوصفات النيوليبرالية الجاهزة، وكأنها حقل تجارب لسياسات اقتصادية لا نعلم إن كانت تميّز بين «الاقتصاد الحرّ» كما يُطبّق بشكل مُقيّد في دول مثل تركيا وقطر (وهي من أشدّ الداعمين للنظام سياسياً وأمنياً واقتصادياً)، ونظيرِه الجاري تطبيقه هنا، من دون وجود سوابق له حتى في أعتى الاقتصادات الرأسمالية التي تتبنّى النموذج النيوليبرالي.
خاتمة
عدم التفريق بهذا المعنى بين تعويم كلّ الأصول الاقتصادية للدولة، من العملة الوطنية إلى الخدمات الأساسية، ووضع قيود تنظّم عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة نفسِها، ينطوي على جهلٍ كامل حتى بمنطق التعويم وتحرير الاقتصاد، إذ غالباً ما تلجأ الدول، لدى إجراء عمليات تحرير للسلع والخدمات والعملة، إلى ضبطها بمُحدِّدات لا يمكن بدونها الحفاظ على البنية الأساسية للنظام الاقتصادي، حتى الرأسمالي منه.
أبرز تلك المحدِّدات، بالإضافة إلى حصر التداولات والتدفُّقات النقدية بالعملة الوطنية، الإبقاء على معدّل وسطي للدعم، بحيث لا يُترك استهلاك المواد والخدمات الأساسية لمنطق العرض والطلب، كأيّ سلعة أخرى في السوق، لأنّ ذلك سيتسبّب بتقويض الطلب العامّ على السلع والخدمات نفسِه، عبر جعله يُستهلَك ضريبياً، وبمعدّل قياسي، لا يترك مجالاً لحدوث أيّ نموّ في الاقتصاد، حتى على مستوى الإنفاق الاستهلاكي وحده.
ما سيحصل، على الأرجح، انطلاقاً من هذا التحرير القياسي للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء التي تُعتبر المحرّك الرئيسي لأيّ اقتصاد، هو عملية ركود غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد السوري، إذ في غياب تغطية فعليّة من الدخل الخاصّ بالأفراد لهذه الزيادة القياسية، لن يكون بمقدور أحدٍ من السوريين، حتى المغتربين منهم والذين يساهمون بقسطٍ وافر في تغطية أعباء المعيشة هنا، إنفاق ليرة واحدة خارج إطار الاستهلاك الضريبي القياسي، لمجمل الإنفاق الحاصل، سواء في الداخل حيث الأجر المحدود جداً مع كلّ الزيادات الحاصلة، أو حتى في الخارج حيث لم يعد نموذج التحويلات قادراً على إعالة العائلات الباقية في البلاد أكثَرَ ممّا فعل حتى الآن.
* كاتب سوري
أخبار سوريا الوطن١- الأخبار
 syriahomenews أخبار سورية الوطن
syriahomenews أخبار سورية الوطن